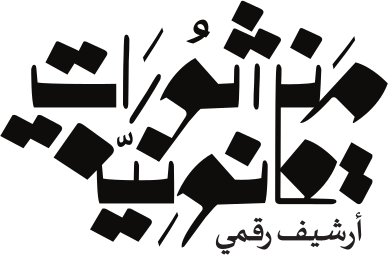التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا
* الكاتبة: المستشار شيرين حافظ فرهود - الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
** تنشر "منشورات قانونية" هذه الورقة بإذن خاص من الكاتب وسبق نشرها بالعدد الثامن والعشرين من مجلة المحكمة الدستورية العليا.
في الثامن عشر من يناير عام 2014 صدر دستور جمهورية مصر العربية، معبراً عن آمال وطموحات الشعب المصرى بكافة طوائفه، في أعقاب ثورتين هما ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، وقد عمد المشرع الدستورى إلى إيلاء عناية خاصة ببعض الفئات التى أرتأى أن حمايتها دستورياً بنصوص خاصة تحمى حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً هو أمر لازم، ومن هؤلاء شهداء الوطن، ومصابى الثورة، والمحاربين القدامى، والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس والأطفال والشباب، وذوى الإعاقة والأقزام، والمسنين، والمغتربين المقيمين في الخارج، وجاءت المرأة على رأس الفئات التى شملها الدستور بتلك العناية، والتى فاقت ما ورد بالدساتير السابقة، فلم يكتف بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بل ألزمها باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيلها تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وبكفالة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما وضع الدستور على عاتق الدولة التزاماً بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة، والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجاً.
وحرص الدستور في المادة (180) منه على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، ومنح في المادة (6) منه الجنسية لمن يولد لأم مصرية، وإذا كان الدستور الصادر عام 2014 قد خطا خطوات واسعة في سبيل تمكين المرأة المصرية، فإن المحكمة الدستورية العليا كانت كعهدها دائماً سباقة في هذ المجال، وكانت أحكامها بمثابة علامات أضاءت الطريق أمام المشرع الدستورى، بلوغاً لهذه الغاية السامية، وأحاطت المرأة المصرية بسياج من الحقوق والضمانات، متخذة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء نبراساً في هذا الشأن، ومن اعتبارات العدالة والمساواة هدفاً وسبيلاً، ومن إعلاء شأن المرأة المصرية غاية سامية.
وقد أظلت هذه الحماية المرأة المصرية في مناحي حياتها كافة، وعلى امتداد مسيرتها من الطفولة حتى الشيخوخة، وشملت كل النساء على اختلاف ظروفهن، ومستوياتهن الثقافية والاجتماعية والمادية، وأياً كانت ديانتهن، فكانت أحكامها، ومازالت رائدة في هذا المجال، وكان إنتصافها لحقوق المرأة في العديد من أحكامها، على أمتداد تاريخها تفعيل حقيقى لمفهوم تمكين المرأة (Women's Empowerment) ، على النحو الذى يكفى لأن تتيه الأجيال القادمة به، كما تتيه به محكمتنا الدستورية العليا.
ففى مجال تمكين المرأة العاملة وحماية حقوقها الدستورية:-
أقرت المحكمة مبدأ مهماً مقتضاه أن خروج المرأة للعمل ليس نشوزاً عن طاعة زوجها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/5/1997، في القضية رقم 18 لسنة 14 قضائية "دستورية"، وكان النزاع الموضوعى- وفى مجال استحقاق المدعى عليها لنفقتها- مبناه إنكار زوجها لحقها في العمل.
وكان موضوع الدعوى الدستورية محدداً بما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية- وفى مجال تطبيق أجزائها التى تتعلق بعمل الزوجة وشروط هذا العمل- وجاء بحيثيات هذا الحكم ما يلى: "إن المرأة شريكة الرجل فى عمارة الأرض وغيرها من أشكال الحياة وأنماطها بما يتفق مع طبيعتها، ولايخل بكمال رعايتها لأسرتها وفق تعاليم دينها، تقديراً بأن عملها لايجوز أن ينفصل عن الضوابط الشرعية ســـواء فى حدودها أو آدابها، وأن إنكار حقها فى العمل على إطلاق، قد يوقعها فى الضيق والحرج، فلا ييسر شئونها، أو يعينها على أداء مسئوليتها حتى نحو بيتها وأفراده. "وإن المشرع لايرخص للمرأة بالعمل خارج بيتها لمجرد ضمان استقلالها اقتصادياً سواء عن زوجها أو عن أسرتها، وإنما لأن هذا العمل يؤثر فى كثير من نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقد يكون مطلوباً منها وجوبا أويصون ماء وجهها أن يراق، وهو فى الأعم يكفل الخير لمجتمعها. وإن القول بأن خير حال المرأة أن تقر فى بيتها مردود بأن لها مثل ما عليها معروفاً، فلا يقوم زوجها بإيوائها وحمايتها ورعايتها والإنفاق عليها ليقهر إرادتها، ولا ليمحق كيانها بما يباشره من سلطان كاسر عليها، بل هى كالرجل مدعوة لتحقيق الخير لمجتمعها".
وقد تزامن هذا الحكم، الصادر في هذه الحقبة بالتحديد من تاريخ هذا الوطن، في وقت كنا نخوض فيه حرباً شرسة ضد الإرهاب، سواء بصورته الدموية المتعارف عليها، أو بصورته الخفية، التى كانت لا تقل ضراوة أو شراسة عن الأرهاب الدموى، إذ جاء فى صورة ردة فكرية، تستتر وراء عباءة الدين، وجهت سهامها في المقام الأول ضد المرأة، ليأتى هذا الحكم لينصف للمرأة، ويدعمها في حربها، في مواجهة الثقافة الرجعية التى حاولت إقصاءها عن ساحة العمل، بإفتعال التناقض بين عملها وواجباتها كزوجة.
وفى حكم آخر أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/8/2000 في القضية رقم 163 لسنة 20 قضائية "دستورية". قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991، الذى كان ينص على أن يتم تمليك الراغبين من العاملين بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضى زراعية، بحيث يتملك العامل من الرجال ممن تنطبق عليه شروط الانتفاع بالتمليك حصة تمليك كاملة هو وزوجته إذا لم يستفد الزوج من التمليك، فى حين تملك العاملة السيدة 50% فقط من حصة الرجال، حال كونهما- العامل والعاملة- يعملان في نفس الجهة، وتنطبق عليهما الشروط ذاتها للتمليك، فجاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليعدم هذا النص، ويقر حق العاملات في الحصول على حصص تمليك مساوية لحصة العاملين من الرجال وجاء بحيثيات هذا الحكم: "إن من المقرر أن عمل المرأة فى مجتمعها- وأياً كانت الصورة التى يتخذها- هو من الحقوق التى كفلها الدستور لها بمراعاة التوفيق بين هذا العمل وواجباتها قبل أسرتها. فإذا منعها المشرع- بغير سند موضوعى مبرر- من الحصول على حصة كاملة من الأرض الزراعية- شأنها شأن العاملين من الرجال- فإن القول بتكافئهما فى الفرص التى أتاحتها هذه الجهة لنيلها، أو بتساويهما فى شروط النفاذ إليها، ينحل بهتاناً يؤيده أن القرار رقم 324 لسنة 1991 المشار إليه، ما كفل للعاملين ميزة الحصول على أراض زراعية تملكها جهة عملهم، وتقوم بتوزيعها عليهم، بعيداً عن الأغراض التى ربطها بها، وأخصها استثارة اهتمامهم بالتنمية الزراعية تطويراً لها. ولا يلتئم وهذه الأغراض، إنكار حق المرأة كاملاً فى تلك الميزة، ولو كانت مستوفية شرائطها، وإلا كان هذا الحرمان عدواناً مبيناً".
فكان هذا الحكم بمثابة غمد، لصورة صارخة من صور التمييز ضد المرأة العاملة، لصالح زميل لها في العمل، دون أن يكون لهذا التمييز ما يبرره- من وجهة نظر واضعى هذا النص- سوى اختلافهما في الجنس، إذ وجدوا في ذلك مبرراً كافياً لحرمان العاملة من تملك حصة من الأرض مساوية لزميلها، حال كونها تؤدى العمل ذاته، وفقاً لذات الشروط والضوابط، في نفس الجهة.
وتفعيلاً للنص الدستورى الذى يلزم الدولة بكفالة توفيق المرأة بين عملها في مجتمعها، وواجباتها في نطاق أسرتها، وهو ما ينبغى أن تتولاه الدولة، بإعتباره واقعاً في نطاق مسؤليتها، مشمولاً بإلتزاماتها التى تضمنها الدستور، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة13/2/2005 في القضية رقم 81 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل في مدة السنوات العشر المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعات طوال مدة خدمته، وكانت المدعية- وهى أستاذة جامعية- قد أعيرت للعمل بإحدى الدول العربية لمدة ست سنوات، ثم حصلت على إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثلاث سنوات متتالية، ثم تقدمت بطلب للموافقة على إسقاط مدة إجازة رعاية الطفل السابق حصولها عليها من مدة السنوات العشر المصرح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس إعمالاً لنص المادة (91) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات، مع طلب تجديد إجازاتها بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عامين، فصدر قرار السيد رئيس الجامعة متضمناً تجديد إجازاتها الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل حتى تاريخ إستكمال مدة السنوات العشر، وهى مدة أقل من المدة التى طلبتها المدعية، مما حدا بها إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بهذا الحق، فأجابتها المحكمة لطلباتها، وأصدرت حكمها السالف الإشارة لمنطوقه.
وجاء بحيثيات هذا الحكم: "إن النص الطعين، إذ إحتسب إجازة رعاية الطفل ضمن مدة السنوات العشر المسموح بها كإجازة لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته ، يكون قد أفرد الأمهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابطها، ويخل بالأسس التى تقوم عليها، وبالركائز التى لا يستقيم مجتمعها بدونها، ومايز بذلك، وعلى غير أسس موضوعية بينهن، وبين غيرهن من العاملات بالدولة، اللاتى يحق لهن قانوناً الحصول على تلك الإجازة، بإعتبارها تمنح لهن وجوباً وفق ضوابط معينة، لا تنال من مدتها، أو تمس جوهر الحق فيها، فى حين حرم الأم عضو هيئة التدريس بالجامعة من تلك الإجازة إذا كانت قد استنفدت قبل الإنجاب. مدة السنوات العشر فى بعثة علمية أو إعارة خارجية مما تستلزمه طبيعة عملها. كما مايز النص المطعون فيه بين المرأة والرجل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إذ أتاح للرجل فرصة الاستفادة بمدة الإجازة المصرح بها كاملة فى إجراء الدراسات العلمية أو الإعارات الخارجية، فى حين حرم الأم عضو هيئة التدريس من هذه الميزة، عندما أدرج مدة إجازة رعاية الطفل فى الفترة المذكورة، وبذلك يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه".
فرفعت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم، عن كاهل أستاذة الجامعة عبئاً ثقيلاً، يتجسد في معاناة فرضها عليها النص محل الطعن، بأن جعلها ممزقة بين واجبها كأم، ودورها وواجبها كأستاذة جامعية، تتطلب طبيعة عملها السفر في بعثات، وحضور مؤتمرات علمية، وإعداد أبحاث على مدار حياتها العملية، وهو ما يستلزم في كثير من الحالات حصولها على اجازات، واستقطاع ست سنوات مدة اجازة رعاية الطفل، من السنوات العشر المقررة لها كإجازة طوال مدة خدمتها، يمثل إجحافاً شديداً بحقوقها، ويضعها بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن تقصر في واجباتها كأم، يحتاج ولدها إلى رعايتها في سنى عمره الأولى، أو أن تضحى بمستقبلها العلمى والوظيفى، الذى كابدت المشاق وصولاً له وهو ما يرهقها من أمرها عسراً.
وبتاريخ 6/5/2017، قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 165 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى هذه اللائحة- قبل استبدالها باللائحة الصادرة بتاريخ 21/4/2008- فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة بدون مرتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها، وكان النزاع الموضوعى، تدور رحاه حول مدى أحقية المدعية في أن يضاف لراتبها كامل العلاوات الدورية التى مُنحت للعاملين ببنك ناصر الاجتماعى خلال مدتى الإجازة الخاصة بدون مرتب المصرح لها بها، لرعاية طفلها سواء التى حرمت منها كاملاً أم من ربع العلاوة أو نصفها، وجاء بحيثيات حكمها ما يلى: "إنه متى كان نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى، الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ 6/1/1980، قد إلتزم بما أوجبه الدستور فى شأن وجوب الحفاظ على وحدة وتماسك الأسرة، بإعتبارها أساس المجتمع، وإلتزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، فنص على أحقية العاملة بالبنك فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. إلا أن نص الفقرة الخامسة من تلك المادة عاد ونقض غزل هذا الحق من بعد قوة أنكاثًا، بأن حمل هذا الحق بأعباء وقيود تثقله وتجعل ممارسته إرهاقًا للعاملة، وحائلاً دون تمكينها من التوفيق بين عملها، وواجباتها نحو أسرتها وأطفالها، وعلى ذلك، فإن مؤدى إطلاق أحكام هذه الفقرة أن العاملة بالبنك التى صرح لها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها تكون بالخيار بين أمرين، إما أن تضحى بحق طفلها لرعايتها، حتى يضاف لراتبها العلاوة الدورية السنوية، بما يرفع قوته الشرائية عند عودتها إلى العمل، وإما أن تضحى بتلك العلاوة أو بجزء منها- رغم حاجتها الماسة لها- وتتفرغ لرعاية طفلها طوال مدة الإجازة المصرح لها بها، أو بجزء منها، وبذلك يكون النص التشريعى المحال- فى النطاق السالف تحديده- قد خرج عن حدود تنظيم حق العاملة بالبنك فى الحصول على هذه الإجازة، إلى حد قد ينتقص من أصل هذا الحق من أطرافه، أو ينقضه من أساسه".
فجاء هذا الحكم، لتعلن المحكمة الدستورية العليا من خلاله بإفصاح جهير، عن موقف لم تحد عنه على مدار تاريخها، وهو حماية حقوق المرأة العاملة، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها تجاه أسرتها، وواجباتها تجاه مجتمعها، في سلسلة متصلة الحلقات من الأحكام، التي لا يتسع مجال هذا البحث لعرضها، أكتفاء بعرض الأبرز منها، لتكون بذلك- كعهدها دائما- نموذجاً- يحتذى في التمكين للمرأة العاملة، فالعلاوات الدورية جزء لا يتجزأ من الدخل يضاف إلى الراتب، ويؤدى حرمانها منه إلى تقليص مدخولها دون ذنب جفته سوى أنها حصلت على إجازة لرعاية طفلها.
وإذا كان حق العمل لا ينفصم عن الحق في الحصول على المعاش، فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 7/3/2010، في القضية رقم 68 لسنة 29 قضائية "دستورية" على هذا المعنى قضت بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه، وكانت رحى المنازعة الموضوعية تدور حول مطالبة المدعية باحتساب كامل مدة اشتراكها فى نظام التأمين الاجتماعى بما فيها مدة اشتراكها عن عملها بالصيدلية المملوكة لزوجها، وكان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى مجال تحديد المنتفعين بأحكامه يقضى فى المادة (2) منه بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لقانون العمل، وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981- الذى يحكم علاقة العمل التى كانت قائمة بين المدعية وزوجها إبان فترة عملها بالصيدلية المملوكة له، ينص على ألا تسرى أحكامه على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، بما مؤداه: استبعاد هذه الطائفة من الإفادة من نظام التأمين الاجتماعى، وجاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة لمنطوقه مايلى: "وحيث إن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى دون سبب منطقى يبرر ذلك سوى أنهم يعملون لدى رب عمل يعولهم فعلاً، أى أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق فى المعاش يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التى تربطهم برب العمل، حال أن هذه العلاقة، وكنهها، والقواعد التى تنتظمها، ليس لها من صلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، لاسيما وأن الحق فى المعاش يقوم وفقاً للقواعد التى تقرر بموجبها، ويتحدد مقداره على ضوء المدد التى قضاها أصحابها فى الجهات التى كانوا يعملون بها، وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الاجتماعى، وذلك كله ليس له من صلة بطبيعة النظام القانونى الذى يخضع له هؤلاء العاملون فى علاقتهم برب العمل الذين يعملون لديه، ولا ينال من حقهم فى الحصول على معاش عن مدة اشتراكهم فى نظام التأمين الاجتماعى- متى كان ذلك فإن النص المطعون عليه وقد حرمهم من هذا الحق يكون قد خالف حكم المادتين (17، 122) من الدستور".
وبهذا الحكم تكون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت على حق أسرة صاحب العمل- ومنهم الزوجة والإبنة- في الحصول على حقوقهم التأمينية، وهى حقوق كفلتها لهم الدساتير المتعاقبة، لا تنفصم عن حقهم في العمل، فكان حكمها بهذه المثابة وصل لحلقة متصلة من الحقوق، بداية من حقهم في إختيار الجهة التي يعملون بها، وإنتهاء بحقهم في المعاش المقرر لهم وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى، وكلها أمور وثيقة الصلة بالكرامة الإنسانية.
وفى حكم آخر رائد أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/4/2015، في القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية"، واجهت المحكمة الاتجاه المناهض لوجود عنصر نسائى بين الخبيرين النفسى والاجتماعى، ضمن تشكيل محكمة الأسرة، إعمالاً لنص المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وكان المدعى في الدعوى الدستورية يبتغى من دعواه، ألا يعاون محكمة الأسرة، التى تنظر نزاعه الموضوعى مع زوجته التى أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة مطالبة بقيمة مؤخر صداقها، خبيرة من النساء، لما أرتآه من ان اشتراط النص السالف التحديد، لأن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، يؤدى إلى محاباة الزوجة، (المدعية) وفندت المحكمة الدستورية العليا هذه الادعاءات، وقضت برفض الدعوى، وجاء بأسباب حكمها مايلى: "أن ما أوجبه المشرع- بالنص المطعون فيه- من أن يكون أحد الخبيرين، على الأقل من النساء؛ مرجعه أن منازعات الأسرة تدور فى أغلبها حول النساء والأطفال، حيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة؛ بإعتبارها- بطبيعتها- الأكثر تفهمًا في هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يُقبل فيها شرعاً إلا قول النساء، ولا يُقبل فيها قول الرجال، مثل العدة والحيض وما إلى ذلك، وهو ما يُعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، ومن ثم فإن النص المطعون فيه، وإن مايز بين الرجال والنساء - على النحو السالف البيان - فإن هذا التمييز؛ وقد شُيد على أساس القاعدة الموضوعية المشار إليها، فإنه ينهض تمييزًا مبررًا غير قائم على أساس تحكمى".
فدفع هذا الحكم بحيثياته عن المرأة العاملة، مظنة المحاباة لبنات جنسها حال مزاولتها لمهام عملها، بما مؤداه إفتقارها للنظرة للموضوعية والمهنية لمجرد كونها امرأة، وهى الإدعاءات التى طالما طالت المرأة العاملة على مدار سنين كفاحها للحصول على حقوقها، وكانت تلك هى أحدى الذرائع التي تم التذرع بها لإبعادها عن تولى العديد من المناصب، بالإضافة إلى إدعاءات غلبة العاطفة عليها بحكم طبيعتها وتكونيها كأنثى، وقد أثبتت النجاحات المتوالية، والجلية للمرأة في كافة المجالات كذب هذه الإدعاءات، وأن مردها في نهاية الأمر لعنصرية وتحيز ضدها ليس إلا، ولا أساس لها في الواقع.
وفى مجال التمكين للزوجة وحماية حقوقها الدستورية:
أسبغت أحكام المحكمة الدستورية العليا سياجاً فولاذياً من الحماية بكافة أشكالها على الزوجة، سواء في علاقتها بزوجها، أو بالغير، فكانت أحكامها وبحق نقطة تحول تاريخى في كثير من شئونها، فبجلسة 14/8/1994، قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية" نص المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية- الذى خول الزوجة التى تزوج عليها زوجها- ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد الزواج ألايتزوج عليها- أن تطلب الطلاق منه على ضوء شرطين موضوعيين، أولهما: أن يكون قد لحقها ضرر من قبل زوجها- مادياً كان أو أدبياً- على أن يكون هذا الضرر موصوفاً من حيث أثاره بأن يبلغ مداه درجة من الإساءة تكون معها العشرة بين أمثالهما أمراً متعذراً. ثانيهما: أن يكون تقدير هذا الضرر عائداً إلى القاضى، وعليه ألا يطلقها من زوجها طلقة بائنة إلا إذا عجز عن الإصلاح بينهما. وكان الزوج قد أقام دعواه الدستورية متوخياً إبطال ذلك النص بمقولة إهداره الحق في تعدد الزوجات أو تقييده، وقد دحضت المحكم الدستورية العليا هذا الإدعاء بحيثيات حكمها والذى جاء به:-
"أن حق الزوجة التى تعارض الزواج الجديد فى التفريق بينها وبين زوجها، لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لتزوجه عليها، وليس لها كذلك أن تطلب فصم علاقتها بزوجها بإدعاء أن إقترانه بغيرها يعتبر فى ذاته إضراراً بها، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها، بفعل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً، واقعاً لا متصوراً، ثابتاً وليس مفترضاً، مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها، وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعاً، منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما، بما يخل بمقوماتها لينحل إساءه لها- دون حق- اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هى باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها، فإن حقها فى التفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة فى التطليق للضرر المنصوص عليها فى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية".
وفى سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص الذى يعاقب الزوج الذى يدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وهو نص المادة (23 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الزوجة معاقبة زوجها المدعى في الدعوى الدستورية، بالعقوبة المقررة بتلك المادة، لإقراره في وثيقة زواجه الثاني أنه ليس في عصمته زوجة أخرى خلافاً للحقيقة، وقد لجأ الزوج إلى المحكمة الدستورية العليا بغية إبطال هذا النص إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلباته، وقضت برفض دعواه، وسطرت بأسباب حكمها ما يلى:
"إن العلاقة الزوجية لها قدسيتها، بما يجعلها مميزة عن سائر العلاقات بين أفراد المجتمع، وقد اعتبرها القرآن الكريم "ميثاقاً غليظاً" تعبيراً عن رفعة شأنها وعلو منزلتها بحسبانها تقوم على الامتزاج والتكامل بين الزوجين في وحدة يرتضيانها ويستهدفان صون مقوماتها ورعاية حدودها، ومؤدى ذلك أن تظل الأمانة والإخلاص فهذه العلاقة ضماناً لاستمرارها بعيداً عما يعكر صفوها ويعرقل جريان روافدها. متى كان ذلك وكانت العقوبة المقررة بنص الفقرة الطعينة كجزاء على مقارفة الأفعال الواردة به قد فرضتها ضرورة اجتماعية قوامها حماية الأسرة واستمرار الحياة الزوجية على الصدق والوفاء الذى ينافيهما إقدام الزوج على الزواج بأخرى دون إعلام زوجته بذلك حتى تكون على بينة من أمرها، وذلك إعمالاً لقوله تعالى "وعاشروهن بالمعروف" فإن تقرير هذه العقوبة لا يكون مخالفاً للشريعة أو الدستور".
وتكمن أهمية هذين الحكمين، بحيثياتهما المرتبطة بمنطوق كل منهما، في أنهما تضمنا ما يكفى لإسكات عدد من الأصوات التي تعالت في تلك الفترة منادية بتعدد الزوجات، تذرعاً بزيادة نسبة العنوسة، أو زيادة عدد المطلقات، مستترة بستار إعمال تعاليم الدين الحق، منكرة أى حق للزوجة الأولى في الاعتراض على هذا الزواج، أو في طلب الطلاق والحصول على حقوقها الشرعية، أو حتى حقها في أن تخطر بزواج زوجها بأخرى، بزعم أن في ذلك ما ينطوى على مجافاة للشريعة الإسلامية، لتجيء عبارات الحكمين قاطعة في دلالتها على كذب هذه الادعاءات والمزاعم، ولتفندها من الناحية الشرعية، وتقر حق الزوجة في أن تخطر بزواج زوجها بأخرى، ومعاقبة الزوج الذى يدلى ببيانات غير صحيحة للموثق على النحو السالف بيانه.
وانتصرت المحكمة الدستورية العليا لحق الزوجة في الحصول على معاش زوجها في حكمين من أهم ما أصدرته من أحكام، أولهما حكمها الصادر بجلسة 2/1/2011، في القضية رقم 36 لسنة 31 "قضائية" والقاضى بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقى هذه الفقرة، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، التى أقيمت هذه الدعوى بمناسبتها، تدور حول استحقاق المدعية لمعاش عن زوجها المتوفى بتاريخ 14/10/1996، الذى كان قد تزوج بها فى 19/1/1983، بعد بلوغه سن الستين، حال كونها لم تبلغ عندئذ سن الأربعين. وكان صدر الفقرة الثانية من المادة (105) السالفة الذكر قد اشترط لاستحقاق الأرملة معاشًا أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، واستثنت هذه الفقرة من هذا الشرط حالات محددة أوردتها فى بنود ثلاثة، جاء البند (2) منها –المطعون فيه- متعلقاً بحالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، وبشرط ألا يكون للمؤمن عليه، أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين، وكانت لا تزال على قيد الحياة، وجاء اسباب الحكم مايلى: "إنه إذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية، الاجتماعية منها والصحية، بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى، التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. وتلك هـى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، لما كان ذلك، وكان صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى قد اشترط لاستحقاق المعاش بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، فإنه يكون قد حرم الأرملة التى تزوج بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين من خدمات التأمين الاجتماعى، دون سبب منطقى أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، وبغير أن يكفل لها عيشا كريما، وإن اشتراط النص المطعون عليه زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشًا عنه، وبما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند (2) فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الأربعين وقت الزواج، يؤثر سلباً فى الحق فى الزواج، كما ينتقص من الحق فى اختيار الزوجة أو الزوج، بما يفرضه إجحافاً من ظروف تحيط بهذين الحقين، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد غريبة عنهما، ولا تربطها باستحقاق الأرملة معاشاً عن زوجها المتوفى صلة منطقية، وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية، إذ تتعلق هذه الشروط بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية، وخصوصياتها ودخائلها التى يتمثل فيها جوهر الحرية الشخصية والحياة الخاصة اللتين كفلهما الدستور."
والحكم الثاني الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا في هذا المجال كان بجلسة 9/12/2001، فى القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية "دستورية"، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج"، وكان نص المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى محل الطعن، يستلزم عدم الاعتداد بالحكم القضائى الصادر بإثبات الزوجية، إلا إذا كانت الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم قد رفعت حال حياة الزوج، وكانت المدعية فى الدعوى الموضوعية سبق وأنه صدر لصالحها حكمُ ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وورثة زوجها، بإعتبارها أرملته، وتستحق الثمن فى تركته، ومن ثم ربط معاش شهرى لها، فقامت الهيئة المذكورة بصرف معاش لها لمدة عشرة أشهر، ثم اوقفت صرفه إعمالا لنص المادة (105) محل الطعن، إذ أقامت المدعية دعواها بإثبات الزواج بعد وفاة الزوج، فقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص وجاء بحيثيات حكمها ما يلى: "وحيث إن النعى على النص الطعين لانطوائه على حكم يخالف الدستور، هو نعى صحيح، ذلك أنه إذ ناطت المادة (122) من الدستور بالقانون أن يعين قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، فإن القاعدة القانونية التى تصدر بهذا التعيين ، إنما يستند وجودها إلى حكم المادة (122) من الدستور، إلا أن اكتمال دستوريتها لا يتحقق إلا باتفاقها مع باقى أحكام الدستور وأخصها مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور"، فإن النص محل الطعن، بإعتداده بالحكم القضائى لثبوت الزواج بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ، وعدم إعتداده بالحكم المماثل، والصادر فى دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، يكون قد أجرى تفرقة تستند إلى حالة المدعى عليه من حيث الحياة أو الموت ، وقت رفع الدعوى، وهى حالة منفصلة ومنبتّة الصلة بجوهر الحق الذى يكشف عنه الحكم القضائى بثبوت الزواج، بإعتباره فى جميع الأحوال عنوان الحقيقة، وقد ترتب على هذه التفرقة، التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتماثلة فى درجة حجيتها وفى الحق الواحد الذى قررته".
وبهذين الحكمين أكدت المحكمة الدستورية العليا على مبدأ شديد الأهمية والخطورة في آن، وهو حماية الأرامل والمطلقات من العوز، وكفالة الحد الأدنى من العيش الكريم لهن، معتبرة أن كف الأذى عنهن، هو في ذاته منفعة كبرى لهذه الفئة من السيدات بصفة خاصة، وللمجتمع ككل بصفة عامة، فالتمكين للمرأة إنما يتجسد في صورته الأجلى في حماية الفئة الأضعف، والأكثر احتياجاً مادياً، واجتماعياً، وصحياً، وهو ما نحا إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، في هذين الحكمين، وغيرهما من الأحكام.
وأقرت المحكمة الدستورية العليا مبدأ وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007، في القضية رقم 23 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والقاضى برفض الدعوى التى أقامها أحد الأزواج طعناً على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية التى تنص على أنه: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكماً، حتى لو كانت موسرة، أو مختلفة في الدين"، وأسست المحكمة حكمها القاضى برفض الدعوى على ما يلى: "إن المقرر شرعاً- أن نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها- ولو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين- ليملك زوجها عليها تلك المنافع التى ينفرد بالاستمتاع بها بحكم قصرها عليه بإذن من الله تعالى، ومن خلال تسليمها نفسها لزوجها تسليماً فعلياً أو حكمياً. والنفقة بذلك حق ثابت لها على زوجها فى نكاح صحيح. ومن ثم كان احتباسها أو استعدادها لتمكين زوجها منها، سـبباً لوجوبها، وكان قدرها مرتبطاً بكفايتها، وبشرط ألا تقل عما يكون لازمـاً لاستيفاء احتياجاتها الضرورية، امتثالاً لقوله تعالى ]لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا[- وهذا الحكم الشرعى الذى ردده النص التشريعى فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهو من الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها، التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، الأمر الذى يتفق فيه النص الطعين مع حكم المادة الثانية من الدستور".
فجاء ذلك الحكم توكيداً لحقها الشرعى والقانونى كزوجة في النفقة، وهو من أوجب حقوقها على زوجها، وأولاها بالحماية، وليدعمها في الدفاع عن هذا الحق، إنطلاقاً من فهم صحيح لمبادئ شريعتنا الإسلامية السمحاء، التي أرست منذ قرون لقاعدة إنفصال الذمة المالية للزوجة عن زوجها، مع وجوب نفقتها عليه حتى وإن كانت أكثر منه مالاً، وليس فى ذلك يتعارض مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل، إذ أن المساواة في هذا المقام ليست مساواة حسابية، وإنما مساواة في الحقوق والواجبات، وحقها في النفقة يقابله واجبها في العناية بزوجها وعائلتها، بما يحقق التوازن في العلاقة بينهما، ولا يقوض دعائمها.
وفى مطلع عام 2000 صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 متضمناً في نص المادة (20) منه، التى تقرر حق المرأة في أن تلجأ للقضاء طالبة التطليق للخلع، وهو النص الذى أثار بصدوره ضجة إعلامية ومجتمعية وقانونية واسعة، وأثار جدلاً كبيراً، وانقسمت الآراء بشأنه بين مؤيد، ومعارض، حتى عرض هذا النص على المحكمة الدستورية العليا، فكان ان حسمت الجدل الدائر حوله، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذى قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص مؤكدة على دستوريته، وموافقته للشريعة الإسلامية، وتضمنت حيثيات حكمها تأصيلاً للمسألة من الناحية الشرعية والدستورية بتفصيل يحول دون المجادلة في هذا الأمر من جديد، وبعبارات قاطعة في دلالتها على دستورية هذا التنظيم برمته فجاء به مايلى: "إنه لما كان الزواج قد شُرع- فى الأصل- ليكون مؤبداً، ويستمر صالحاً، وكانت العلاقة الشخصية بين الزوجين هى الصلة التى تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها، لذلك فقد حـرص الشارع -عز وجل- على بقاء المودة وحث على حسن العشرة، ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة، ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق، فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهى العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفى الحدود التى رسمها له الشارع الحكيم، وفى مقابل هذا الحق الذى قرره جل شأنه للرجل، فقد كان حتماً مقضياً أن يقرر للزوجة حقاً فى طلب التطليق لأسباب عدة، كما قرر لها حقاً فى أن تفتدى نفسها فترد على الزوج ما دفعه من عاجل الصداق وهـو ما عُرِفَ بالخُلع. وفى الحالين، فإنها تلجأ إلى القضاء الذى يطلقها لسبب من أسباب التطليق، أو يحكم بمخالعتهـا لزوجهـا، وهى مخالعة قال الله تعالى فيها ]الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[-الآية رقم 229 من سورة البقرة- بما مؤداه: أن حق الزوجة فى مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد ورد به نص قرآنى كريم قطعى الثبوت، ثم جاءت السنة النبوية الكريمة لتُنزل الحكم القرآنى منزلته العملية، فقد روى البخارى فى الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبى- صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق، إلا أنى أخـاف الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أفتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم وأزيد، فقال لها أما الزيادة فلا، فردت عليه حديقته، فأمره؛ ففارقها. وقد تعددت الروايات فى شأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الرواية السابقة ومنها أنه أمره بتطليقها، وفى رواية أخرى أنه طلقها عليه، وكان ثابت بن قيس غير حاضر، فلما عرف بقضاء رسول الله قال: رضيت بقضائه. فالخُلع إذاً فى أصل شرعته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه فى كل من القرآن والسنة. أما أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه- لحكمة قدرها- وتبعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى ذلك، وأن النص المطعون فيه؛ أخذ بمذهب المالكية وأجاز للزوجة أن تخالع إذا ما بغضت الحياة مع زوجها، وعجز الحكمان عن الصلح بينهما، فيخلعها القاضى من زوجها بعد أخذ رأى الحكمين، على أن تدفع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجل الصداق. وليس ذلك إلا إعمالاً للعقل بقدر ما تقتضيه الضرورة بما لا ينافى مقاصد الشريعة الإسلامية وبمراعاة أصولها؛ ذلك أن التفريق بين الزوجين فى هذه الحالة، من شأنه أن يحقـق مصلحـة للطرفين معاً، فلا يجوز أن تُجبر الزوجة على العيش مع زوجها قسراً عنها؛ بعد إذ قررت أنها تبغض الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما حدا بها إلى افتدائها لنفسها وتنازلها له عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردها الصداق الذى أعطاه لها".
وقد جاء هذا الحكم تتويجاً لسلسلة من الأحكام التى سبقته وكرست فيها المحكمة الدستورية العليا لمبدأ حق المرأة فى اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق، إذا استحكم النفور، واستحالت العشرة، وثبت الضرر، وكذا حقها فى طلب التطليق عند نظر الاعتراض على الإنذار بالطاعة الموجه لها من الزوج، وغيرها مما لا يتسع هذا البحث بمحدوديته لسرده، والتي دعمت حق المرأة الشرعى والقانونى في الخلاص من زوج لا تطيق العيش معه، ورفض إجابتها لطلبها بالطلاق، وألجأها لسلوك طريق القضاء، فكان لزاماً مع تزايد تلك الحالات، أن تدعم المحكمة الدستورية العليا موقف المشرع الموافق للشرع والدستور في هذا الشأن.
وفى حكمين من أهم ما صدر عن محكمتنا الدستورية العليا، أقرت حق الزوجة فى إثبات الطلاق، وفى إثبات مراجعة زوجها لها بكافة طرق الإثبات.
ففى حكمها الصادر بجلسة 15/1/2006، فى القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية "دستورية"، قضت بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق"، وكان نص المادة السالفة التحديد يقتصر على الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وكان مبنى النزاع الموضوعى هو طلب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع الزوج المطلق عن إثباته طبقاً للنص المطعون عليه، الذى قصر إثبات الطلاق عند الإنكار على التوثيق والإشهاد، وهو ما يمهد الطريق أمام ضعاف النفوس من الرجال كى يعمدوا إلى عدم توثيق الطلاق رغم إيقاعه على زوجته نكاية فيها، وإضراراً بها، فجاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليوصد الباب أمام هذه النوعية من الرجال، مؤكداً فى حيثياته على أن:
"الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار، فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص، وإن وقع فى دائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، فإنه- فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة- يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الطـلاق، وعلمت به، وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بهـا، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النـص المطعـون فيه، وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة".
وفى حكمها الصادر بجلسة 5/12/2015، فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية "دستورية"، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى، المقامة طعناً على نص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن– تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعية القضاء لها بنفقة متعة، على سند من أنها قد طُلقت على غير رغبتها وبغير سبب من جانبها، الأمر الذى واجهه المدعى عليه- المدعى فى الدعوى الدستورية- بأن المدعية مازالت زوجته؛ إذ راجعها بعد الطلاق الرجعى، وقبل انقضاء عدتها، دون أن يُعلنها بهذه المراجعة، وهو ما أنكرته المدعية، وكان النص المطعون عليه قد اشترط- حال إنكار المطلقة علمها بالمراجعة- أن يتم إعلانها بها بورقة رسمية قبل انقضاء مدة العدة، إذ يجرى على أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض". وأوردت المحكمة بحيثيات حكمها القاضى برفض الدعوى تبياناً شافياً للمسألة فجاء بمدونات هذا الحكم ما يلى: "إن تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص يعد من القواعد الشرعية المقررة، وأنه يجوز لولى الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث والضياع، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بها، وأَلِفَ الناس هذه القيود واطمأنوا إليها بعد أن تبين ما لها من عظيم الأثر فى صيانة حقوق الأسرة. وقد دلت الحوادث على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة - فى حاجة إلى الصيانة والاحتياط فى أمره، لما له من شرف وقدسية تحمل على ضرورة حمايته من الجحود والإنكار، والبعد به عن المفاسد، وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق أو العبث بها. لما كان ذلك، وكان النص المطعون عليه قد واجه احتيال بعض المطلقين طلاقًا رجعيًّا على مطلقاتهن، بإدعاء المراجعة قبل انقضاء العدة، وعدم إخبار المطلقة بها إلا بعد انقضاء العدة الشرعية لها للتحايل على أحكام العدة، أو استهانة بحق المطلقة في العلم بالمراجعة قبل صيرورة الطلاق بائنًا، فأوجب على المطلق أن يعلن مطلقته بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء عدتها، لتفادى إنكارها العلم بهذه المراجعة من ناحية، وحماية لحقوقها الشرعية من جهة أخرى، وبذلك يكون هذا النص قد تحوط لمصلحة جديرة بالحماية، وقصد إلى درء مفاسد ومضار أكبر، وإن النص المطعون فيه قد تغيا من إعطاء الزوجة المطلقة الحق فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلاً لعُرى الزوجية، ليتحقق إلتزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها، وفى الوقت ذاته يحول دون تجاوز الزوج مدة العدة تحايلاً بادعاء المراجعة قبل انقضائها، فإنه يكون قد تغيا تحقيق مصلحة عامة جديرة بالرعاية والحماية، وأتى بتنظيم راعى فيه تباين الحقوق الشرعية للزوج والزوجة مستهدفًا به تحقيق الصالح العام، وحفظ الحق فى العِرض، وسلامة الأسرة".
وقد جاء هذان الحكمان، بهذه الحيثيات ليدفعاً ضرراً بالغاً عن الزوجة والأبناء والمجتمع ككل، وليوصد باباً للتحايل على القانون والتنكيل بالزوجة، والتنغيص عليها، من جانب حفنة من الأزواج منعدمى الضمير، كما أنه بسط حمايته لتشمل الأزواج حسنى النية، من تلاعب بعض الزوجات، وإنكارهن المراجعة، فأضحى هذان الحكمان بمثابة تمكين حقيقى للمرأة من السيطرة على مقدراتها، ومقدرات أسرتها، في مواجهة زوج اختار اللدد في الخصومة سبيلاً للتعامل مع مطلقته، متخذاً من حقه الشرعى فى إيقاع الطلاق، وحقه في مراجعة مطلقته خلال فترة العدة- إذا كان الطلاق رجعياً-، أداة لإخضاعها، وإذلالها، وتحميلها ما لا تطيق، فمكنها الحكم الأول من إثبات الطلاق الواقع عليها بكافة طرق الإثبات، وألزم الحكم الثانى الزوج بأن يعلن زوجتة بالمراجعة بورقة رسمية.
ولم تغفل المحكمة الدستورية العليا عن حقوق الزوجة المسيحية، فقد حفلت العديد من أحكامها بالمبادئ التى تحمى حقوقها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحكم الصادر بجلسة 9/12/2001، في القضية رقم 107 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وكان هذا النص يجرى على أنه: "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته" وكانت المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية طالبة الحكم بإثبات وفاة زوجها، ووالد أبنائها، على سند من أنه قد سافر إلى دولة الكويت عام 1997، وانقطعت أخباره، وفشلت كل المحاولات التى بذلت للعثور عليه، وأن فقده كان في حالة يغلب عليها الظن بهلاكه، وقد انقضت مدة تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده، بما يستوجب الحكم بوفاته حسبما يقضى به حكم المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الواجب الإعمال على النزاع الموضوعى باعتبار أن المدعية وزوجها من الأقباط حال دون إجابتها لطلباتها في دعواها الموضوعية، مما حدا بها إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص، وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة لمنطوقه ليجيبها إلى طلباتها، وجاء بحيثيات هذا الحكم ما يلى: "أن تنظيم أوضاع غيبة وفقد المصريين، هو أمر يتصل بحياتهم الاجتماعية ويندمج بالكامل فى الأحكام الخاصة بتنظيم أحوال الأسرة المصرية فى مفهومها المطلق الذى يتجاوز اختلاف العقائد والأديـان، بما يجعله شأناً مصرياً عاماً لا محل فيه لخصوصية العقيدة وذاتيتها الروحية، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة قد جرى على أن "يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده"، فى حين أن نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد جرى على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته"، فإن مؤدى النصين معاً، أنهما وإن اتحدا فى تنظيمهما لأحكام الغيبة والفقد، فإنهما اختلفا اختلافاً بيّناً فى التنظيم الذى قرره كل منهما بشأن الطائفة المخاطبة بأحكامه، حال أن الطائفتين معاً هما من المصريين، الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة، طالما تعلق الأمر بتنظيم لمسألة بعينها تتصل بحياتهم العامة، وإلا كان فى خضوع بعضهم لتنظيم وخضوع بعضهم الآخر لتنظيم مغاير، تمييزً لمن كان التنظيم الخاضع له أكثر ميزة أو أيسر سبيلاً".
فكان هذا الحكم بمثابة طوق نجاة للزوجات المسيحيات، اللائى فقدن أزواجهن في ظروف يغلب عليها الظن بهلاكهم، إذ صار بوسعهن- شأنهن شأن قريناتهن من المسلمات- أن يستصدرن حكماً بوفاة أزواجهن في تلك الحالة، ويتمكن من الحصول على ميراثهن وميراث أولادهن، والحصول على معاش الزوج، فضلاً عن حقهن في الزواج مرة ثانية إن أردن، وفى كل ذلك حماية لهن نفسياً واجتماعياً ومادياً، من البقاء لعقود طويله دون أن يتمكن من الحصول على هذه الحقوق، مع ما يرتبه ذلك من تحميلهن ما لا يطقن، فجاءت المحكمة الدستورية العليا لترفع عن كاهلهن هذا الحمل، وتتيح لكل زوجة مسيحية تعرضت لهذا الظرف القاسى أن تمضى قدماً في حياتها، وأن ترعى مصالح أبنائها، بعذ مضى أربع سنوات على فقد الزوج، وليس بعد 30 سنة.
وفى مجال التمكين للأم وحماية حقوقها الدستورية:-
فامتدادًا لنهج المحكمة الدستورية العليا على مدار تاريخها منذ إنشائها وحتى تاريخه، فى الحفاظ على الحقوق والحريات التى قررها الدستور للمواطنين جميعاً، من خلال مباشرة دورها فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وانطلاقاً من رسالتها السامية فى التكريس لهذه الحقوق، وتدعيمها من خلال أحكامها، فقد جاءت تلك الأحكام داعمة للأم في أداء رسالتها السامية، مبينة لحقوقها، من خلال ما قررته من مبادئ يبرز منها على سبيل المثال لا الحصر:
حكمها القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى فى تلك الدعوى، وهو من مواليد القاهرة فى 3/4/1991، بثبوت الجنسية المصرية له، تبعًا لإكتساب والدته جنسية المصرية بتاريخ 26/6/1998، حال كونه فى هذا التاريخ قاصرًا، لم يبلغ سن الرشد، وكان نص الفقرة الثانية من المادة (6)، قد قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية على الأولاد القصر للأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية، دون الأم الأجنبية، ليضحى النص المذكور فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لها دون الأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية، هو المانع القانونى الذى يحول بين المدعى وإكتساب الجنسية المصرية تبعًا لإكتساب والدته لها، وتوافرت فى حقه باقى الشروط التى حددها القانون لاكتساب تلك الجنسية، وجاء بحيثيات حكمها السالف الإشارة لمنطوقة ما يلى: "إن الدستور وإن أوكل للمشرع بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (6) تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، فإن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى هذا المجال يحدها القيد العام الذى ضمنه الدستور نص المادة (92) والذى بمقتضاه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، بما لازمه وجوب التزام التنظيم الذى يقره المشرع بالمبادئ الضابطة لسلطته فى هذا الشأن، التى يُعد تحقيقها غاية كل تنظيم يسنه، وفى المقدمة منها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهما، فضلاً عن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع، والذى جعله الدستور بمقتضى نص المادة (10) التزامًا على الدولة، والتى يتصادم معها جميعًا حرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، تبعًا لاكتسابها هذه الجنسية، إسوة بالأب الأجنبى الذى قرر المشرع بالنص المحال حق أولاده القصر فى ذلك، وليضحى النص المطعون فيه وقد قصر هذا الحق على الأولاد القصر للأب الأجنبى دون الأم الأجنبية، متضمنًا تمييزًا تحكميًّا لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أنه باعتباره الوسيلة التى اعتمدها المشرع لتنظيم موضوع اكتساب الأولاد القصر للأجانب المتجنسين بالجنسية المصرية لهذه الجنسية، يتناقض مع الأهداف التى رصدها الدستور، وأقام عليها بناء المجتمع".
وبذلك تكون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت على مبدأ المساواة بين الأب والأم في مجال منح الجنسية لأبنائهما، من ناحية، ورفعت عن كاهل الأم عبئاً مادياً ومعنوياً ثقيلاً من ناحية أخرى، وقررت للأبناء حقاً يمكنهم من العيش تحت سماء هذا الوطن، كمواطنين مصريين، يتمتعون بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون للمواطن الذى حصل على الجنسية المصرية بالتجنس، وتلك حقوق طالما لهجت ألسنة الأمهات، والمنظمات الداعمة لحقوق المرأة في المطالبة بها.
وفى حكمها الصادر بجلسة 5/3/2016، في القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية"، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى بمنح الولاية التعليمية للحاضن ويجرى على أنه:- "وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية". وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول مدى أحقية الحاضنة فى إختيار دور التعليم لأبنائها، دون من له الولاية على النفس، فجاءت حيثيات هذا الحكم لتؤكد على دستورية هذا الحق الذى منحه المشرع للحاضنة، مراعاة للمصلحة الفضلى للمحضون إذ سطرت المحكمة بأسباب حكمها ما يلى: "إن المشرع قد تغيا بأحكام النص المطعون فيه من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التى تثور فى شأن تعليم الأبناء بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس - نكاية فى الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية - عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمى من الدار التى كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى دار أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمى، خاصة إن تم انتزاعه من دار تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، الذى يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع. فأسند بموجب النص المطعون فيه الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، بإعتباره القائم على تربيته ورعايته، والأدرى بميوله واستعداده. وفى الوقت ذاته لم يحرم ولى النفس من المشاركة فى الولاية التعليمية عليه؛ إذ الأصل أن يسعى مع الحاضن إلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، فإن حدث خلاف بينهما فى هذا الشأن، أو تعمد الحاضن إرهاقه بمصاريف تعليم تفوق قدرته المالية، فقد وفر له ذلك النص وسيلة قضائية سريعة، من قاض متخصص فى شئون الأسرة، بإستصدار أمر على عريضة فى شأن المسألة المتنازع فيها، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وبمراعاة مدى يسار ولى الأمـــر، وهو ما يتوافـــق وقــــول الله عز وجل فى الآية (233) من سورة البقـــــرة "لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَّ وُسْعَهَا، لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ". ويقتصر أثر الأمر الصـــادر من القاضى فى هذا الشأن على المسألة محل الخلاف. ومن ثم، فقد توافقت الوسيلة التى أوجدها المشرع بموجب النص المطعون فيه، مع الغاية التى سعى إليها، متمثلة فى حماية مصلحة الطفل الفضلى فى التعليم، وهى من مقاصد الشريعة الإسلامية، لما فيها من حفاظ على عقل ونفس الطفل، وحفاظ على المال بالنسبة لولى الأمر الملزم بالإنفاق".
وبإقرار المحكمة الدستورية العليا لدستورية هذا النص، تكون قد أقرت مذهب المشرع في إتجاهه لحماية الحاضنة والمحضون، مبتغياً المصلحة الفضلى للأخير، وتحرت ليس فقط مدى إتفاق النص محل الطعن لنصوص الدستور، وهو دورها الرئيسى ورسالتها الأسمى- بل كذلك أثر حكمها الصادر في هذا الشأن على المجتمع، الذى صار يعج بالخلافات الطاحنة بين الحاضنات وأولياء النفس، وهى خلافات حطب نارها هم المحضونون، وإحدى أدوات هذه الحرب تهديد مستقبلهم العلمى والدراسى، فلم تكن المحكمة أبداً بمنأى عن واقع مجتمعنا، وما يعتمل داخله من مشاكل، سعت إلى إيجاد حلول لها من خلال مباشرة دورها في الرقابة على دستورية القوانين، وكان سبيلها إلى ذلك هو الموازنة الدقيقة التي تجريها بين الضرورات والنتائج.
وتماشياً مع كل ما تقدم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/5/2008، فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانونين رقمى 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، وكانت رحى النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى ضم ابنه إلى حضانته، إلا أن نص المادة السالفة التحديد حال بينه وبين بلوغ غايته من دعواه الموضوعية: إذ رفع سن الحضانة للصغير والصغيرة إلى الخامسة عشرة، على أن يخيرهما القاضى بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة." وجاء بحيثيات حكمها القاضى بدستورية النص ما يلى : "لما كان المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل فى مضمونها المصالح الحقيقية التى يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها، وكان الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقرر أنه أنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، محققاً لما يهدف إليه من التنظيم الذى يشرع له. فإذا كان قد قدر أنه بما أورده فى النص المطعون عليه يهدف من رفع سن الحضانة، وإعطاء الصغير الحق فى الاختيار عند بلوغ هذه السن، إلى تحقيق المصالح المشروعة للمحضون. وبما يتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من تغير وتطور فى ظروفه وثقافته، دون أن يضيق على الناس أو يرهقهم، فإنه -وقد التزم الضوابط الدستورية فى هذا الشأن- لا يكون قد خالف المادة التاسعة من الدستور أو غيرها من النصوص المنظمة للحق فى تكوين الأسرة وصيانتها".
ولم يكن هذا الحكم إلا تقعيداً لمبدأ رددته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها، ومقتضاه أن الأحكام العملية جميعها متطورة بالضرورة، لأنها تواجه الناس في إحتياجاتهم المتغيرة ومصالحهم المختلفة، وهى بذلك لا تقبل جموداً يبقيها عند لحظة زمنية معينة، على أن يكون الاجتهاد- وهو حق لولى الأمر- واقعاً في إطار المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، فتحديد سن الحضانة بخمسة عشر عامًا، وتخيير الطفل بعد هذه السن في البقاء في يد الحاضن، لا يناقض نص قطعى في ثبوته ودلالته في الشريعة الإسلامية، ولا يجافى أي من نصوص الدستور، ويواكب تطورات العصر، ويوائم بين مصلحة المحضون الفضلى، وبين تمكينه من التعبير عن إرادته، في زمن أنفتحت فيه عقول الصغار على العالم من خلال الإنترنت، وأتسعت مداركهم إلى الحد الذى يسمح لهم في هذه السن باختيار من يرونه أحق بحضانتهم.
واستكمالاً لمسيرة طويلة قطعتها محكمتنا الدستورية العليا ترسيخاً لحقوق المرأة، وتمكيناً لها، وحماية لكيانها،- وبالتبعية- للأسرة بكامل أفرادها، بحسبان أن الأم هى عماد هذا الكيان، فقد أصدرت سلسلة متصلة الحلقات من الأحكام، التى تجيز توقيع عقوبة الإكراه البدنى على الزوج والأب لحمله على أداء مبلغ النفقة المحكوم به للزوجة والأبناء، وكانت باكورة تلك الأحكام الصادرة فى شأن جواز حمل المدين بالنفقة- سواء كان مستحقها زوجته أو أولاده- واقتضائها من الملتزم بها جبراً- ولو بطريق الإكراه البدنى- هو الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 5 قضائية عليا "دستورية" الصادر فى 29/6/1974 بمناسبة فصلها فى دستورية نص المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، الذى يجرى على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو فى أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يتمثل، حكمت بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به، أو أحضر كفيلاً، فإنه يخلى سبيله. وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية".
وبعد صدور هذا الحكم بسنوات قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997، فى القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعناً على نص المادة (293) من قانون العقوبات الذى يجرى على أنه :- "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين ولاترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته، أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة". وجاء بحيثيات حكمها ما يلى: "إن النص المطعون فيه، تقرر أصلاً توقياً لهجر العائلة، ولدعم الأواصر بين أفرادها، فلايمزقها الصراع، ولايهيمن عليها التباغض، بل يكون التراحم بينهم. موطئاً لتعاونهم وفق القيم والتقاليد التى يمليها التضامن الاجتماعى، فلا يتناحرون. ومن ثم كان هجر العائلة جريمة يُعَاقَب عليها فى كثير من الدول المتحضرة، لأنها تعنى التخلى عنها والامتناع عن الإنفاق عليها، وتعريضها للضياع، تقديراً بأن السلطة الأبوية التى يباشرها أصحابها على بنيهم لا تتمحض عن حقوق، بل تقارنها واجباتهم التى لا يملكون التنصل منها، وإلا وجب حملهم عليها بالجزاء الجنائى، لا يتخلصون منه إلا بعودتهم إلى العائلة التى هجروها، ومواصلتهم الحياة معها، على أن تدل قرائن الحال على أن عودتهم إليها، ليس ملحوظاً فيها أن تكون إجراء موقوتاً أو مرحلياً، بل واشية بإرادة بقائهم فى محيطها، استئنافاً للحياة العائلية بين أفرادها".
وفى حكم ثالث حديث أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2016، فى القضية رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية"، قضت برفض الدعوى المقامة طعناً على البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، معدلاُ بالقانون رقم 91 لسنة 2000 فيما تضمنه هذا البند من نهائية الحكم الصادر بالحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وحملت المحكمة حكمها القاضى برفض على ما يلى: "إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن قصر حق التقاضى فى المسائل التى فصل فيها الحكم على درجة واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين: أولهما: أن يكون هذا القصر قائمًا على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها. ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية فلا تراجعها فيما تخلص إليه من ذلك جهة أخرى.
فجاءت هذه الأحكام، المتتابعة زمنياً، المتكاملة منهجياً، لتكمل مسيرة بدأتها المحكمة الدستورية العليا بإقرار دستورية النصوص الموجبة للنفقة، وكان لابد من إستكمالها بإقرار دستورية الإجراءات الواجب إتخاذها لانفاذ الحكم القاضى بفرض النفقة، وإلا أضحت تلك الحقوق المدعمة بأحكام قضائية نافذة مجرد حبر على ورق، وتكون المشقة التي تكبدتها الزوجة والأم مستحقة النفقة حتى تحصلت على حكم لصالحها، قد ذهبت أدراج الرياح، تاركة الأم وأطفالها يئنون تحت وطأة الحاجة، وهو ما يجافى كافة المبادئ الدستورية.
وفى عام 2013 أصدرت المحكمة حكماً رائداً، جاوزت به حدود حماية الأم إلى حماية الجدة والجد كذلك، فقد أكدت المحكمة على حق الجدة فى التواصل مع أحفادها، ورؤيتهم، عند انفصال الأبوين، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 37 لسنة 33 قضائية "دستورية"، فقضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين. وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب الجدة لأم الحكم بتمكينها من رؤية حفيدتها مرة كل أسبوع، وكان النص المطعون عليه يقصر حق الأجداد فى الرؤية على حالة عدم وجود الأبوين، فقضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها السالف الإشارة لمنطوقه وأوردت بأسباب حكمها ما يلى: "إن النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، قد أخلّ بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذى تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور. ويكون النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة ثم للصغير فى علاقته بأسرته وخاصة أجداده، بما يحمله ذلك من أحاسيس ومشاعر متبادلة بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغير وأبويه، متجاوزًا بذلك إلى الإسهام فى فصم عرى العلاقات الأسرية والتواصل بين أجيالها على أساس من القيم والتقاليد المتوارثة والأطر الثقافية الثابتة، ومتجاهلاً التطورات المتسارعة التي توالت على المجتمع والأسرة، وتعدد الأنزعة فى مجال رؤية الأبوين والأجداد للصغير، بما تحمله من لدد فى الخصومة، وعنت من الحاضنة أو الحاضن فى تمكين الأجداد من رؤية أحفادهم، وما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطف أجدادهم الجياشة وتعلقهم بهم ورعايتهم لهم، وهو ما يؤدى إلى العديد من محن قد تعصف بالصغار".
فأدركت المحكمة الدستورية العليا بذلك الحكم ما فات المشرع، وردت الأمر إلى جادة الصواب، واضعة نصب عينها مصلحة الأسرة جميعها، صغيرها وكبيرها، ومحاولة تجميع شتاتها بعد خلافات مزقت أوصالها، وتفاقمت حتى لم تجد الجدة المسنة من سبيل أمامها إلا ساحات المحاكم تجوبها طلباً لحقها في رؤية أحفادها في نهاية العمر، وصولاً إلى المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكمها المتقدم، إنصافاً لها من نص تشريعى أغفل حقها في التواصل مع أحفادها، وتقر لها ولأحفادها هذا الحق.
وفى مجال حماية حقوق الفتاة الدستورية والتمكين لها:-
فإذا كانت مظلة الحماية التى أسبغتها المحكمة الدستورية العليا قد شملت المرأة العاملة والزوجة والأم، فإنها لم تغفل عن حماية الفتاة فى مراحل عمرها المبكرة، وهى الأولى بالعناية، وإذا كانت الأحكام التى صدرت لصالح الأم والزوجة يعم نفعها يشمل كافة الفتيات على أرض هذا الوطن بشكل غير مباشر، إلا أن المحكمة قد أفردت لحقوقهن من المساحة ما يصب بشكل مباشر فى صالحهن، سواء من خلال أحكامها، أو من خلال تقارير هيئة المفوضين بها، وهى جزء لا يتجزأ من هذا الكيان العظيم، فلم تكن هيئة المفوضين بالمحكمة بمنأى عن هذا النهج الذى أنتهجته المحكمة الدستورية العليا، إذ أن تقاريرها زخرت بالعديد من الأبحاث والآراء الدستورية الداعمة لحقوق المرأة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تقرير هيئة المفوضين المعد فى القضية رقم 289 لسنة 31 قضائية "دستورية". وقد تناول التقرير بالبحث موضوع ختان الإناث من كافة جوانبه الشرعية والدستورية، وخلص إلى نتيجة مؤداها رفض الدعوى المقامة طعناً على نص المادة (242 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الذى يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض إجراء عملية الختان، وجاء بتقرير هيئة المفوضين رداً على الادعاء بمخالفة النصين سالفى التحديد للشريعة الإسلامية ما يلى: "وحيث إنه ليس ثمة نص قطعى الثبوت والدلالة يقرر حكماً فاصلاً قاطعاً فى شأن ختان الإناث– على نحو ما أوردنا تفصيلاً فيما سلف- إذ أن عملية ختان الإناث لم تذكر على الإطلاق فى القرآن الكريم، كما خلت مرويات السنة النبوية الشريفة من دليل واحد صحيح السند يكون فاصلاً فى موضوع ختان الإناث أو يمكن أن يستفاد منه حكم شرعى فى مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية للأنثى. والأحاديث الواردة فى ختان الإناث الصحيحة السند ليس فيها ما يقوم حجة على وجود أمر شرعى محدد فهى– على قلتها إذ لا تتجاوز حديثاً واحداً أو حديثين على الأكثر– ليست فاصلة فى مقطع النزاع. كما أن الخلاف فى الحكم بين السنية والاستحباب والمكرمة فيه دليل قاطع على عدم وجود إجماع فى مسألة ختان الإناث، فأهل العلم سواء القدامى أم المحدثين يرون فى ختان الإناث أنها من قبيل العادات، وليس من قبيل الشعائر، فالذى هو من شعائر الإسلام هو ختان الذكور. وقد قال ابن المنذر: ليس فى الختان (أى للإناث) خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. كما يقول شمس الحق العظيم آبادى (فى عون المعبود): وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة ومخدوشة لا يصح الاحتجاج بها، والذى أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال".
فجاء هذا التقرير الذى أعد عام 2011، فى وقت كان الجدل المجتمعى والاعلامى حول موضوع ختان الإناث محتدماً، ليحسم هذا الجدل، وينتصف لحق الفتيات فى الحفاظ على حرمة أجسادهن، وليقرر بإفصاح جهير بأن هذا الفعل هو عادة قديمة، ولا علاقة له بالدين الإسلامى، ويندرج تحت مفهوم (العنف ضد المرأة)، وهو التعبير الذى أستخدمه المشرع الدستورى فى نص المادة (21) من الدستور القائم، الصادر بعد إعداد هذا التقرير بسنوات ليلزم الدولة بمواجهة كافه أشكال العنف ضد المرأة.
وانتصفت المحكمة الدستورية العليا للفتيات مرة أخرى من خلال ما أرسته من مبادئ فى حكم شديد الأهمية أصدرته بجلسة 18/5/1996، فى القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية "دستورية" وقضى برفض الدعوى المقامة طعناً على قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994، الذى يلزم فى مادته الأولى التلاميذ بالمدارس الرسمية والخاصة بإرتداء زى موحد، وكان المدعى قد أقام دعواه بعد أن امتنعت أحدى المدارس الثانوية عن قبول أبنتيه لكونهما منتقبتين، وقد نعى نص المدعى على هذا القرار مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولمبدأ الحرية الشخصية فجاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا رداً على هذا النعى مايلى:
إن القرار المطعون فيه، قد قرر لكل فتاة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها، هيئة محددة لزيها تكفل فى أوصافها الكلية، مناسبتها لها، ولايكون موضعها من بدنها كاشفا عما ينبغى ستره منها، بل يكون أسلوبها فى ارتدائها كافلا إحتشامها، ملتزما تقاليد وأخلاق مجتمعها، وأن تنازع الفقهاء فيما بينهم فى مجال تأويل النصوص القرآنية، وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها، وإن آل إلى تباين الآراء فى شأن لباس المرأة، وما ينبغى ستره من بدنها، إلا أن الشريعة الإسلامية- فى جوهر أحكامها وبمراعاة مقاصدها- تتوخى من ضبطها لثيابها، أن تعلى قدرها، ولا تجعل للحيوانية مدخلا إليها، ليكون سلوكها رفيعا لا ابتذال فيه ولا اختيال، وبما لا يوقعها في الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى تلقى العلوم على اختلافها، وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من الأعمال التى تختلط فيها بالآخرين، ولا يجوز بالتالى أن يكون لباسها مجاوزا حد الاعتدال، ولا احتجابا لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافا، ولا إسدالاً لخمارها من وراء ظهرها، بل اتصالا بصدرها ونحرها فلا ينكشفان، مصداقا لقوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" واقترانا بقوله جل شأنه بأن "يدنين عليهن من جلابيبهن" فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا ما لا يعد عورة، وهما وجهها وكفاها، بل وقدماها عند بعض الفقهاء "ابتلاء بإبدائهما" على حد قول الحنفية، ودون أن يضربن بأرجلهن "ليعلم ما يخفين من زينتهن". "وإن استقراء الأحكام التى جرى بها القرار المطعون فيه، يدل على أن لكل طالبة أن تتخذ خماراً تختاره برغبتها، ولا يكون ساترا لوجهها، على أن يشهد ولى أمرها بأن اتخاذها الخمار غطاء لرأسها، ليس ناجما عن تدخل آخرين فى شئونها بل وليد إراداتها الحرة، وهى شهادة يمكن أن يقدمها بعد انتظامها فى دراستها".
فوضع هذا الحكم بحيثياته حداً فاصلاً، بين ما يعد من الزى فرضاً شرعياً يتعين الإلتزام به، وما لا يعد كذلك ويمكن أن يتدخل المشرع بتنظيمه بسلطته التقديرية، بالنظر لمدى موائمته لظروف المجتمع، ومواكبته لعوامل تطوره، مع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف، والحرص على تقاليد مجتمعنا.
وكما أثار موضوع ختان الإناث، وموضوع النقاب شرعى للمرأة، جدلاً واسعاً في المجتمع المصرى، فقد أثار موضوع الزواج العرفى الجدل ذاته، مع تزايد حالات ما عرف الزواج العرفى بين الشباب، مما دعا إلى تدخل المشرع بالتنظيم لهذه المسألة، وذلك بنص المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية، وكان هذا التدخل التشريعى ضرورة حتمية لحماية الفتيات من التغرير بهن، والإنزلاق في علاقات يستحيل إثباتها، وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا مؤيداً لنهج المشرع في هذا الشأن إذ قضت برفض الدعوى المقامة طعناً على نص الفترة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية التى تقضى- عند الإنكار- بعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على اول أغسطس سنة 1931، إلا إذا كان الزواج ثابتاً بتوثيق رسمية، وكانت طلبات المدعية امام محكمة الموضوع قد تحددت في طلب ثبوت عقد زواجها العرفى من مورث المدعى عليهم، وهو ما يصادم صريح نص صدر الفقرة الثانية من المادة (17) المطعون عليها، التى لا تجيز قبول هذه الدعوى عند الإنكار، إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، فأقرت المحكمة الدستورية هذا النص تأسيساً على ما يلى:
"إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحرية الشخصية تعد أصلاً يهمين على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هى محورها وقاعدة بنايتها، ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها، ومن بينها الحق في الزواج، وما يتفرع عنه من الحق في تكوين أسرة وتنشئة أفرادها. إن تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحوادث والاشخاص يعد من القواعد الشرعية المقررة، وانه يجوز لولى الأمر ان يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى، وان يفيد السماع بما يراه من القيود تبعاً لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث والضياع، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بها، والف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها بعد ان تبين ما لها من عظيم الأثر في صيانة حقوق الاسرة. وقد دلت الحوادث على ان عقد الزواج- وهو أساس رابطة الأسرة- في حاجة الى الصيانة والاحتياط في أمره، لما له من شرف وقدسية تحمل على ضرورة حمايته من الجحود والإنكار والبعد به عن المفاسد، وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق أو العبث بها لما كان ذلك، وكانت أحكام الشريعة الاسلامية قد خلت من نص قطعى الثبوت أو الدلالة، يحول بين ولى الامر واشتراط اثبات الزواج – عند الانكار- بوثيقة رسمية في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931، تحقيقاً للمقاصد الآنفة البيان، فإن قالة مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، أو اخلاله بمبدأ الحرية الشخصية والحق في تكوين الأسرة، أو تكريس الاخلال بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، يكون على غير أساس خليقاً بالرفض. وأن استثناء قبول دعوى التطليق او الفسخ من اشتراط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية، خلافاً لما اشترطه المشرع من ضرورة ثبوت الزواج ذاته- عند الانكار- بوثيقة رسمية، مرجعة- ان يفتح للنساء اللائى وقعن في مشكلة الزواج العرفى، ولا تجدن مخرجاً منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستندة إليه، باباً للرحمة، فأتاح لهن المشرع سماع دعواهن بطلب التطليق، وواجه بذلك أمراً واقعاً فيه للمرأة يتمثل في تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرفى، ثم هجرها وأهملها أو غاب عنها إلى حيث لا تعلم، ولا تجد فكاكاً من وصمة مثل هذا الزواج، فأجاز لها المشرع رفع دعوى طلب التطليق عليه، وتسمع دعواها هذه إذا كان زواجها ثابتاً بأية كتابة، وفى هذا الأمر عدل، وفيه تصفية لمثل هذه الاوضاع المجحفة بالمرأة".
فجاء هذا الحكم بحيثياته المرتبطة بالمنطوق، إستكمالاً لنهج المحكمة الدستورية العليا، في صيانة حقوق المرأة، والحرص على كيانها، وكرامتها وشرفها، وإعتبارها بين ذويها، وهو ما يجد أصله في تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء، وتقاليد مجتمعنا العريقة، وكرست له نصوص الدستور القائم والدساتير السابقة في العديد من المواد.
وختاماً،،،
تجدر الإشارة إلى أمرين:
أولهما: أننا عرضنا في هذا البحث لغيض من فيض من أحكام محكمتنا الدستورية الصادرة في هذا الشأن.
وثانيهما: أن المحكمة كانت سباقة في إبراز مفهوم التمكين للمرأة، وجوهره رفع مكانتها في المجتمع، بمعاونة كافة أجهزة الدولة وسلطاتها، وهو مفهوم خرج مؤخراً بدعم من القيادة السياسية من الإطار النظرى إلى الواقع العملى الملموس، وأهم عناصره حقها في تحديد خياراتها في الحياة بنفسها سواء داخل المنزل أو خارجه، قبل الزواج أو بعده، وحقها في التعبير عن ذاتها، وحقها في المشاركة في الحياة العامة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتمكين بهذا المعنى هو تمكين اجتماعى وثقافى وسياسى ونفسى، بالإضافة إلى التمكين القانوني (Legal Empowerment) الذى ينبغي ألا يقتصر على سن التشريعات التي تدعم حقوق المرأة، وإنما يتعين أن يكون هناك تفعيل لتلك النصوص التشريعية، من ناحية، بمعاونة أجهزة الدولة المختلفة كل فى مجاله، وهنا يبرز الدور الأجلّ للمحكمة الدستورية العليا من موقعها على قمة الهرم القضائى المصرى، الذى باشرته بإقتدار على مدار أكثر من نصف قرن من تاريخها الحافل، وهو حماية الحقوق التي قررها الدستور للمواطنين جميعاً بصفة عامة، وللمرأة بصفة خاصة، من خلال مباشرة دورها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، على ما قد سلف بيانه تفصيلاً، فكانت ريادتها في هذا الشأن محط أنظار العالم أجمع، وتقديره لها.