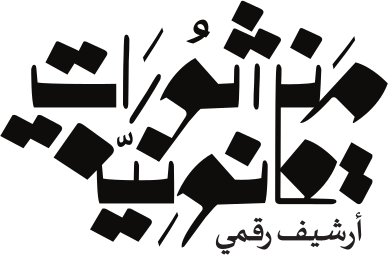أثر تغير الظروف على فهم وتطبيق النص الدستوري
* الكاتب: المستشار محمد خيري طه النجار - النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا
** تنشر "منشورات قانونية" هذا المقال بإذن خاص من الكاتب
الدستور وثيقة غايتها وضع القواعد الحاكمة لحركة الحياة في المجتمع بمختلف جوانبها، وهي وإن كانت قواعد كلية تضع الإطار العام الحاكم لبناء الدولة بمكوناتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تبقى مع ذلك نتاجًا لأسلوب وضع الوثيقة الدستورية والفلسفة التي صدرت في ظلها.
فهي في حقيقتها اشتقاقًا عن السلطة التأسيسية الأصلية، والتي كان الدستور نتاجًا لعملها، وتعبيرًا صادقًا عن الاستفتاء الشعبي التأسيسي الذي وافق عليه، لتكون مقاصدهما التي عبرت عنها عبارات النص الدستوري، وكشفت عنها أعماله التحضيرية، ومجموعة القيم والأفكار والفلسفات الأساسية التي حركت الجماعة إبان وضع الوثيقة الدستورية، أساسًا أيديولوجيًا، حاكما لتفسير نصوص تلك الوثيقة وفهمها وتطبيقها، والذي يتعين أن يتسم دومًا بالمرونة والاتساع ليشمل المتغير من واقع الحياة المجتمعية في مختلف صورها وجوانبها، خاصة بالنسبة للموضوعات ذات الصلة بحقوق الأفراد وحرياتهم وممارستهم الديمقراطية، وأن يراعى عند النظر في أحكام الوثيقة الدستورية قاعدة جوهرية، أنها في تقريرها للحقوق والحريات، إنما تضع في الاعتبار ما يمكن أن يندمج فيها من الحقوق والحريات، التي تشاركها في عللها والقيم التي تحكمها، والأغراض التي تتوخاها، ولو لم يرد النص عليها بهذه الوثيقة، لتضبط تقريرها وتنظيمها، وتمتد إليها الدائرة التي تحكمها، بما يحول بين المشرع العادي وتحريفها.
فالدستور – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا تكون إلا تناغمًا مع روح العصر، وما يكون كافلاً للتقدم في مرحلة بذاتها، يكون حريًا بالاتباع بما لا يناقض أحكامًا تضمنها الدستور[1] ومن هنا كان الدور الهام والجوهري للقضاء الدستوري في تحديد مضامين وأُطر الحقوق والحريات والواجبات، والقواعد الضابطة لتفسير نصوص الدستور وتطبيق أحكامه، بما يضمن لها مسايرة الحاضر بواقعه، والمستقبل بما يحمله من جديد تسعه أحكامه.
ومن أجل ذلك كانت أهمية بحث التطور في مفاهيم بعض أحكامه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، لدوره الفاعل في تحديد نطاق تطبيقها، والدائرة التي تعمل فيها، باعتبارها أحد وسائل الحماية القانونية للحقوق والحريات، وهو الإطار الذي سنخصص له هذا المقال، ويأتي مبدأ المساواة في المقدمة من المسائل الجديرة بالبحث، والذي كان محلاً للعديد من الأبحاث والمقالات، ولكننا سنعرض في هذا المقال لجانب واحد منه، هو الدائرة الحاكمة لإعمال هذا المبدأ، كما حددها قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فقط.
والمتحري لهذا القضاء يتبين منه على ما جرى به قضاء المحكمة، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دومًا بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن[2]،وبذلك عُد التماثل في المراكز القانونية، والتساوي في العناصر المكونة لها، شرطًا جوهريًا وأساسيًا لتطبيق مبدأ المساواة، ليتحدد بذلك نطاق الدائرة التي يعمل خلالها هذا المبدأ، كضابط للرقابة على الدستورية، وتفسير نص الدستور المقرر لهذا المبدأ، والإطار الحاكم لإعماله، ونطاق المطالبة القضائية من قبل المواطنين استنادًا إليه.
غير أن قضاء المحكمة الدستورية العليا لم يتوقف عند هذا الحد، سعيًا منه لتقديم ضمانة أكبر للأفراد من خلال توسيع الدائرة التي يعمل فيها هذا المبدأ، والتخفيف من شرط التماثل في المراكز القانونية، والتساوي في العناصر المكونة له، كشرط لإعمال هذا المبدأ، اكتفاء بضابط التكافؤ في المراكز القانونية، أي اتحاد العناصر الكلية المكونة للمراكز القانونية، الموجبة للتكافؤ في المعاملة القانونية بين أصحاب هذه المراكز، وهو النهج الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا.
فقضت بأن مبدأ المساواة أمام القانون الذي أرساه الدستور بحسبانه ضمانة جوهرية لتحقيق العدل والحرية، والسلام الاجتماعي، لا يقتصر نطاق تطبيقه على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإنما يتعلق كذلك بما يكون منها قد تقرر بقانون في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها أو ينال من ممارستها، بل يتعين أن تنتظمها أسس موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها، وأن العاملين من اسرة صاحب العمل ممن يعولهم فعليًا وغيرهم من العاملين لديه الذين لا يتحقق في شأنهم شرط الإعالة تتكافأ مراكزهم القانونية بالنسبة للحق في المعاش بوصفه حقًا دستوريًا كفله الدستور، بما يستوجب وحدة القواعد التي تنتظمهم جميعًا[3] وقضت المحكمة بأن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها.
إلا أن قوام التمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل او استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها، وكان التكافؤ في المراكز القانونية بين المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي المقرر بقانون المحاماة، يقتضى ألا تكون معاشاتهم التي يستحقونها وفقًا لأحكامه سببًا لحرمانهم من الدخول التي يحصلون عليها مقابل أعمال أدوها، وكان النصان المطعون فيهما ( المادتين 202، 205) من قانون المحاماة، قد قررا أحقية أرملة المحامي في معاش زوجها، كما قررا احقيتها في الجمع بين معاشها وبين دخلها من العمل الذي تقوم به، دون تقرير هذين الحقين للزوج، فإنهما يكونان قد انطويا على تمييز تحكمي بالمخالفة لحكم المادة (40) من الدستور.[4]
وهذا الاتجاه الذي سارت فيه المحكمة الدستورية العليا بأحكامها المتقدمة، هو ما ندعو المحكمة إلى انتهاجه لتوسيع دائرة الحماية القانونية التي يكفل مبدأ المساواة تحقيقها.
وفي هذا المقام يجدر بنا التذكير بأحد المبادئ الهامة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في خصوص مبدأ المساواة، فذهبت إلى أن "الدائرة التي يجيز فيها الدستور للمشرع أن يباشر سلطته التقديرية لمواجهة مقتضيات الواقع، وهى الدائرة التي تقع بين حَدّي الوجوب والنهي الدستوريين، فإن الاختلاف بين الأحكام التشريعية المتعاقبة التي تنظم موضوعًا واحدًا، تعبيرًا عن تغير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة، لا يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة، الذي يستقي أحد أهم مقوماته من وحدة المرحلة الزمنية التي يطبق خلالها النص القانوني الخاضع لضوابط المبدأ، فإذا تباينت النصوص التشريعية في معالجتها لموضوع واحد، وكان كل منها قد طُبق في مرحلة زمنية مختلفة، فإن ذلك لا يُعد بذاته إخلالاً بمبدأ المساواة، وإلا تحول هذا المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة، إلى سد حائل دون التطور التشريعي.[5]
ولعل هذا المبدأ يتوافق مع النظرة الحقة للدستور باعتباره وثيقة تقدمية، تواكب التطورات والمتغيرات، ولا تحول دونها، غير أن هناك ضابط دستوري في هذا الخصوص يتعين عدم تجاهله، والتقيد به، قررته الفقرة الأخيرة من المادة (226) من الدستور الحالي، والتي بمقتضاها لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات، ليضحى هذا القيد قيدًا حاكمًا لكل تعديل دستوري أو تشريعي يتعلق بمبادئ المساواة، يُعد إهداره موقعًا النص التشريعي أيًا كان موضعه في حومة مخالفة الضوابط والقواعد التي تحكم هذا التعديل والتي فرضتها السلطة التأسيسية المُؤَسسة الأصلية، وضمنتها وثيقة الدستور، التي وافق عليها الشعب في استفتاء تأسيسي، والتي يتقيد بها كل تعديل يتعلق بأحكام الدستور، ومن باب أولى النصوص التشريعية الصادرة من المشرع العادي، والتي تمس مبادئ الحرية والمساواة، التي أولاها الدستور عناية خاصة فحظر تعديلها إلا لمزيد من الضمانات.
والحظر المتقدم ليس المقصود به استبعاد الحقوق التي قررها الدستور من نطاق الضمانة الدستورية التي تضمنتها المادة (226) من الدستور السالف ذكرها، ذلك أن الحقوق في مضمونها القانوني هي المكنات التي يخولها الحق ويحوزها صاحبه، وتمثل من هذا الحق العناصر المكونة له، والمحددة لجوهره واصله، لتبقى الحرية دائمًا – بحسب الأصل – هى شق هذا الحق، والدائرة التي يتحرك فيها، والتي تُمارس تلك المكنات والعناصر في إطارها، فالحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة في ذاتها، ولا يتصور أن تعمل في فراغ، وأنه أيًا كان دورها أو وزنها أو أهميتها في بناء النظام القانوني للدولة، فإنها لا تنفصل عن حرياته المنظمة التي تدعمها وتعمل من خلالها.
لذلك كان اهتمام الدستور بالمبادئ الحاكمة للحريات كافة، والتي تمثل الأصول والقواعد الكلية والأساسية التي تقوم عليها – فمبدأ الشئ لغة هو قواعده الأساسية، التي يقوم عليها – والتي ترتبط بها مبادئ المساواة، التي اعتمدها الدستور بمقتضى نص المادة (4) منه، إلى جانب العدل وتكافؤ الفرص، كأساس لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ليكون ضمانهما أولى وأكفل للحقوق والحريات معًا، بوصف تقريرهما إنما يتغيا دومًا توفير الحماية للحقوق والحريات الدستورية، ومواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها أو الاعتداء عليها، من خلال الضمانات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي قررها الدستور، باعتبارها سبيله ووسيلته لكفالة الحماية الدستورية للحقوق والحريات جميعًا، ومن أجل ذلك أحال نص الفقرة الأخيرة من المادة (226) المشار إليه النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة، ويندرج تحتها تلك المتعلقة بضمانات حمايتها بمختلف صورها، إلى نصوص جامدة لا يجوز المساس بها، إلا في النطاق الضيق الذي حدده الدستور، وهو تقديم التعديل لمزيد من الضمانات، التي تكفل لكل من هذين المبدأين وجوده، والدائرة التي يتحرك ويمارس من خلالها، كما عناها الدستور، لتضحى تلك الضمانات هى المحددة لنطاق ذلك الحظر والمعنية به.
والمقصود بذلك الضمانات الإجرائية منها والموضوعية، التي يتعين أن يقدمها التعديل لكفالة مبدأ المساواة وحماية الحقوق والحريات التي قررها الدستور، وكفالة ممارستها على الوجه الذى حدده، ووضع الضمانات اللازمة لذلك، وتحصينها من التعديل إلا لتحقيق المزيد من تلك الضمانات، وليبقى هذا القيد أساسًا دستوريًا حاكمًا لتقييم كل تعديل دستوري أو تشريعي يمس مبادئ الحرية والمساواة أو يتعلق بهما، ويأتي في مقدمة هذه الضمانات وعمدتها، ما نصت عليه صراحة المادة (94) من الدستور من أن "....استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"، ليغدو ضمان استقلال القضاء وحصانته وحيدته، أحد أبرز المبادئ وثيقة الصلة بالحرية والمساواة، والكافلة لهما، وضمانة أساسية لحمايتهما، ذلك أن القضاء فوق كونه أحد السلطات العامة التي نص عليها الدستور، والمكونة لنظام الحكم في الدولة، الذي خصص له الدستور الباب الخامس منه.
فإن ما يقدمه من ضمانات يُعد أهم وسائل حماية الحقوق والحريات كافة، والتي تعتبر شق الحق والحرية، وجزءً لا يتجزأ منه، فلا يتصور وجود الحق أو الحرية أو قيامهما بعيدًا عن وسيلة حمايتهما، التي تُعد الضمانة الأكيدة لوجودهما، وكفالة ممارستها طبقًا لأحكام الدستور، ورد العدوان عليها، وليغدو ضمان استقلال القضاء وحصانته وحيدته سبيلاً لتحقيق العدل للقاضي والمتقاضي، وضمان حقوقهم وحرياتهم الدستورية والقانونية، والحفاظ على الوظيفة القضائية، وضمان استمرار أداء القضاء والقضاة لدورهم الدستوري، والتي ترتبط بالحرية والمساواة باعتبارها الضمانات الأساسية لحمايتهما، بصريح نص الفقرة الثانية من المادة (94) من الدستور – كما سلف البيان – والتي حرص الدستور على توكيدها وكفالتها بموجب التنظيم الذي ضمنه الفصلين الثالث والرابع والخامس من الباب الخامس منه ( المواد من 184 حتى 197 منه)، المحددين للحد الأدنى لضمانات استقلال القضاء وحصانته وحيدته، الذي ارتضته السلطة التأسيسية الأصيلة التي وضعت الوثيقة الدستورية، وأقرها الشعب، والتي تشكل مع نصوص هذه الوثيقة، طبقًا لنص المادة (227) من الدستور نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ تتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
ومن هنا يتضح أهمية تحديد المقصود بالقاضي الطبيعي، الذي كفلته المادة (68) من الدستور الصادر سنة 1971 في نصها على أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي". وتقابلها المادة (97) من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 في نصها على أن " ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي "، وهذا الحق في أصل شرعته، هو حق للناس كافة، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية من جهة لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعي بها، وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.[6]
ولذلك كان لتحري قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن تحديد القاضي الطبيعي في ضـــــوء أحكـــــام الدستور أهميته، باعتباره جوهر حق التقاضي.
وفي هذا الشأن نعرض لقضاء المحكمة العليا الصـــــادر بجلسة 4/3/1978 في الدعوى رقم 21 لسنة 6 قضائية، وكان محلها الطعن على نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من إسناد ولاية الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة ألغاءً وتعويضًا إلى لجنة التأديب والتظلمات، وقضت فيها المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن تلك اللجنة تتوافر لها سمات الهيئات القضائية، إذ تشكل من كبار أعضاء الهيئة باعتبارهم أكثر خبرة ودراية بشأن الهيئة وشئون القائمين عليها، وأقدر على الفصل في منازعاتهم، وكفل لأعضائها ضمانات التقاضي من إبداء دفاع وملاحظات وسماع أقوال وصدور حكم بالأغلبية، وقد عرض هذا النص على المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والتي أصدرت فيها بجلسة 6/5/2000 حكمها القاضي بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنه من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات.
وعلى الرغم من سابقة قضاء المحكمة العليا بحكمها المتقدم برفض الدعوى المقامة طعنًا على ذلك النص، وذلك تأسيسًا على "إنه في مقام المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وعلى الأخص منها طلبات الإلغاء والتعويض، فقد استحدث قانونها الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، لجنة التأديب والتظلمات، واختصها - فضلاً عن تأديب أعضاء تلك الهيئة - بالفصل بقرارات قضائية نهائية في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم، وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، وقد استمد هذا النظام في جوهره مما كان متبعًا بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة، وهو ما دعا المحكمة العليا أن تقضى في الدعوى رقم 21 لسنة 6 قضائية "دستورية" برفض المطاعن الدستورية الموجهة إلى نص المادة (25) من قانون تلك الهيئة. بيد أن مسيرة التشريع لم تتوقف عند هذا الحد بالنسبة للاختصاص بالمنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة - الذين قيس عليهم أعضاء هيئة قضايا الدولة عند صدور قانونها سالف الذكر - ولا بالنسبة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، فقد صدر القانون رقم 50 لسنة 1973 الذى تناول بالتعديل نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة بحيث أصبحت تقضى بأن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وفى طلبات التعويض عنها، وبمثل هذا جرى نص المادة (40 مكررا -1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989، أما قانون السلطة القضائية فقد عهدت المادة 83 منه - معدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - بهذا الاختصاص في شأن رجال القضاء والنيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض. وقد دلت هذه القوانين جميعها، على أن رد هذا الاختصاص إلى المحاكم، يمثل ضمانة لازمة لأعضاء تلك الهيئات، عند نظر طلبات الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم. وحيث إن القانون، وإن عهد قبلُ بطلبات الإلغاء والتعويض بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة إلى اللجنة المشكلة بالنص المطعون فيه، بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي، إلا أن المشـــــــــرع وقد قدَّر بعد وبنفســــــــه - على ما اتضح من مسلكه إزاء تحديد الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى - أن المحاكم وحدها هي الأقدر على الفصل فى هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي تلابسها عادة، لكى ينال أعضاء هذه الهيئات الترضية القضائية إنصافًا؛ فإن إفراد أعضاء هيئة قضايا الدولة وحدهم بالإبقاء على اختصاص اللجنة المشار إليها في هذا الشأن، يعد إخلالاً بمبدأ المساواة في مجال حق التقاضي، رغم توافر مناط إعماله، مكرسًا بذلك تمييزاً غير مبررًا بينهم وبين أعضاء الهيئات القضائية الأخرى في هذا المجال، معطلاً مبدأ خضوع الدولة للقانون[7]، ومن ثم انتهت المحكمة إلى القضاء المتقدم.
ولذات الأسباب قضت المحكمة في البند أولاً من حكمها الصادر بجلسة 4/8/2001 في الدعوى رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ"، "بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات النهائية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها".
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2018 في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية "دستورية" في البند أولاً منه "بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة". على سند من أن النص المطعون فيه السالف الذكر بما تضمنه من النص على اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضي بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضي في شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، مما يتيح لهم حماية أكبر في مجال استئداء حقوقهم، وينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، بالمخالفة لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، والحق في التقاضي، اللذين كفلهما الدستور في المواد (4، 9، 53، 97، 186) منه، فضلاً عن إنه بحرمانه لأعضاء مجلس الدولة من هذه الضمانة يكون قد انتقص من الاستقلال الممنوح لهم بالمخالفة للمواد (94، 184، 190) من الدستور. ومن ثم انتهت إلى القضاء المشار إليه.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا ولذات الأسباب بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2021 في الدعوى رقم 82 لسنة 41 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم، على درجة واحدة. وقضت لذات الأسباب بحكمها الصادر بجلسة 8/4/2023 في الدعوى رقم 47 لسنة 44 قضائية "دستورية" " بعدم دستورية نص المادة (40 مكررًا-1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، على درجة واحدة".
والواضح من استعراض هذا القضاء تغير نظرة المحكمة الدستورية العليا لمفهوم القاضي الطبيعي، فبعد أن اعتدت المحكمة العليا بالاختصاص المقرر للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة في الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها، باعتبارها القاضي الطبيعي للفصل في هذه المنازعات ، وجعلت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، عادت وقضت بعدم دستورية قصر الاختصاص بالنسبة لهذه المنازعات على درجة واحدة، وهو ما قضت به بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وما من شك في أن تغير الظروف والأوضاع التشريعية، كان هو الأساس في هذا التطور في قضاء المحكمة الدستورية العليا سعيًّا منها إلى كفالة تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم مزيدًا من الضمانات لأعضاء تلك الجهات والهيئات القضائية.
هذا وتعتبر الأوضاع الدستورية الحاكمة لتنظيم جهات القضاء هي الأساس في تحديد المقصود بالقاضي الطبيعي، ومن ثم كان تغيرها مفضيًا إلى تحديد كنهه ومضمونه، ولعل القضاء الهام للمحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص هو تلك المفارقة في الاصطلاح التي أجرتها المحكمة بين السلطة القضائية من جهة، وبين الهيئات القضائية من جهة أخرى، والهيئات ذات الاختصاص القضائي من جهة ثالثة، فالأولى: هي إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتقوم على ولاية القضاء وتستقل بشئون العدالة، في مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأما الثانية: فجامعها أنها هيئات تسهم في سير العدالة، وأما الثالثة: فهي الهيئات التي خولها المشرع ولاية الفصل في خصومات محددة حصرًا بأحكام تصدرها بعد اتباع الإجراءات القضائية، وفي إطار من ضمانات التقاضي، فهي جهات ذات اختصاص استثنائي[8]، وكان المرجع في إسناد الفصل في بعض الخصومات استثناء إلى إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي، هو التنظيم الدستوري الذي تضمنه الدستور الصادر سنة 1971، الذي نص في المادة (167) منه على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم"، وبذلك أجاز التنظيم الذى حواه الفصل الرابع من هذا الدستور للسلطة القضائية (المواد من 165 إلى 173) للمشرع إيلاء سلطة القضاء فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعي، وذلك في أحوال استثنائية تكون الضرورة في صورتها المُلجئة هي مدخلها، وصلتها بالمصلحة العامة في أوثق روابطهــــــا مقطوعًا بها، ومبرراتهـــا الحتمية لا شبهة فيها، بحيث لا يصير ما يقرره الدستور في المادة (167) المشار إليها موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم، أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها، وبذلك أتاحت هذه الأوضاع الدستورية للمشرع توسيع دائرة ما يدخل في عداد الجهات صاحبة الولاية القضائية بالفصل في المنازعات، والذى يعد في جانب منه تغير في مفهوم القاضي الطبيعي في الإطار المحدد لمضمونه ومحتواه، وهى النظرة التي تغيرت بعد صدور الدستور الحالي، والذى انتهج في هذا الشأن نهجًا جديدًا كان له تأثيره على تحديد المقصود بالقاضي الطبيعي، منظورًا في كل ذلك – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الأصل في نصوص الدستور أنها تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليا نظام الحكم في الدولة، وهى باعتبارها كذلك تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها والعمل بموجبها، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وأحقها بالنزول على أحكامها، وإذ كان الدستور قد حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية، وما تباشره من أعمال أخرى لا تدخل في نطاقها، بل تعد استثناء يرد على أصل انحصار نشاطها في المجال الذى يتفق مع طبيعة وظائفها، وكان الدستور قد حصر هذه الأعمال الاستثنائية، فقد تعين على كل سلطة في مباشرتها لها أن تلتزم حدودها الضيقة، وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التي عينها الدستور، وإلا وقع عملها مخالفًا لأحكامه.
وحيث إن الوثيقة الدستورية الصادرة في 18/1/2014 كانت نتاجًا لثورة 25 يناير – 30 يونيه تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، والتي جعلت غايتها كتابة دستور جديد يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، ويفتح أمام شعبها طريق المستقبل، ويصون حقوق أفراده وحرياتهم، ومن أجل ذلك حرص المشرع الدستوري على تخصيص الباب الخامس من الدستور الوارد تحت عنوان نظام الحكم لتحديد السلطات العامة في الدولة.
فتناول الفصل الأول منه السلطة التشريعية، وحدد القواعد التي تحكم تكوينها واختصاصاتها، ثم خصص الفصل الثاني منه بأفرعه الثلاث للسلطة التنفيذية بمكوناتها الثلاث، وهى رئيس الجمهورية والحكومة، والإدارة المحلية، وحدد الأحكام الخاصة بتكوين كل منها، والاختصاصات والصلاحيات المسندة لها، ثم أفرد الفصل الثالث من هذا الباب للسلطة القضائية، فأسند توليها بصريح نص المادة (184) منه للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها التابعة لجهات القضاء، كما ضمن هذا الفصل، والفصل الرابع، والفرع الأول والثالث من الفصل الثامن منه، تحديدًا حصريًا لتلك الجهات، لا يجوز للمشرع تجاوزه أو الخروج عليه بأي حال من الأحوال، فعين تلك الجهات في جهة القضاء العادي (القضاء العادي والنيابة العامة) المادتين (188، 189) منه، وجهة القضاء الإداري (مجلس الدولة) المادة (190) من الدستور، والمحكمة الدستورية العليا (المواد 191 إلى 195) منه، والقضاء العسكري واللجنة القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة (المادتين 202، 204) من الدستور.
وقد أفرد المشرع الدستوري في الفرع الأول من الفصل الثالث الوارد تحت عنوان " أحكام عامة"، لبيان الأحكام العامة المشتركة بين جهات القضاء والهيئات القضائية جميعًا، وعين لكل منها كيفية تكوينها، وضمانات استقلالها وحيدتها، وكذا أعضائها، ثم تولي توزيع ولاية القضاء بين الجهات القضائية المشار إليها، فعين لكل جهة من جهات القضاء اختصاصاتها، وجعل بمقتضى نص المادة (188) منه جهة القضاء العادي، هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهات القضاء الأخرى، محددًا بذلك الدائرة التي ينحصر فيها اختصاص المشرع العادي في شأن ما يجد من منازعات خارج نطاق التحديد الدستوري لاختصاص تلك الجهات القضائية - والذي لا يجوز له المساس به أو الخروج عليه أو الالتفات حوله على أيه وجه من الوجوه – وقاصرًا إياه في استخدام الرخصة الممنوحة للمشرع بمقتضى المواد (190، 191، 204) من الدستور، في خصوص تحديد الاختصاصات الأخرى لكل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء العسكري، ليتحدد نطاق استعمال هذه الرخصة في إسناد الاختصاص بهذه المنازعات لأي من جهات القضاء المشار إليها حصرًا، وبما يتوافق مع طبيعة الولاية الدستورية المقررة لها بمقتضى أحكام الدستور، أو تركها لجهة القضاء العادي في نطاق ولايتها العامة التي وسدها لها الدستور، ليمتنع بذلك على المشرع إيلاء الاختصاص بأي من هذه المنازعات لغير تلك الجهات التي عينها الدستور، بعد انتهاء التفويض الذي منحه إياه نص المادة (167) من الدستور الصادر سنة 1971، واستبعاد هذه الرخصة في ظل العمل بالدستور الحالي الصادر سنة 2014، ليستقل الدستور بهذا الاختصاص في تحديد جهات القضاء وتوزيع ولاية القضاء بينها، والذي يجد مبرره في اتصال الأمر بالتكوين العضوي لإحدى السلطات العامة، المكونة لنظام الحكم في الدولة وهي السلطة القضائية، التي اعتبر الدستور بمقتضى المادة (94) منه كفالة استقلالها وحصانتها وحيدنها ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، فوق كونه يعد أمرًا وثيق الصلة بالوظيفة القضائية الموكلة لجهات القضاء، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في إقامة العدل، الذي اعتبرته المادة (4) من الدستور، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية.
فضلاً عن أن تولى المشرع العادي هذا الاختصاص أو جزءًا منه ، يمثل مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن الذي أقام عليه الدستور العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية طبقًا لنص المادة (5) من الدستور، وبالتالي كان عدم تخويل المشرع العادي هذا الاختصاص أمرًا منطقيًا، وله ما يبرره من الوجهة الدستورية، حتى لا يتخذه المشرع العادي سبيلاً للتغول على اختصاص جهات القضاء، واستغراقه، بحيث يتولى الدستور وحدة حصر جهات القضاء، والاختصاص المقرر لكل منها، وتحديد نطاق الرخصة المخولة للمشرع العادي في هذا الشأن، والذي يتعين عليه التقيد بها وعدم الخروج عليها وإلا وقع في حومة مخالفة الدستور، وبذلك أضحى التحديد الدستوري لجهات القضاء واختصاصاتها أمرًا حتميًا لا يملك المشرع منه فكاكًا، والذي يتسع ليشمل ما يرتبط به من أحكام جعل الدستور كفالتها التزامًا دستوريًا على عاتق الدولة، كتلك التي تضمنتها كل من المادتين (96، 240) من الدستور بشأن تقرير استئنافات الأحكام الصادرة في الجنايات، والذى تتحقق به شروط المحاكمة القانونية العادلة المنصفة للمتهم، بما يكفل له الترضية القضائية من الوجهة الدستورية.
فضلاً عن التزام كل من جهات القضاء بنطاق الاختصاص الذي قرره الدستور والقانون، والذي لا يجوز لها تجاوزه على أي وجه من الوجوه، والاعتداء على اختصاص أي من الجهات الأخرى، أيًا كانت صورته، والذي يعد تخومًا لا يجوز لها تجاوزها، إذ يعد ذلك منها انتهاكًا لأحكام الدستور والقانون، ينحدر بعملها إلى مرتبة العدم، ليغدو محض واقعة مادية، فلا يكون له حجية في مواجهة جهة القضاء صاحبة الاختصاص.
وليضحى تقرير ذلك في مكنة الجهة صاحبة الولاية، لا تشاركها فيه جهة أو سلطة أخري، بوصفه حقًا نابعًا من اختصاصها الأصيل الموكل إليها بمقتضى أحكام الدستور والقانون، وناشئًا عنه، وداخلاً في مضمونه ومحتواه، باعتباره أحد أدواتها لرد العدوان على اختصاصها، وإقامة أحكام الدستور والقانون، وكفالة احترامها والالتزام بها وصونها[9] وبذلك حسم الدستور الحالي مفهوم القاضي الطبيعي في جهات القضاء التي عينها حصرًا في وثيقته، بحيث لا يجوز للمشرع العادي تجاوزه.
يؤكد ما تقدم ويدعمه أن الدستور الحالي أفرد للهيئات القضائية الفصل الخامس منه، وحددها في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، معتنقًا في ذلك التفرقة التي قررتها المحكمة الدستورية العليا السالف ذكرها بين الجهات القضائية والهيئات القضائية، بما يحدثه من انعكاس أكيد على تحديد مفهوم القاضي الطبيعي في ظل الدستور الحالي، على النحو المتقدم بيانه، والذي لا يغير منه النص في المادة (192) من الدستور على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والأخر من جهة أخري منها، وما نصت عليه المادة (239) من الدستور من إلزام مجلس النواب بإصدار قانون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
ذلك أن النص الأول إنما يهدف في جانب منه إلى تصفية الأوضاع بالنسبة للمنازعات المطروحة على المحكمة الدستورية العليا، فوق كونه ينظم الاختصاص الدائم لها بنظر تلك المنازعات المتصور قيامها بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، المنشأة بمقتضي أحاكم الدستور، منها على سبيل المثال اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، المنصوص عليها في المادة (202) من الدستور، والتي تدخل في عداد الهيئات ذات الاختصاص القضائي المنشأة بموجب أحكام الدستور، والتي ذهبت المحكمة الدستورية العليا في شأنها بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017 في الدعوى رقم 168 لسنة 36 قضائية "دستورية"، إلى أن الدستور أقام بمقتضي نص المادة (202) المشار إليها إلى جوار مجلس الدولة، قضاء إداريًا عسكريًا متخصصًا يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عهد إليها بقسط من المنازعات الإدارية، فأوسد إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءًا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضي نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ناهيك عن الخلاف في شأن ما قررته المادة (190) من الدستور من اعتبار مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في شأن الفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، والذي لا يحول بين المشرع وجعل الاختصاص بنظر أيًا منها لسلطات تأديبية أخرى، شاملة مجالس التأديب بنوعيها (الابتدائية والاستئنافية) وما يثار في شأن إعتبارها من الجهات ذات الاختصاص القضائي، والذي يثير مسألة هامة وجوهرية تدور حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطات التأديبية والقرارات الصادرة عنها، والذي سنتناوله في بحث قادم مستقل، ومن ثم كانت الإشارة في المادة (192) من الدستور إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والنص في المادة (239) منه على تنظيم الندب للجان ذات الاختصاص القضائي له ما يبرره، دون أن يعني ذلك انتهاج ذات النهج الذي سلكه الدستور الصادر سنة 1971، وضمنه نص المادة (167) منه المشار إليها، والذي هجره الدستور الحالي الصادر في 18/1/2014، بما لازمه انحصار مفهوم القاضي الطبيعي في ظل هذا الدستور، في التنظيم الحصري الذي حوته نصوصه الصريحة في شأن تحديد جهات القضاء، وتوزيع ولاية القضاء بينها على التفصيل المتقدم، ومؤدى ذلك أن الأوضاع الدستورية الحاكمة لإنشاء وتنظيم السلطة القضائية، تكون هي المحددة والمؤثرة تأثيرًا مباشرًا في تحديد مفهوم القاضي الطبيعي في مضمونه ومحتواه، على نحو ما قررته نصوص الدستور الحالي، بما يخالف مسلك الدستور الصادر سنة 1971، على النحو السالف البيان.
ونعرض في إطلالة أخري لنص المادة (224) من الدستور الحالي التي تنص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقي نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور"، وبمقتضي هذا النص قرر الدستور قاعدة مؤداها استمرار العمل بالقوانين واللوائح السارية قبل صدوره، إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه، وهو نص درجت عليه الدساتير المختلفة، غايته مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على الدستور، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية، وعدم نشوء فراغ تشريعي، دون تطهير هذه التشريعات مما قد يشوبها من عيوب، ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها في ذلك شأن التشريعات الصادرة في ظل الدستور القائم[10] وبما لا يحول دون تعديلها أو إلغائها وفقًا للدستور، من أجل ذلك ضمن الدستور نص الفقرة الثانية من المادة (224) التزامًا دستوريًا على عاتق الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكامه، لتتواكب والنظم والقواعد التي استحدثها الدستور، وهي تتقيد في ذلك بالمدة المعقولة التي تراقبها المحكمة الدستورية العليا، ما لم يقيد الدستور الدولة بميعاد حتمي، يصير الالتزام به غرضًا دستوريًا.
فالدستور لا يتضمن نصوصًا توجيهية، يكون التقيد بها عائدًا إلى تقدير المشرع، ولا هو تعبيرًا في فراغ، ولا يدعو بالنصوص التي يتضمنها، لأمر يكون مندوبًا، بل يقرر بها ما يكون لازمًا، فلا يكون المشرع بالخيار بين تطبيقها أو إرجائها، بل يتقيد بها بالضرورة، فلا يتخطاها أو يميل انحرافًا عنها[11]، بحيث يجب على الدولة في هذه الحالة التزام المهلة التي حددها الدستور وعدم تجاوزها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة عامة جوهرية يقرها الدستور، ويُعد التراخي غير المبرر في هاتي الحالتين، خروجًا من الدولة على التزامها الدستوري المتقدم، قالت فيه المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، إن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكم مجلس الدولة إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور الحالي – الذي طال إهماله من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972 – لا يُعد مبررًا أو مسوُغًا لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة، كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذي يفرضه نص المادة (97) من الدستور الحالي، بكفالة الحق لكل شخص في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، والذي يقتضي أن يوفر نفاذًا مسيرًا إليه، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها، التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الاخلال بالحقوق التي يدعيها، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه استتار المشرع وراء سلطته، فلا يكون عملها إلا انحراف عنها[12]، تلك هي الرؤية التي ذهبت إليها المحكمة الدستورية العليا لمواجهة تراخي الدولة والسلطة التشريعية بها عن التدخل للوفاء بالتزامها الدستوري بتحقيق التوافق بين القوانين واللوائح المعمول بها قبل صدور الدستور، والأحكام التي تضمنتها وثيقته، متى كان هذا التراخي – كما سبق البيان – ليس له ضرورة تبرره، تكون استجابة لمصلحة عامة جوهرية يقرها الدستور، إذ يعد ذلك مجاوزة من الدولة والسلطة التشريعية لأغراض توخاها الدستور، يصمها بإساءة استعمال سلطتها، فوق كونه يُعد مخالفة لالتزامها الدستوري المقرر بالمادة (224) من الدستور، ليكون تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسم المسألة الدستورية المطروحة هو الوسيلة الدستورية باعتبارها الحارسة على أحكام الدستور، دون أن يعد ذلك منها من قبيل رقابة السياسة التشريعية أو رقابة ملاءمة إصدار التشريعات.
إذ أن عدم امتداد الرقابة على الشرعية الدستورية لذلك، لا يعني إطلاق سلطة المشرع العادي في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، وفي حالة صدور قضاء من المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص سابق على العمل بالدستور الجديد، لا يخلو الوضع من أحد فرضين: الأول: أن يكون النص المقضي بدستوريته يتوافق مع أحكام الدستور الجديد، ولا يتضمن مخالفة لأي حكم من أحكامه، وفي هذه الحالة يتعين التقيد بالحجية المطلقة لهذا القضاء المقررة بمقتضي المادة (195) من الدستور الحالي.
وفي ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2016 في دعوى البطلان رقم 1 لسنة 35 قضائية "بطلان" بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على قرار المحكمة الصادر في غرفة مشورة بجلسة 15/1/2013 في الدعويين 153 لسنة 28قضائية "دستورية"، 149 لسنة 29 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (534) من قانون التجارة، لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية" الصادر فيها الحكم بجلسة 1/4/2012 برفض الدعوي المقامة طعنًا على النص.
وجاء بمدونات حكم المحكمة الصادر في دعوى البطلان ردًا على ما أثاره المدعي فيها من مناعي تعود في مجملها إلى صدور دستور جديد سنة 2012 عقب صدور حكم المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على ذلك النص، أشارت المحكمة إلى أن صدور قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الدعويين المشار إليهما لسابقة الفصل في دستورية النص المذكور - بعد نفاذ دستور 2012- يقطع بأن المحكمة لم تجد بعد سندًا، أو مقتضي للعدول عن قضائها في شأن المادة (534) المشار إليها[13]، بما مؤداه وجوب احترام الحجية المطلقة لقضاء المحكمة المتقدم، حتي بعد صدور الدستور الجديد.
أما الفرض الثاني فهو صدور قضاء من المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص التشريعي قبل العمل بالدستور الجديد، الذي أتي بتنظيم مستحدث يضحي معه النص المشار إليه متضمنًا مثالب موضوعية يتصادم بها هذا النص مع أحكام ذلك الدستور، بما مؤداه تغير الظروف والأوضاع الدستورية الحاكمة للبناء القانوني للدولة، يستنهض ولاية المشرع العادي للتدخل بتعديل أو إلغاء النص لتحقيق التوافق بينه وبين أحكام الدستور الجديد، إنفاذًا لالتزامه الدستوري المقرر بالمادة (224) السالف ذكرها، ليضحي تراخي المشرع العادي عن الوفاء بهذا الالتزام إساءة منه لاستعمال سلطته، لينشئ حالة قانونية تخضع في رقابتها من قبل المحكمة الدستورية العليا لضوابط رقابة الإغفال، وغايتها مواجهة قصور التنظيم التشريعي عن الوفاء بالمتطلبات الدستورية، والإخلال بالحماية الواجبة للحقوق والحريات، والذى يتحدد به نطاق المسألة الدستورية التي تطرح على المحكمة الدستورية العليا، ليغدو ثبوت صحة المثالب الموضوعية في حق هذا النص – دون الأوضاع الشكلية التي يحكمها دومًا الدستور المعمول به في تاريخ صدور النص – مبررًا للتصدي لدستورية ذلك النص استجابة للأوضاع الدستورية الجديدة، والتي تعد مسوغًا لإعادة طرح المسألة الدستورية بالنسبة له من جديد، وقد كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة السالف الإشارة إليه، وعدولها عن قضاء المحكمة العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا عليه، استجابة لتغير الظروف والأوضاع التشريعية، وكفالة تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية مبررًا للعدول عن هذا القضاء، ومع ذلك قد يكون من المنطقي أن يقتصر إعمال أثر قضاء المحكمة في هذه الحالة على التاريخ الفرضي لنشوء الالتزام الدستوري على عاتق المشرع العادي بالتدخل لتحقيق التوافق مع التنظيم الدستوري الجديد، في ضوء الرخصة المقررة للمحكمة الدستورية العليا بمقتضي نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998.
الهوامش
[1] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/2/1997 في القضية رقم 7 لسنة 16 قضائية "دستورية".
[2] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/3/2004 في الدعوى رقم 162 لسنة 21 قضائية "دستورية".
[3] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/3/ 2010 في الدعوى رقم 86 لسنة 29 قضائية "دستورية".
[4] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/5/2010 في الدعوى رقم 31 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وذي ذات المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/6/1997 في الدعوى رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية".
[5] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/12/2001 في الدعوى رقم 5 لسنة 22 قضائية "دستورية".
[6] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 16/5/1982 في الدعوى رقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 في الدعوى رقم 120 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية".
[7] يراجع قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية".
[8] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية".
[9] راجع فى كل ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20/1/2019، في الدعوى رقم 62 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الصادرة بجلسة 9/3/2016، ملف رقم 58/1/439.
[10] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/3/1971، في الدعوى رقم 3 لسنة 1 قضائية عليا "دستورية".
[11] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/8/1998، في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية".
[12] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"
[13] في ذات المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/1/2016 في الدعوى رقم 2 لسنة 35 قضائية "بطلان".