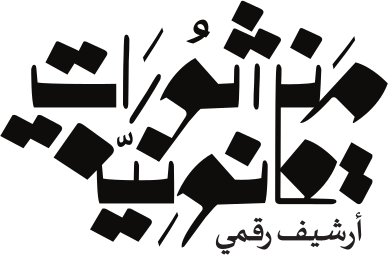المبادئ الحاكمة للفرائض المالية في قضاء المحكمة الدستورية العليا
* الكاتب: المستشار الدكتور طارق محمد عبدالقادر - الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
** تنشر "منشورات قانونية" هذه الورقة بإذن خاص من الكاتب
أرست المحكمة الدستورية العليا، العديد من المبادئ، في مجال تفسيرها لنصوص الدستور، وتحديد مضامينه، باعتبارها وبحكم موقعها من الدستور، هى الحارسة على أحكامه، والقوامة على الشرعية الدستورية، فلها قول الفصل في تفسير نصوص الدستور، وتحديد أطُر الحقوق والحريات التي كفلها، والواجبات والالتزامات التي قررها، وبيان مقاصد المشرع الدستوري من كلٍ منها، منظورًا في شأنها، إلى أن نصوص الدستور ككل لا يتجزأ، هي عماد البناء القانوني للدولة، الذي تستمد منه شرعيتها، وبغيرها تتهادم أركانها وتتقوض، ولذلك كان أمرًا مقضيًا، أن يكون ما تستظهره هذه المحكمة، من نصوص الدستور، هو التفسير الصحيح لها، بلا معقب عليها فيه([1]) ولا مراء فيما تقدم، إذ تقوم هذه المحكمة بدورها، بتفسير نصوص الدستور، أثناء مباشرتها للرقابة الدستورية على القوانين واللوائح، بشرط أن يكون إجراء هذا التفسير، لازماً للفصل في المسائل التي تطرحها الخصومة الدستورية، فإذا كان مجرد تفسير الدستور، هو موضوع هذه الخصومة، خرج هذا التفسير، عن ولايتها.([2])
وتعد المبادئ الحاكمة للفرائض المالية، من أبرز وأهم المجالات، التي أسهمت فيها المحكمة الدستورية العليا، بقضاء وافر، أرست من خلاله مجموعة من المبادئ والضوابط، التي أضاءت الطريق للمشرع، في مباشرته لعمله التشريعي، بما يحول دون قيامه، بانتهاك الحقوق والحريات، التي يتضمنها الدستور تحت ستار تنظيمها، وبذلك يتم العمل التشريعي متكاملاً صناعة ورقابة، ليصدر محققاً مصلحة المجتمع، على أكمل وجه، بل إن قضاءها الملزم لسلطات الدولة كافة،ً تشريعية وتنفيذية وقضائية، يضمن لها، أن تسير في عملها، طبقاً للحدود التي رسمها الدستور، ويوفر للحقوق والحريات التي كفلها الدستور، الضمانة التي نص عليها، بما يصون أصلها وجوهرها، الذي من أجله، حظر الدستور صراحةً، بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة (92) منه، المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، التي لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصًا، كما ضمن نص الفقرة الثانية من هذه المادة، قيدًا عامًا، على سلطة المشرع التقديرية، في مجال تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأى قانون يسنه، ويتناول فيه تنظيم ممارسة أي منها، أن يقيدها، بما يمس أصلها وجوهرها، ليظل اجتهاد المحكمة الدستورية العليا، كجهة قائمة على الرقابة القضائية على الدستورية متواصلاً، في مجال تحديدها لمعاني الدستور، وهى بصدد تفسيره، وتحديد نطاق تطبيقه.
وحيث إن الدستور الحالي، الصادر في 18/1/2014 قد انتهج نهجاً جديداً، في شأن، إعلاء بعض القيم الدستورية، في خصوص الفرائض المالية، إذ نصت المادة الثامنة والثلاثون، من الفصل الثاني من الدستور، والمُعنون "المقومات الاقتصادية" على جملة من المبادئ، ذات الصلة بالفرائض المالية، فنصت على كون النظام الضريبي، إنما يهدف إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، كما أكدت على مبدأ دستوري تليد، ألا وهو مبدأ قانونية الضريبة، الذى مؤداه أن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، كما لا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ويحظر تكليف أحد بأداء أي من الفرائض المالية إلا في حدود القانون. وتوخيًا لتحقيق مبدأ عدالة الضريبة واقعاً، أوجب المشرع الدستوري، أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية، متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، فنص في الفقرة الأولى من المادة (38) منه على أن "يهدف النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة، إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية"، ثم أعقب ذلك، بالنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة، على أن "ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية، متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية..."، ليبقى اختيار الدستور لتطبيق الضرائب التصاعدية متعددة الشرائح، بالنسبة لدخول الأفراد – دون الأشخاص الاعتبارية، والأنشطة الاقتصادية الأخرى – وبمراعاة قدراتهم التكليفية، الوسيلة الأساسية التي عينها الدستور، لكفالة تحقيق العدالة الاجتماعية، بالنسبة لهذه الفئة من الممولين، ولتكون لها الأولوية، في مجال التطبيق([3])، بحيث لا يجوز الخروج عليها أو التحلل منها، إلا للضرورة التي يقدرها المشرع، تحقيقًا لمصلحة عامة جوهرية، أولاها الدستور عنايته، ويوجبها تحقيق النظام الضريبي العادل، كالتزام دستوري على النظام الاقتصادي، قررته الفقرة الثانية من المادة (27) من الدستور، والذي يمثل في الوقت ذاته، قيدًا دستوريًا على اختيار النظام الضريبي الأنسب لكفالة تحقيق ذلك، خاصةً في ظل ما أرساه الدستور الحالي، وضمنه نص المادة (4) منه، بشأن اعتماد مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وضابطًا عامًا، يتعين تفعيل موجباته، في أحد أهم المجالات الدستورية، وهو تحديد النظام الضريبي، الذى يُعد أحد المكونات الجوهرية للنظام الاقتصادي للدولة، إذ تراعي المحكمة الدستورية العليا،- دوماً- في تفسيرها لنصوص الدستور، النظر إليها باعتبارها، تشكل نسيجًا مترابطًا وكلاً لا يتجزأ، تتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة، على ما قررته صراحةً المادة (227) من الدستور، فضلاً عن أن كل ذلك، سيكون تحت الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، التي وسدها إليها الدستور، بمقتضى نص المادة (192) منه.
وقد أرست المحكمة الدستورية العليا، في مجال الفرائض المالية، العديد من المبادئ الحاكمة لها، سواء في مجال فرضها، وطرق تحصيلها، وإمكانية تخصيصها، بتحديد ما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وكذلك ضوابط الاختصاص القضائي بشأنها، وهو ما سنعرض له فيما يلي:
أولاً: في مجال التمييز بين الضرائب وغيرها من الفرائض المالية الأخرى.
مايز الدستور بين الضريبة العامة، وغيرها من الفرائض المالية، فنص على ان أولاهما: لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما: يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون؛ وكان ذلك مؤداه أن السلطة التشريعية، هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون([4]).
فالضريبة العامة، لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية، فيكفى لتقريرها أن يكون في حدود القانون، تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة، بالنظر إلى اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين، وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، مما يحتم موازنتها بالقيود المنطقية، التي ينبغى أن تكون إطاراً لها، فلا تفرضها السلطة التشريعية إلا لضرورة تقتضيها، وعلى ضوء معايير، تكفل عدالتها اجتماعياً.
وقد أقام المشرع الدستورى بذلك، تفرقة فى الأداة التشريعية، فجعل من القانون، وسيلة وحيدة، ومصدراً مباشراً، بالنسبة للضرائب العامة ؛ فالسلطة التشريعية، هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها، وذلك على تقدير أن الضريبة العامة، هى فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة، مساهمةً منه فى التكاليف والأعباء والخدمات العامة، ودون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها، بما ينطوى عليه ذلك، من تحميل المكلفين بها أعباء مالية، تُقتطع من ثرواتهم تبعاً لمقدرتهم التكليفية، ومن ثم فإنه يتعين تقريرها، بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، وهو ما ارتبط من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية، ورقابتها للسلطة التنفيذية، ومن هنا كان القانون، هو وحده وسيلة فرضها.
أما بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى، ومن بينها الرسوم، التى تُستأدى جبراً، مقابل خدمة محددة، يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها ، فقد سلك الدستور فى شأنها مسلكاً وسطاً، بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاعها ، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً، وإنما مقيداً بالقيود التى حددها الدستور ذاته ، وأخصها أن تكون فى حدود القانون أى أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها ، مبيناً العريض من شئونها ، فلا يحيط بها فى كل جزئياتها ، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية فى استكمال ما نقص من جوانبها ، فالقانون هو الذى يجب أن يحدد نوع الخدمة التى يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التى لا يجوز تخطيها، بأن يبين حدوداً لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور، من أن يكون تفويضها، فى فرض هذه الرسوم "فى حدود القانون".
وحيث إن القيود التى قيّد بها الدستور السلطة التشريعية؛ فى تفويضها للسلطة التنفيذية، فى شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضريبة العامة ، تتفق وكون هذه الفرائض، مصدراً لإيرادات الدولة ، ووسيلة من وسائل تدخلها فى التوجيه الاقتصادى والاجتماعى، تأكيداً لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التى تؤديها الدولة، وحتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية، لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها ، ولا يتأتى ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع، لا يكتفى فيه، بمجرد إقرار مبدأ فرض الرسم ، وإنما يتم تحديده فى نطاق السياسة المالية التى تنتهجها السلطة التشريعية، فى مجال تحديد الإيرادات وضبط الإنفاق ، وكفالة تقديم الخدمات التى تلتزم بها الدولة، على أساس من العدل الاجتماعى . ولا يتنافى ذلك مع المرونة اللازمة فى فرض الرسوم، لمجابهة الظروف المتغيرة فى تكاليف أداء الخدمة، طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون بقانون فى كل حالة على حـده، وإنما يتم ذلك فى حدود القانون ، أى بقرار من السلطة التنفيذية، يقع فى دائرة السلطة المقيدة، ولا يتجاوز نطاق التفويض الممنوح من المشرع".([5]).
- أنه إذا كانت الضرائب والرسوم، تعدان من أهم إيرادات الدولة، فإنهما يتمايزان فيما بينهما بحسب ما أبرزته المادة (119) من دستور عام 1971 - المقابلة للمادة (38) من دستور عام 2014 - فى أن الضريبة فريضة مالية، تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهامًا منهم فى الأعباء العامة، ودون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها، فى حين أن الرسوم، تكون مقابل خدمة محددة، يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، ودون تلازم بين قدر الرسم وتكلفة الخدمة. كما يتمايزان فى أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. فى حين أن الرسوم يكون إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، فإن إيرادات الدولة لا تقتصر على هذين المصدرين فقط، وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر، من بينها أثمان المنتجات أو مقابل الخدمات، التى تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة، وتتجلى أبرز الفروق بين هذا المقابل أو الثمن وبين الرسوم، فى أن الرسم يؤدى جبرًا مقابل خدمة من طبيعة إدارية يقدمها مرفق إدارى، أما مقابل الخدمة أو ثمن المنتج، إنما يؤدى لمرفق عام اقتصادى (تجارى أو صناعى)، تقوم فيه جهة من الجهات بإدارة أملاك الدولة، وفقًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، وتحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقًا لمعايير اقتصادية بحتة، وهو اختلاف له أثره فى أن الرسم كقاعدة عامة، يكون مقداره ثابتًا بالنسبة لجميع المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعى الذى فرضه، بينما ثمن المنتج، أو مقابل الخدمة، الذى تطلبه الجهة القائمة على إدارة أملاك الدولة إدارة اقتصادية، يخضع للتغيرات التى تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية، وقد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج، أو الخدمة والمرفق الاقتصادى، بل إنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات، من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها المكانية أو المناخية([6]).
- أن الضريبة العامة، هى التى لا تقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة تنبسط عليها دون سواها، ويتحدد المخاطبون بها فى إطار هذه الدائرة وحدها. بل يعتبر تحقق الواقعة المنشئة لها على امتداد النطاق الاقليمى للدولة -وبغض النظر عن تقسيماتها الإدارية- مرتباً لدينها فى ذمة الممول، بما مؤداه تكافؤ الممولين المخاطبين بها فى الخضوع لها دون تمييز، وسريانها بالتالى -بالقوة ذاتها- كلما توافر مناطها فى أية جهة داخل الحدود الإقليمية للدولة، ولا يعنى ذلك أن يتماثل الممولون فى مقدار الضريبة التى يؤدونها، بل يقوم التماثل على وحدة تطبيقها من الناحية الجغرافية، فالتكافؤ أو التعادل بينهم ليس فعلياً intrinsic، بل جغرافياً Geographic([7]).
- الإلتزام بالضريبة ليس إلتزاماً تعاقدياً، ناشئاً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد هذا الإلتزام إلى نص القانون وحده، فهو مصدره المباشر، وهو ما يملكه ولى الأمر، ويجد دليله الشرعى فى رعاية مصلحة الجماعة، التى يمثلها، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فليس ذلك باعتبارها طرفاً فى رابطة تعاقدية، أياً كان مضمونها، ولكنها- تفـرض – فى إطار القانون العام- الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية، لا يجوز التبديل أو التعديل فيها، بالاتفاق على خلافها، ولا يعنى إقرار السلطة التشريعية لضريبة معينة، أن الخاضعين لها قد أنابوها عنهم فى القبول بها، وأن علاقتهم فى مجالها هى علاقة تعاقدية، أو شبه تعاقدية، ذلك أن إقرار السلطة التشريعية لتنظيم معين، إنما يتم فى إطار ممارستها لولايتها المستمدة مباشرةً من الدستور، والتى لا يجوز لها النزول عنها، وتأتى الضريبة العامة فى موقع الصدارة من مهامها، لاتصالها من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ذاتها، ولما ينطوي عليه فرضها من تحميل المكلفين بها أعباء مالية يتعين تقريرها بموازين دقيقة، ولضرورة تقتضيها. ولو كان حق الدولة فى استئداء الضريبة ناشئاً عن علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى تشتبه بها، لكان لها حق التخلى عنها وإسقاطها بإتفاق لاحق، وهو ما يناقض حقيقة أن الضريبة العامة، لا يفرضها إلا القانون، ولا يتقرر الإعفاء منها إلا وفقاً لأحكامه على ما تقضي به المادة (119) من دستور عام 1971، المقابلة لنص المادة (38) من الدستور الحالي ([8]).
ثانياً: في شأن طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأية متحصلات سيادية أخرى.
المتأمل في صياغة نص المادة (38) من الدستور، يجد انها، قد أبقت على الحكم الوارد، بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (119) من دستور عام 1971 بالنص على ان: لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك فقد أضافت الفقرة الثالثة، من المادة (38) من دستور عام 2014، حكماً خاصاً، لم يكن منصوصاً عليه في دستور عام 1971. والحكم الجديد، هو أن القانون يحدد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى. وعلى ذلك يكون تدخل المشرع وجوبياً، لتحديد طرق وأدوات تحصيل الرسوم والمتحصلات السيادية الأخرى. وهذه النتيجة، تبدو غريبة بعض الشيء، لأن المشرع، وفقاً للنص الدستورى، لا يتدخل إلا من أجل، تحديد الإجراءات الخاصة بالتحصيل، بينما لا يتدخل ابتداءً، لإنشاء الرسوم التي يكون إنشاؤها، في حدود القانون، أي استناداً إلى قانون([9]).
وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا، لأمر قواعد وإجراءات تحصيل الرسوم في الدستور الحالي، حال تعرضها لرسوم النظافة المقررة، إذ قضت بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005، فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص، في تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة، مشيدة قضاءها، تأسيساً على "أن الدستور سلك في شأن الرسوم، التى تُستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة، يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، مسلكًا وسطًا، فأجاز للسلطة التشريعية، أن تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا، وإنما مقيد بالقيود التى حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون فى حدود القانون، أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها فى كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية، فى استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذى يجب أن يحدد نوع الخدمة التى يُحصل عنها الرسم، وحدوده القصوى التى لا يجوز تخطيها، بأن يبين حدودًا لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور، من أن يكون تفويضها فى فرض هذه الرسوم "فى حدود القانون"، والقيود التى قيد بها الدستور، من أن يكون تفويضها للسلطة التنفيذية، فى شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضريبة العامة، تتفق وكون هذه الفرائض، مصدرًا لإيرادات الدولة، ووسيلة من وسائل تدخلها فى التوجيه الاقتصادى والاجتماعى، تأكيدًا لإتاحة الفرص المتكافئة، للحصول على الخدمات العامة التى تؤديها الدولة، وحتى لا تكون الرسوم، مجرد وسيلة جباية، لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، ولا يتأتى ذلك كله، إلا بمسلك متوازن من المشرع. كذلك جرى قضاء هذه المحكمة، على أنه لا يجوز للسلطة التشريعية- فى ممارستها لاختصاصاتها، فى مجال إقرار القوانين - أن تتخلى بنفسها عنها، إهمالاً من جانبها لنص المادة (86) من دستور سنة 1971، والمقابلة للمادة (101) من دستور سنة 2014، اللتين عهدتا إليها أصلاً بالمهام التشريعية، ولا تخول السلطة التنفيذية مباشرتها إلا استثناء، وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرًا، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتى لا يدخل فى مفهومها، توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون، من بيان الإطار العام الذى يحكمها، فلا تُفصل اللائحة عندئذٍ، أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، ولكنها تُشرع ابتداء من خلال نصوص جديدة، لا يمكن إسنادها إلى القانون، وبها تخرج اللائحة، عن الحدود التى ضبطتها بها المادة (144) من الدستور، الصادر سنة 1971، والتى تقابلها المادة (170) من دستور سنة 2014.
وحيث إن الدستور، مراعاةً منه لأهمية الدور الذى تقوم به الأموال العامة، ووجوب توفير الحماية لها، وضبط القواعد الحاكمة لتحصيلها وصرفها، قد جعل القانون هو أداة تنظيم القواعد الأساسية، لتحصيل تلك الأموال، وإجراءات صرفها، وهو ما نصت عليه المادة (120) من دستور سنة 1971، ورددته المادة (126) من الدستور الحالى، والذى أكدت عليه المادة (38) من هذا الدستور بالنسبة للضرائب والرسوم بنصها على أن "..... ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ....."، وذلك باعتبارها من الأموال العامة، وأحد المصادر الهامة والرئيسية لإيرادات الدولة، ورافدًا أساسيًّا من روافد الموازنة العامة للدولة، التى تمكنها من القيام بالمهام التى أوكلها لها الدستور، بما مؤداه أنه، يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها، طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثّم لا يجوز لها أن تفوض السلطة التنفيذية، فى تنظيم الوسائل والأدوات التى يتم بها تحصيل هذه الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون، باعتباره الأداة التى عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت فى حومة مخالفة أحكام الدستور.
وكان نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005، قد فوض المحافظ المختص، فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، حال أن هذه المسائل جميعها، تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد تسلبًا منها من اختصاصها المقرر طبقًا لأحكام الدستور، ولا يرفع هذه المخالفة الدستورية، اشتراط موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، أو أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية ذات الشأن، ومن ثم يقع هذا النص، مخالفًا لنصوص المواد (86، 119، 120) من دستور سنة 1971، وتقابلها المواد (38، 101، 126) من دستور سنة 2014"([10]) .
ثالثاً: في شأن إمكانية تخصيص الفرائض المالية، وتحديد ما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.
سبق للمحكمة الدستورية العليا، وأن تعرضت لهذه المسألة - ابان العمل بدستور 1971- من خلال تعرضها لدستورية تخصيص الفرائض المالية، التى تم تحصيلها، لدعم موارد بعض النقابات المهنية التى عرضت عليها([11]). إذ خلصت فى أحكامها، إلى مخالفة المشرع – فى تخصيصه لهذه الموارد - لقواعد الانفاق العام وجباية الأموال العامة، فى ظل العمل بأحكام دستور عام 1971، وذلك إرساءً لمبدأ عمومية الموازنة، بقاعدتيه المنصبتين، على عدم تخصيص الإيرادات العامة، وعدم خصم النفقات من الإيرادات، تقديراً منها بأهمية تلك القواعد، فى الهيمنة على أوجه الانفاق العام من الأموال التى جمعتها الدولة من ضرائبها ومكوسها وإتاواتها وغراماتها ودومينها الخاص، وغير ذلك من الموارد التى تصب فى خزانتها العامة، لتفقد كلٍ منها- باندماجها مع بعضها البعض- ذاتيتها ولتشكل جميعاً نهراً واحداً لإيراداتها الكلية Consolidated Funds، بل أكدت المحكمة فى قضائها: على أن ضوابط الإنفاق العام وجباية الأموال العامة، التى أملتها المواد (115، 116، 120) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971، تشكل فى مجملها قيوداً تحّد من عمل السلطة التشريعية، فى ألا تخُص أحد الجهات بحصيلة الموارد التى تقوم بجبايتها، فلا يجوز أن تؤول مباشرةً إليها، دون دخولها الخزانة العامة للدولة، لتتضافر مع غيرها من الموارد التى تستخدمها الدولة لمواجهة نفقاتها الكلية، بما يحقق النفع العام لمواطنيها جميعاً.
بيد أنه وعلى الرغم من كل ما تقدم، فقد اجازت المحكمة التخصيص لإحدى الجهات، بضابطين: أولهما: أن تكون الأغراض التى تقوم عليها هذه الجهة، وفقاً لقانون إنشائها، وثيقة الاتصال بمصالح المواطنين فى مجموعهم، أولها: أثارها على قطاع عريض من بينهم، مما يجعل دورها فى الشئون التى تعينهم حيوياً. ثانيهما: أن يكون دعمها مالياً مطلوباً لتحقيق أهدافها، على أن يتم ذلك- لا عن طريق الضريبة التى تفرضها السلطة التشريعية ابتداء لصالحها لتعود إليها مباشرة غلتها- بل من خلال رصد ما يكفيها بقانون الموازنة العامة، وفقاً للقواعد التى نص عليها الدستور، وفى إطار الأسس الموضوعية التى يتحدد مقدار هذا الدعم على ضوئها.
ويبين مما تقدم، أن المحكمة الدستورية العليا، قد تشددت فى قضائها، فى إعمال قاعدة عدم تخصيص الإيرادات، ولم تسمح بالاستثناء منها، إلا بالضابطين المشار إليهما؛ وهو ما يعنى أنها لم تر فى الخروج على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات، مخالفة دستورية فى ذاتها. بل كل ما هنالك أنها ارتأت أن وجه المخالفة، يتجسد فى الإخلال بالضوابط التى فرضها الدستور، فى شأن الإنفاق العام والجباية العامة، من خلال فرض ضريبة لها خصائص الضريبة العامة، التى لا ينحصر تطبيقها فى رقعة أقليمية معينة، لصالح أحد الجهات، لا لتقتضيها الدولة من الملتزمين بها لمواجهة نفقاتها العامة، ومن ثم تدخل الخزانة العامة للدولة، بل تخصصها لصالح تلك الجهة عوناً لها لاستخداماتها، على نحو يُخرج تلك الفريضة عن مجال وظائفها، ويفقدها مقوماتها، وهو ما دعا المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستورية تلك الفريضة لمخالفة فرضها لأحكام المواد (61، 115، 116، 119، 120 ) من دستور عام 1971.
وبملاحظة أحكام الدستور الحالى المعدل عام 2014، نجد أنه وعلى الرغم من تبنى الدستور، فى المادة (124) منه، لمبدأ وحدة الموازنة؛ والذى يقضى – وعلى ما سلف بيانه- بعدم تخصيص الايرادات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة. إلا أن المشرع فى المادة (38) من هذا الدستور، منح المشرع مكنة تحديد ما يودع من ضرائب ورسوم وأى متحصلات سيادية أخرى فى الخزانة العامة للدولة، الأمر الذى قد يفيد بمفهوم المخالفة، إن المشرع يملك تحديد ما لا يودع من الضرائب والرسوم الخزانة العامة للدولة. مما يشي بوجود تعارض ظاهر، فى إعمال مقتضى هاتين المادتين؛ إذ لا يتصور أن يتم إيداع تلك المتحصلات، خارج نطاق الخزانة العامة للدولة، بمعزل عن مبدأ وحدة الموازنة؛ الذى يستلزم، إدراج كافة الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة دون استثناء.
والمتأمل فى صياغة هاتين المادتين (38)، (124) من الدستور، لا يجد أي تعارض بينهما فى هذا الخصوص، ذلك أن سلطة المشرع فى تحديد ما يودع من المتحصلات السيادية بالخزانة العامة للدولة، على النحو الوارد بالمادة (38) من هذا الدستور، تنضبط بضوابط صارمة، يراعيها المشرع حال قيامه بتخصيص أحد المتحصلات السيادية([12]) لصالح مرفق من مرافق الدولة، بما يشكل إستثناء صريح من قاعدة عدم تخصيص الإيرادات، وبذلك يمكن التوفيق بين نصي المادتين (38)، (124) من الدستور الحالى؛ باعتبار أن لكلٍ منها مجالها فى الإعمال والتطبيق، والقول بغير ذلك، يجعل النصوص الدستورية، تتعارض مع بعضها البعض، وهو أمر ينافى قواعد التفسير، ويخالف مبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى تقضي بأن "النصوص الدستورية، ينبغى أن لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التى تؤمن بها الجماعة فى مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دومًا أن يعتد بهذه النصوص، بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالى لقالة إلغاء بعضها البعض، بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية، وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها فى مجموعها، وشرط ذلك اتساقها وترابطها والنظر إليها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونًا ذاتياً، لاينعزل به غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها، متسانداً معها، مقيداً بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التى تجمعها"([13]).
وقد تبنت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه، فأرست مبدأ جديداً، يجيز تخصيص الفرائض المالية لأحد مرافق الدولة، استناداً لصريح نص المادة (38 من الدستور، إذ ذهبت إلى أن مؤدى عجز الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور، والتى تنص على أنه "يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة"، "أن الدستور وإن كان قد أوجب أصلاً عامًا، يقتضى أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة للدولة فى الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديد مصارفها تحت رقابة المؤسسة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المادة (124) من الدستور، بيد أن ما يستفاد من هذا النص، بدلالة المخالفة – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين، التى أعدت مشروع الدستور – أن مقتضى هذا النص، أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفى أضيق الحدود، أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد المالية فى الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة – بحسبانها استثناء من الأصل العام – أداته القانون، وفى حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص، إلا إذا كان الدستور ذاته، قد نص فى صلبه على تكليف تشريعى صريح ذى طبيعة مالية، قدَّر لزوم وفاء المشرع به، وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية، أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع، استناداً إلى أسباب جدية، صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة فى ظل أعبائها. فمتى استقام الأمر على هذا النحو، جاز للمشرع تخصيص أحد الموارد العامة إلى هذا المصرف تدبيراً له، إعمالاً لأحكام الدستور، وتفعيلاً لمراميه"([14]).
وقد تساندت المحكمة الدستورية العليا، إلى مبدأ تخصيص الموارد ذاته، في شأن إعفاء بعض المرافق المهنية، من أداء الرسوم التي تفرضها الدولة، فذهبت في خصوص نقابة المهندسين، إلى أن "المشرع تمكيناً لهذه النقابة من تحقيقها لأهدافها التي أنشأت من أجلها، فقد أعفاها - بموجب النص التشريعى المحال – من جميع الرسوم، التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى، مهما كان نوعها أو تسميتها، وذلك في إطار استعماله لسلطته التقديرية في تنظيم الأعباء المالية العامة، والمحمل بأدائها، وحالات الإعفاء منها، على نحو يحقق المصلحة العامة، ويُمكّن تلك النقابة، من تحقيق الأغراض التي حددها لها على الوجه الأكمل، من خلال مواردها المالية الذاتية، دون أن يقتطع منها جزءًا لتخصيصه للوفاء بالرسوم التي أعفاها منها، ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع، فى موضوع تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعى، موازنًــا بينها، مرجحًــا ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثُقلاً فى مجال إنفاذها. وكان المشرع في مجال سلطته في الاختيار بين البدائل المتاحة أمامه، عند إقراره أحكام النص المحال، قد فاضل بين وجهين من أوجه المصلحة العامة، أولهما: يتمثل في استيفاء الدولة لهذه الرسوم، باعتبارها موارد سيادية، الأمر الذي يصب بشكل مباشر في المصلحة العامة، وينعكس إيجابًــا على إيرادات الخزانة العامة، وقدرتها على الوفاء بما هو موكول إليها. وثانيهما: المصلحة العامة، المتعينة في تمكين نقابة المهندسين، من الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة، وتعبئة قوى أعضائها، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وأهداف التنمية الاقتصادية، وغيرها من الأهداف التي من أجلها قامت النقابة، ويتعذر تحقيقها إلا بالحفاظ على مواردها المالية وتدعيمها. الأمر الذي قدّر معه المشرع، أولوية الوفاء بالهدف الأخير، لكونه الأقرب لتحقيق الصالح العام، من خلال إعفاء النقابة من جميع الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها. ومن جانب آخر، فقد توافرت فى هذا الإعفاء، كافة الضوابط الدستورية المقـــــررة، لتخصيص أحد الموارد العامة لهذه النقابة، من خلال الإعفاء من أدائه، إذ تقرر بموجب القانون، ولتحقيق مصلحة جوهرية، أولاها الدستور عناية خاصة، متوخيًــا من ذلك، عدم الانتقاص من الموارد المالية للنقابة، بمقدار الرسوم محل الإعفاء، حتى تتمكن من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، وتقديم الخدمات المنوطة بها، التى تُعد كفالتها واجبًــا والتزامًــا على الدولة، غايته تحقيق مصلحة جوهرية، أولاها الدستور اهتمامه وعنايته. ومن ثم يكون هذا التخصيص – عن طريق الإعفاء المشار إليه - قد وافق الغايـات الصريحة للدستور".([15])
رابعاً: في شأن سرعة الفصل في قضايا التهرب الضريبى، وجعل جرائم التهرب الضريبى من الجرائم المخلة بالشرف.
أكدت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، على أن "لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره في محاكمة منصفة وعلنية، تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون، تتولى الفصل - خلال مدة معقولة - في حقوقه والتزاماته المدنية أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن في كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه، ومواجهة أدلة خصمه ردًّا وتعقيبًــا، في إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها، وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها في نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هي التي تحدد الملامح الرئيسية التي يتطلبها الدستور في الجهة التي يعهد إليها بالفصل في الأنزعة القضائية".
وكان المشرع، وإن أوجب على المحكمة الجنائية، أن تنظر جرائم التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات، على وجه السرعة، فإنه أسند نظر هــــــذه الطائفــــــة من الجرائم– في ظــــــل العمــــــل بقانــــــون الضرائب العامــــــة على المبيعات - إلى محكمة الجنح، شأنها شأن سائر الجنح، وهي محكمة من محاكم جهــــة القضــــاء العــــادي، يتمتع قضاتهـــا المؤهلين قانونًــا، بسائر الضمانات القانونية التي يتطلبها الدستور، ويتمتعون بالحيدة والاستقلال، وكانت هذه المحكمة، تتحدد سلطاتها وصلاحياتها، بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له، وهي قوانين تتيح لمن يقدم إلى المحاكمة الجنائية، أن يبسط دفاعه كاملًا، وأن يفند الأدلة المقدمة ضده، بسائر وسائل الدفاع والرد دحضًا لها، وتشكيكًا في دلالاتها، توصلاً لنفي التهمة، ولم يفترض المشرع أية قرينة تقيد سلطة المحكمة المعقود لها الاختصاص، في استخلاص النتيجة التي تطمئن إليها، ولم يحل دون حقها في التثبت من توفر أركان الجريمة، متمثلة في الركن المادي، والركن المعنوي لكل جريمة منها، وفي التحقق من انتفاء أسباب الإباحة بأنواعها، وموانع المسئولية بشأنها، ولا من القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، إذا تمكن المتهم من نفي الأدلة المواجـــه بها، أو التشكيك فيها، استصحابًــا لأصل البراءة، أو إثبات تحقق سببٍ للإباحــة، أو مانعٍ للمسئوليــة. ومن ثم فإن النص المطعــــون عليـــــه، يتماهى مع مــا أوجبه المشـــــرع، من أن يولي قضاة هـــــذه النوعية من القضايـــــا أولوية خاصة، لسرعة إنجازهـــــا، دون إخلال بسائر أحكام المنظومة الإجرائية، التي يوجبها الدستور لسلامة المحاكمة الجنائية".
وكان ما قرره المشرع، من حث المحكمة الجنائية، على الفصـــل في جرائم التهــــــــــرب مـــــن الضرائب على المبيعـــــات، على وجـــــه الاستعجال، لا يعدو أن يكـــــون تطبيقًــا للالتزام الدستـــــوري، المنصوص عليـــــه فـــــي المـــــادة (97) منـــــه، الذي أوجب علـــــى الدولـــــة، أن تعمـــــل على سرعـــــة الفصل في القضايــــا جميعهــــا، تحقيقًــا للعدالــــة الناجـــــــزة، فإنـــــه يكون قـــــد وافـــــق التزامات الدولة، المقررة بموجب أحكام الدستور، وإذ كان المشرع، قد قرر أولوية خاصة في سرعة الفصل في هذه النوعية من الجرائم، فإن ذلك، وبالنظر للمصلحة العامة، التي تركن وراء هذا الحكم الخاص، متمثلة في استقرار المراكز القانونية، للمواجهين بتهمة التهرب الضريبي، وحسم مراكزهم القانونية، بالحد من المدة، التي يسلط عليهم فيها سيف الاتهام بها – من جهة- ومصلحة الدولة، في أن تضمن للخزانة العامة، سرعة حصولها على العائد من هذه الضرائب، ومواجهة حالات التهرب من عبئها، من جهة أخرى، فإن ما أوجبه المشرع من سرعة الفصل فيها، يكون قد قام على أسباب محمولة تبررها، دون مساس بالحق فى التقاضى، أو الانتقاص من محتواه أو مقاصده، ويكون تبعًا لذلك، قد وقع في دائرة السلطة التقديرية للمشرع، بما ينأى بهذا النص، عن أى مخالفة لنص المادة (97) من الدستور. ([16])
وفى شأن جعل جرائم التهرب الضريبى، من الجرائم المخلة بالشرف، ذهبت إلى أن الضريبة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعد فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهامًا من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة؛ ومن المقرر أن اتخاذ العدالة يقابل حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، فى تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نائيًّا لتحيفها، وحيدتها ضمانًا لاعتدالها. وكان الجزاء الجنائى الذى فرضه المشرع بالنص المطعون فيه، والذى رآه المدعي مغالاً فيه، إنما تقرر لضرورة تبرره، وهى تنبيه الممولين وحثهم على احترام التزاماتهم الضريبية، وسدادها فـى المواعيد المقررة، وعدم تهربهم من أدائها، وهى جريمة أثمتها المادة (38) من الدستور، وتُعد فى العديد من الدول – ومن بينها مصر - من الجرائم المخلة بالشرف، وذلك تمكينًا للدولة، من الاستمرار فى أداء الواجـبات والمهام المعهودة إليها، وتسيير مرافقها العامة بانتظام واضطراد؛ وقد تقرر هذا الجزاء، كوسيلة نهائية وأخيرة، لحمل الممول على الوفاء بالتزامه الضريبى، وبعد تجاوز الحدود التى يجوز التسامح فيها، بما لا يتبقى معه بعد ذلك عذر، لعزوف الممول عن سداد الضريبة فى المواعيد المقررة، وتهربه من سدادها. وبذلك فإن هذه العقوبة، لا تكـون مقصودة لذاتها، وإنما لتقويم سلوك الأفراد المارقة، المنهى عنه جنائيًّا، وفق قواعد موضوعية، يتساوى الجميع أمامها، ومن خلال منظور اقتصادى، واجتماعى يكفل تحقيق مصالح الدولة، ولا يخل بحقوق الأفراد، مما يصبح معه تقرير هذا الجزاء ضروريًا، ومفيدًا ومبررًا، تحقيقًا للغاية من العقوبة، وهى تحقيق الردع العام والخاص، وليس فيه - من منظور دستورى - مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية.([17])
خامساً: في شأن حظر الرجعية في النصوص الضريبية.
خلافاً لأحكام دستور عام 1971، والذي لم يحظر الرجعية، في النصوص الضريبية، بل كان يشترط مراعاة استيفاء الأغلبية المتطلبة في المادة (187) منه في استيفاء الجانب الشكلى في رجعية القوانين([18]) حظر الدستور الحالي، الصادر عام 2014 بالمادة (225) منه، الرجعية في النصوص الجنائية والضريبية، وأصبح هذا المبدأ، قيداً على المشرع، في عدم إقرار النصوص الضريبية بأثر رجعي، تقديراً من السلطة التأسيسية لخطورة الأوضاع التي تقررها الرجعية في النصوص الجنائية والضريبية، ومساسها بحقوق وحريات الأفراد.
سادساً: في شأن التقيد في فرض الأعباء المالية، بمبدأ العدالة الاجتماعية.
لا ريب في أن الأعباء المالية، والتكاليف العامة، التي تندرج ضمنها الضرائب العامة والضرائب المحلية، إنما تخضع جميعها للعدالة الاجتماعية، التي يمثل التزامها وكفالة تحقيقها، هدفاً دستوريًا للنظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، بصريح نص المادة (۳۸) من الدستور، لتبقى حقائق العدل الاجتماعي التي اعتبرها الدستور، ضابطاً للأعباء المالية على اختلافها، قيداً على كل تنظيم يتناولها من جوانبها المختلفة، وهي في مجال الضريبة، تُعد أساسًا يحدد على ضوئه خصائصها، وبنيانها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وضوابط تقادمها، والجزاء على مخالفة أحكامها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها، وبموجبها يتعين أن يكون قدر إسهام المواطنين في التحمل بعبئها متوازناً ومنصفاً فلا يشق على بعضهم بما يجاوز مقدرتهم على إيفائها، أو بما يتمخض عن مصادرة للأموال محلها، أو يقيم تمييزًا غير مبرر في مجال الخضوع لها، وفي إطار العدالة الاجتماعية، فإن دستورية الضريبة، وغيرها من الموارد الرئيسية لتمويل الموازنة العامة للدولة، يرتبط بخصائص بنيانها، والغاية من فرضها باعتبارها المورد الرئيسي، لتمويل هذه الموازنة على نحو يمكنها من الاضطلاع بمهامها الدستورية.
ولا مراء فيما تقدم، ذلك أن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين أو في الحدود سواء كان فى بنيانها - ضريبة أو رسمًا أو تكليفاً آخر، هي التي نظمها الدستور بنص المادة (۳۸) منه، وكانت هذه المادة، وإن خص بها الدستور النظام الضريبي، متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضمون لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشروع عليها النظم الضريبية على اختلافها، فإن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا مالياً على المكلفين بها، شأنها في ذلك، شأن غيرها من الأعباء التي انتظمتها هذه المادة، ويتعين بالتالي- وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها - أن يكون العدل، من منظور اجتماعي، مهيمناً على هذه الأعباء، بكل صورها، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده يضمن خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة، التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها ([19]). ومن ثم كان منطقياً، أن يُلزم الدستور في المادة (۳۸) منه الدولة، بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر، والإحكام في تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها، والمتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها، الذين تتوافر لهم الواقعة المنشئة للضريبة([20]). وقد كرست المحكمة الدستورية العليا، مبادئ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبى، في أحكامها، والتي نوردها فيما يلى:
-"أن النص فى الفقرة الأولى من المادة (38) من الدستور على أنه "يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة، إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية" مؤداه: أن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضمونًا وإطارًا للنظام الضريبى فى البلاد، إنما يقتضى بالضرورة أن يقابل حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها لمواجهة أعباء الإنفاق العــــــام، ولإجــــــراء ما يتصل بالضريبة من آثار عرضية، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسؤلين عنها، فى تحصيلها منهم وفق أسس موضوعية، لا تتبنى تمييزًا غير مسوغ بينهم، يكون إنصافها نائيًا لتحيفها، وحيدتها ضمانًا لاعتدالها، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا فى شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها".([21])
"أن تحديد دين الضريبة، يتطلب التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتباره شرطاً لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، ويتعين في هذا الإطار، أن يكون وعاء الضريبة، ممثلاً في المال المحمل بعبئها، محققاً ومحدداً على أسس واقعية، يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققا،ً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، وفق الشروط التي يقدر معها المشرع واقعية الضريبة وعدالتها، بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور، التي تتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها وغاية تتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن الأعباء التي انتظمتها المادة (38) من الدستور، ويتعين تبعاً لذلك وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها، أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ". ([22])
-"إن الضريبة بكل صورها، تمثل فى جوهرها عِبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمها نص المادة (38) من الدستـــــور، ويتعين بالتالى – بالنظــــــر إلى وطأتهـا وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا فى شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًّا أن يلزم المشرع الدستورى فى المادة (38) من الدستور الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشأة للضريبة. ([23])
- إن التوقع المشروع، يعتبر أحد الضوابط اللصيقة بحقائق العدل الاجتماعي، التي احتضن بها الدستور الأعباء المالية على اختلافها، والتي يتعين التزامها عند تحديد شروط اقتضائها، فلا يباغتون بها، بما يصادم توقعهم المشروع، فلا يكون مقدارها معروفاً لهم، ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل، فلا يزينون خطاهم، على ضوء تقديرهم سلفاً لها، ولا يعرفون بالتالي لأقدامهم مواقعها، ليكون فرضها، نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها([24]).
- إن قوام الواقعة القانونية المنشأة للضريبة، هي الصلة المنطقية بين شخص محدد، يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاءً لها متحملاً بعبؤها، وهذه الصلة هي التي لا تنهض الضريبة بتخلفها سوية على قدميها، وتتحراها المحكمة الدستورية العليا، لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً، بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدد مضمونها وغاياتها، على ضوء القيم التي احتضنها الدستور، ويندرج تحتها ضرورة أن يكون صور الدخل على اختلافها - أياً كان مصدرها - وباعتباره إيراداً مضافاً إلى رؤوس الأموال التي أنتجتها، وعاءً أساسياً للضريبة، كافلاً عدالتها وموضوعيتها، ومرتبطاً بالمقدرة التكليفية لممولها، فلا ينال اتخاذ الدخل قاعدة لها من رؤوس الأموال في ذاتها، بما يؤول إلى تأكلها أو يحول دون تراكمها، بل تظل قدرتها في مجال التنمية، باقية مصادرها، متجددة روافدها، كذلك فإن المشرع وإن توخى أصلاً بالضريبة التي يفرضها، أن يدير من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام تقتضيها النفقات، فإن طلبها هذه الموارد، لا يجوز أن يكون توجهاً نهماً، مؤثراً في بنيان الضريبة محدداً أسسها، وضوابطها، عاصفاً بحقوق الملكية التي يتصل بها بما ينال من أصلها أو يفقدها مقوماتها، أو يفصل عنها بعض أجزائها، أو يقيد نطاق الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهو ما يعنى أن أغراض الجباية وحدها، لا تعتبر هدفاً يحدد للضريبة مسارها، ولا يجوز أن تهيمن على تشكيل ملامحها، فذلك مما لا يحميه الدستور، وعلى الأخص كلما كان عبؤها فادحاً، يحيل أمرها عسراً. ([25])
- أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابله بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها في تحصيلها وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها. ومؤدى ما تقدم، أن قانون الضريبة العامة، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول على إيرادها هدفاً مقصوداً منه ابتداءً، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية، بوصفها مفهومًا وإطاراً مفيداً لنصوص هذا القانون، فلا يكون دين الضريبة سواء بالنسبة إلى الملتزمين أصلاً بها، أو يكونون مسئولين عنها، متمحضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية، ويفقدها مقوماتها بالتالي لتنحل عدماً. ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك استيفاء لمصلحتها، في اقتضاء دين الضريبة - إلى تقرير جزاءً على الإخلال بها، يكون مجاوزاً - بمداه أو تعدده الحدود المنطقية التي يقتضيها صون مصلحتها الضريبية، وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً، منافياً بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدال، واقعاً عملاً - وبالضرورة - وراء نطاق العدالة الاجتماعية، ليختل مضمونها، بما ينافي القيود التي فرضها الدستور، في مجال تنظيم الضريبة([26]).
- أن العدالة إما أن تكون توزيعية، من خلال العملية التشريعية ذاتها، وإما أن تكون تقويمية، ترتد إلى الحلول القضائية التي لا شأن لها بتخصيص المشرع لتلك المزايا الاجتماعية التي يقوم بتوزيعها فيما بين الأفراد بعضهم البعض، بل قوامها تلك الترضية التي تقدمها السلطة القضائية إلى المضرور، لترد عنهم عدواناً قائمًا أو محتملاً، ولضمان مساواة المواطنين في مباشرة حرياتهم، أو على صعيد الحقوق التي يتمتعون بها، ومؤدى ذلك أن العدالة في غاياتها، لا تنفصل عن علاقتها بالقانون، باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفاً، إلا إذا كان كافلاً لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التي تحتضنها، كان منهياً للتوافق في مجال تنفيذه، ومسقطاً كل قيمة لوجوده، ومستوجباً تغييره أو إلغاؤه([27]).
- إن القانون يعتبر مصدراً مباشرًا للضريبة العامة، إذ ينظم رابطتها محيطاً بها في إطار من قواعد القانون العام، متوخيا ًتقديراً موضوعياً ومتوازناً المتطلبات وأسس فرضها، والأصل أن يتوخى المشرع بالضريبة التى يفرضها أمرين يكون أحدهما: أصلاً مقصوداً منها ابتداءً primary motive ويتمثل في الحصول على غلتها لتعود إلى الدولة وحدها، تصبها في خزانتها العامة لتعينها على مواجهة نفقاتها . ويكون ثانيهما: مطلوباً منها بصفة عرضية أو جانبية أو غير مباشرة incidential motive كاشفاً عن طبيعتها التنظيمية regulatory دالاً على التدخل بها لتغيير بعض الأوضاع القائمة، وبوجه خاص من زاوية تقييد مباشرة الأعمال التي تتناولها أو حمل المكلفين بها - من خلال عبئها – على التخلي عن نشاطهم، وعلى الأخص إذا كان مؤثماً جنائياً كالتعامل في المواد المخدرة. وهذه الآثار العرضية للضريبة كثيراً ما تلازمها، وتظل للضريبة مقوماتها من الناحية الدستورية، ولا تزايلها طبيعتها هذه، لمجرد أنها تولد آثاراً عرضية بمناسبة انشائها.
Every tax is some measure regulatory. To some extent it interposes an economic impediment to the activity taxed as compared with othrs not taxed. But a tax is not any the less a tax because it has a regulatory effect tending to restrict or suppress the thing taxed.
بيد أن الضريبة تتجرد من خصائصها، إذا كان من شأنها تدمير وعائها، أو كان لها وطأة الجزاء، بما يباعد بينها وبين الأغراض المالية التي ينبغي أن تتوخاها أصلاً، وكذلك كلما قام الدليل على انتفاء المصلحة المشروعة التى تسوغها. وهو ما يقع بوجه خاص، إذا كان معدل الضريبة أو أحوال فرضها، مناقضاً للأسس الموضوعية التي لا تقوم الضريبة إلا بها([28]).
- إنه وإن صح أن تتخذ الضريبة، وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين، وفقاً لأسس عادلة، فإنه لا يجوز أن تفرض الضريبة، ويحدد وعاؤها بما يؤدى، إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كُليةً أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور، أن تؤدى فى نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها، ليؤول تنفيذها في النهاية، إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. ومن أجل ذلك كان الدخل - باعتباره من طبيعة متجددة ودورية - هو الذي يُشكل على اختلاف مصادره - الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة. الضريبة، وهو التعبير الرئيسي عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يُشكل رأس المال وعاءً تكميلياً للضرائب، لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه، إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليًا أو تمتص جانباً جسيماً منه([29]).
سابعاً: في شأن الاختصاص القضائى بنظر الفرائض المالية.
أكدت المحكمة الدستورية العليا، من خلال قراءتها لنصوص الدستور الحالي، على الاختصاص القضائى – المنفرد - لمحاكم مجلس الدولة، بنظر منازعات الضرائب والرسوم، باعتبارها تندرج ضمن المنازعات الإدارية، التي يختص بها، مجلس الدولة – وحده دون غيره-، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور الحالي، فذهبت في قضائها، في خصوص الاختصاص القضائى بمنازعات ضريبة الدخل إلى أن "المشرع، قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص فى البند سابعًا من المادة رقم (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم".
وكان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما فى ذلك وعاؤها، والمكلفون بها والملتزمون بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، وكان قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، قد تضمن التنظيم القانونى للضريبة على المرتبات والأجور، وأجازت المادة (118) منه للممول الخاضع لتلك الضريبة، الاعتراض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم، وأوجبت على تلك الجهة إحالة طلبه مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وتتولى المأمورية فحص الطلب، وفى حالة عدم اقتناعها بصحته، فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن التى تتولى الفصل فى أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب العامة والممولين، وقد حددت المادة (120) من هذا القانون تشكيل لجان الطعن فنصت على أن " تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. .....، وتكون هذه اللجان دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها"، وقد عين نص المادتين (121، 122) من ذلك القانون قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها، على نحو يبين منه أن هذه اللجان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون هيئات إدارية، خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات التى تتردد بين مصلحة الضرائب العامة والممولين، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية، قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء، ودون أن تضفى النصوص المتقدمة على تلك اللجان الصبغة القضائية، بل تظل مجرد هيئات إدارية تنأى عن مظلة السلطة القضائية، ليظل ما يصدر عنها قرارًا إداريًّا متعلقًا بهذه الضريبة وأوجه الخلاف حولها بين الممول ومصلحة الضرائب، والتى تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، طبقًا لنص المادة (190) من الدستور الحالى. وإذ أسند النص المطعون فيه، الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات - طبقًا للقواعد والإجراءات التى حددها - إلى المحكمة الابتدائية، التابعة لجهة القضاء العادى، وأجاز الطعن فى أحكامها بطريق الاستئناف، أمام محاكم الاستئناف التابعة لتلك الجهة، فإن مسلك المشرع على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية، فى منازعات الضرائب. ولا وجه للاحتجاج فى هذا الشأن، بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم 47 لسنة1972، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص، رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة، على أن المشرع الدستورى، لم يخص - سواء فى ظل دستور سنة 1971، أو الدساتير اللاحقة عليه، وانتهاءً بالدستور القائم - نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية، استلزم صدور قانون بها، استثناءً من القواعد التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى، التى عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه، إعمالاً للنص المذكور - والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه فى 5/10/1972 - أو فى تضمين قانون الضريبة تلك القواعد، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة، بل يناقضه ما انتهجه المشرع ذاته فى بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب، كما يتصادم مع الالتزام الدستورى، الذى يفرضه نص المادة (97) من الدستور الحالي، بكفالة الحق لكل شخص فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، والذى يقتضى أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها، التى تحول دون حصوله على الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه، استتار المشرع وراء سلطته فى هذا الشأن، ليصرفها فى غير وجهها، فلا يكون عملها إلا انحرافًا عنها. ([30])
وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا، الطبيعة الإدارية، في شأن منازعات الرسوم الجمركية، ورسوم الخدمات، المقررة طبقاً لقانون الجمارك، حتى ولو كانت المنازعة فيها، من قبيل منازعات الاسترداد([31])، فأكدت في أحكامها، على أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية، الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التى عقدت الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية، والتى تدخل ضمنها القرارات المار ذكرها.
لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية، ورسوم الخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، وعناصرها ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو القانون المقرر لهذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحجوز للقضاء الإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة، فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى.([32])
تلك كانت مجموعة من المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، في شأن الفرائض المالية، والتي يتحدد بها ملامح النظام الضريبى، والقواعد الحاكمة له في الدستور الحالى.
ويبين من هذه المبادئ، أن الدستور – وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – قد أعلى من شأن الضريبة العامة، وقدّر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار الاقتصادية التي ترتبها، ومايز- ترتيباً على ذلك – بنص المادة (38) منه، بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية. وفى شأن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين بقانون: وفى الحدود التي يبينها، نصت المادة المذكورة على أن "يهدف النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة، إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية"، وهو ما يتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتوى النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع هذه النظم، ويتعين بالتالى أن يكون العدل – من منظور اجتماعى – مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده الذى يضمن خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعا،ً كما ألقى الدستور في المادة (38) منه، التزاماً دستوريا على الدولةً، بالإرتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها، الذين تتوافر لهم الواقعة المنشئة للضريبة، وأوجب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية، متعددة الشرائح وفقاً لمقدرتهم التكليفية، كما أوجب تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة، كمورد مهم وأساسى للموازنة العامة للدولة، والتزام المواطنين بأدائها، باعتباره واجباً وطنياً، وأن التهرب منه يعد جريمة، وبين صيانة الحقوق والحريات الأخرى للمواطنين، وعدم المساس بأصلها وجوهرها، وهو ما حرص الدستور على توكيده بنص المادة (27) منه، باعتباره قيداً والتزاماً دستورياً على الدولة في اختيارها للنظام الاقتصادى الذى تنتهجه، بحيث تراعى فيه تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في العلاقة القانونية محل التنظيم، إعلاًء لقيم العدل الذى حرص الدستور على كفالته في المادة (4) منه، باعتباره أساساً لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، واحتراماً من المشرع للأطر المحددة لسلطته في تنظيم الحقوق والحريات، التي عينتها المادة (92) من الدستور.
الهوامش
([1]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 24/8/2008، في الدعوى رقم 1 لسنة 30 قضائية (مخاصمة).
([2]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/2/1994، في الدعوى رقم 23 لسنة 15 قضائية "دستورية".
([3]) راجع: "الضوابط الدستورية للنظام الاقتصادي في دستور 2014" – للمستشار محمد خيرى طه - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً – مجلة الدستورية – العدد الحادي والثلاثون – السنة العشرون – أكتوبر 2022.
([4]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3 أبريل سنة 1996، في الدعوى رقم 18 لسنة 8 قضائية "دستورية".
([5]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 5/9/2004.
([6]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 304 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 3/12/ 2016.
([7]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8 ابريل سنة 1995، في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية "دستورية".
([8]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 نوفمبر سنة 1992، في الدعوى رقم 35 لسنة 13 قضائية "دستورية".
([9]) راجع: في هذا المعنى: الأستاذ الدكتور/ محمد عبد اللطيف- الإتاوة في القانون الخاص والقانون العام والقانون المالى- مجلة الرافدين- المجلد (22)- العدد (79)- السنة (24)- ابريل2022.
([10]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 95 لسنة 30 قضائية "دستورية" بجلسة 1/8/2017.
([11]) راجع: على سبيل المثال: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 8/4/1995.
([12]) راجع: في مفهوم "المتحصلات السيادية" الواردة بنص المادة (38) من الدستور الحالي، تقرير هيئة المفوضين، المعد من قبل السيد الزميل الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد خيرى النجار، في الدعوى رقم 26 لسنة 31 قضائية "دستورية".
([13]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى رقم 23 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 5/2/1994 – المجموعة الجزء السادس – ص 140.
([14]) راجع على سبيل المثال: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 203 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/2020.
([15]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 139 لسنة 37 قضائية "دستورية" بجلسة 4/12/2021، ويلاحظ أن هذه المحكمة قد أعملت المبدأ ذاته، في شأن إعفاء الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، من أداء 75% من مقابل استهلاك المياه،- راجع: حكمها الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية" بجلسة 6/7/2019، وإعفاءها من أداء 75% من مقابل استهلاك الكهرباء، - راجع: حكمها الصادر في الدعوى رقم 241 لسنة 31 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/2020 .
([16]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 171 لسنة 37 قضائية "دستورية" بجلسة 2/4/2022.
([17]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/2020.
([18]) راجع: على سبيل المثال: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 28 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 3/4/1982.
([19]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 1/2/1997 في الدعوى رقم 65 لسنة 17 قضائية "دستورية".
([20]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 2/3/2019 في الدعوى رقم 50 لسنة 37 قضائية "دستورية".
([21]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 148 لسنة 32 قضائية "دستورية" بجلسة 6/4/2019.
([22]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 75 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 1/6/2014.
([23]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية" بجلسة 2/11/2019.
([24]) راجع: في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 65 لسنة 17 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 1/2/1997.
([25]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 15/11/1997 في الدعوى رقم 58 لسنة 17 قضائية "دستورية" .
([26]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 3/2/1996 في الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية "دستورية".
([27]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 3/2/1996 في الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية "دستورية".
([28]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 8/4/1995 في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية "دستورية".
([29]) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 19/6/1993 في الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية "دستورية".
([30]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة 25/7/2015 وحكمها الصادر في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" بجلسة 17/4/2013. في شأن الاختصاص القضائي بنظر "المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات".
([31]) قارن في هذا الاتجاه: ما قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض، في الطعن رقم 11999 لسنة 89 قضائية "هيئة عامة" بجلسة 28/12/2020، في شأن استرداد رسوم الخدمات، التي قضى بعد دستورية سند فرضها، فذهبت إلى "أن مفاد النص في المادتين (181، 182) من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق، الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانونى أخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب. وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق، وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات الطبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادى، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق، وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أياً كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق، لا تقوم على هذا السبب، ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق، دون النظر إلى السبب الذى زال. وهو ما يترتب عليه، أن موضوع المنازعة الحالية- بطلب استرداد مبالغ مالية، دفعت بغير حق استناداً إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته- لا يتصل بقرار إدارى، ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة، في نطاق اختصاص القضاء العادى".
([32]) راجع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 3 لسنة 38 قضائية "تنازع" بجلسة 6/7/2019.