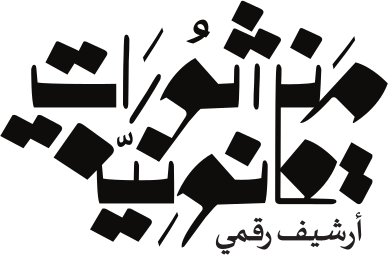الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية
* الكاتب: المستشار د. محمد عبدالفتاح عبدالبر - وكيل مجلس الدولة وعضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستوريا العليا ندبا
تمهيد
خَلَق الله البشر على أجناس شَتَّى تفرقت في أصقاع الأرض وبين ربوعها، فتنوعت مشاربهم وتفرعت أنسابهم، وتَمَخَّض عن كل هذا أمم كثيرة، ولا يزالون مُختلفين.
وترتب على هذه السُنَّة الكونية أن التَفَّ أولئك الذين يجمع بينهم عامل مُشترك – كاللغة أو الدينٍ أو الإثنية أو غير ذلك مما قد يلتَمّ به شمل الأفراد – حول أنفسهم. وقد دعا إلى هذا الالتفاف ما توفره عُصبة الجماعة من أمان ومَنَعة، فضلاً عما يُنتِجه وجود القواسم المُشتركة بين أفراد الجماعة من تقارب في العادات والأعراف، بما ييسر معه التعامل بين أعضاء الجماعة وتتقلص به دائرة الصراع داخلها.
ولا بد لأي جماعة من البشر – حتى قبل قيام الدولة بمفهومها الحديث – من نسيج ثقافي يربط بين أفرادها. وليس ضرورياً أن يتسم هذا الرابط الثقافي بالتطور والتعقيد، بل قد يتسم بالبساطة والغريزية؛ فالمجتمعات البدوية أو الريفية مثلاً ترتبط برباط ثقافي ما، صحيح أنه لا يتسم بالحداثة والمدنية التي يتسم بها الارتباط الثقافي داخل المُدن، إلا أن له احترامه عند أبناء القبيلة أو القرية.
ولم يتغير الأمر كثيراً بظهور الدول بمفهومها الحداثي العصري. فكل دولة في بداية تكوينها لا بد أن جماعة ما شَكَّلَت نواتها الأولى، وغالباً ما يكون الإطار الثقافي لهذه الجماعة إرهاصاً بالإطار الثقافي لهذه الدولة الناشئة، على الأقل في بداية بزوغ شمس هذه الدولة، فمثلاً احتفظت كثير من بلدان الخليج العربي بالكثير من مظاهر القَبَلية القديمة واستصحبت عاداتها حتى وقت قريب جداً.
والسؤال هنا، هل تحظى الروابط الثقافية داخل المُجتمعات البشرية بحماية دستورية خاصة؟ وهل يُفترض أن يحمي دستور الدولة الخصوصية الثقافية Cultural Particularity لشعبها؟ وإذا كان ذلك، هل تتمدد هذه الحماية الدستورية للمُكونات البشرية داخل الدولة؟ بعبارة أخرى، هل للمجتمعات الفرعية – كالأقليات العرقية أو الإثنية أو الدينية – حق في حماية خصوصيتها الثقافية، استقلالاً عن الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية للشعب ككل؟
أولاً: مفهوم «الخصوصية الثقافية» وارتباطه بمفاهيم «التعددية الثقافية» و«الهوية الثقافية» و«التنوع الثقافي»
قبل الدلوف لبحث دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، يلزمنا أن نفهم أولاً معنى اصطلاح «الخصوصية الثقافية». وقبل الوقوف على معنى هذا التركيب الاصطلاحي ينبغي أولاً التعرف على دلالة شقيه - الثقافة والخصوصية.
إن "مضمون الثقافة في اللغة العربية ينبع من الذات الإنسانية، فالكلمة تعني تنقية الفطرة البشرية وتشذيبها وتقويم اعوجاجها ثم دفعها لتكوين المعاني الجوانبية الكامنة فيها، وإطلاق طاقاتها لتنشئ المعارف التي يحتاجها الإنسان ... فهو مفهوم يفتح الباب أمام العقل البشري لكل المعارف والعلوم النافعة. ويركز في المعرفة على ما يحتاج الإنسان إليه طبقاً لظروف بيئته ومجتمعه، وليس على مُطلق أنواع المعارف والعلوم، وهذا يربط مفهوم الثقافة بالنمط المجتمعي الذي يعيش الإنسان في ظله"([1]).
وعَرَّف البعض الأخر الثقافة على أنها "مجموع العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها ويمتثل لها أفراد المجتمع. ذلك أن الثقافة هي قوة وسلطة مُوجِهَة لسلوك المجتمع، تحدد لأفراده تصوراتهم عن أنفسهم والعالم من حولهم، وتحدد لهم ما يحبون ويكرهون، ويرغبون فيه ويرغبون عنه، كنوع الطعام الذي يأكلون، ونوع الملابس التي يرتدون، والطريقة التي يتكلمون بها، والألعاب الرياضية التي يمارسونها، والأبطال التاريخيين الذين خلدوا في ضمائرهم، والرموز التي يتخذونها للإفصاح عن مكنونات أنفسهم ونحو ذلك. ومن هذا التعريف يتبين أن الثقافة:-
- ذات نمو تراكمي على المدى الطويل: بمعنى أن الثقافة ليست علوماً أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أن يحصل عليها ويستوعبها ويتمثلها في زمن قصير، وإنما تتراكم عبر مراحل طويلة من الزمن.
- تنتقل من جيل إلى جيل عبر التنشئة الاجتماعية: فثقافة المجتمع تنتقل إلى أفراده الجُدد عبر التنشئة الاجتماعية، حيث يكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع.
- ذات طبيعة اجتماعية: أي أنها ليست صفة خاصة للفرد وإنما للجماعة، حيث يشترك فيها الفرد مع بقية أفراد مجتمعه وتمثل الرابطة التي تربط جميع أفراده.
وهكذا تميز ثقافة شعب ما نمط حياته عن أنماط الشعوب الأخرى ولكنها لا تعزله ولا تقوده بالضرورة إلى حالة خصام مع الثقافات الأخرى. وقد يوجد في كل ثقافة من يدعو إلى العزلة والانقطاع عن الأخرين، أو أسوأ من ذلك إلى التعالي وتفخيم الذات واحتقار الأخرين. وقد يصل هذا إلى مرحلة العداء للأخرين وتشكيل خطر على وجودهم، ولذلك كان لا بد من الحوار حتى يخفف من حدة هذا العداء ويجعل أصحاب الثقافات يتعايشون ويفهم كل منهم الأخر"([2]).
وعلى صعيد أخر، وفيما يتعلق بلفظة الخصوصية في السياق محل النقاش، فقد ذهب البعض إلى أن مصطلح الخصوصية يعني "التمايز عن الأخر والاتصاف بملامح ذاتية تختلف عنه. وعلى المستوى القيمي، فإنه يعني الوعي بالذات وحقيقتها الوجودية وإدراك تميزها وحدودها الزمانية والمكانية ورسالتها الأخلاقية وما يرتبط بها من دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية. وبذلك تكون الخصوصية مزيجاً من موقف وجداني وعقلاني في نفس الوقت"([3]).
وفي ضوء الفهم السابق للمقصود بلفظتي الثقافة والخصوصية – كُلٍ على حدة – يمكننا تعريف «الخصوصية الثقافية» على أنها حزمة القواسم المُشتركة من القيم بين أفراد أي جماعة، أو البصمة الخاصة بأفراد هذه الجماعة، والتي تميزهم عن غيرهم، وتعكس هويتهم الخاصة وتبرز مظاهر تفردهم واختلافهم عن غيرهم.
وقد تتجلى مظاهر الخصوصية الثقافية في صورة مادية، مثالها النموذجي إرث الجماعة الفني والأدبي وكذا تراثها المعماري، اللذان يحكيان معاً تاريخ الجماعة وماضيها ويوثقان مراحل تطورها الثقافي، أو في صورة معنوية تتجسد في منظومة القيم داخل الجماعة والنسق الاجتماعي العام الذي تدور في فلكه حياة هذه الجماعة، ذلك النسق الذي يضع قواعد السلوك ويحدد أنماط التعامل بين أفرادها، بحيث يُعد القبول به شرطاً أولياً لازماً للانتساب لهذه الجماعة واكتساب عضويتها.
وفي اعتقادنا أن الحماية الدستورية للجانب المعنوى من الخصوصية الثقافية لا تقل في أهميتها – بل ربما تزيد – عن حماية الجانب المادي لها؛ فإذا كان بناء الإنسان مُقدم على بناء البنيان؛ فإن الحفاظ على هوية الجماعة القيمية يعلو في أهميته الحفاظ على بصمتها المادية؛ فإنسان واحد في موقع المسئولية قد يمحو بالتفاته عن المنظومة القيمية لجماعته أو انسلاخه منها مئات وربما آلاف السنين من الحضارة المادية التي شادتها هذه الجماعة.
وعلى أية حال، فهذه الجماعة التي نتحدث عن خصوصيتها الثقافية قد تنحصر دائرتها في إطار ضيق على أساس قَبَلي أو عرقي أو إثني أو ديني أو غير ذلك من أسس، وقد تتسع دائرتها لتشكل عنصر الشعب في الدولة الحديثة، بحيث يمكن القول بأن إطاراً ثقافياً واحداً ينتظم الغالبية الساحقة من أفراد هذا الشعب، وهو ما يرشح للقول بأن لهذا الشعب خصوصية ثقافية معينة.
وفي مُقابل الخصوصية الثقافية يوجد ما يُعرف بـ«التعددية الثقافية» Multiculturalism، ولإيضاح المفهوم الأخير ذهب البعض إلى أن "فكرة الثقافة ذاتها يصعب الإحاطة بها، فهي بمثابة سائل في عالم من الجوامد كما يقول البعض. ... ولا نخطئ كثيراً إذا أكدنا أن هذا يشير إلى كل ما نبدعه ونحتفظ به باعتبارنا جماعة، أو على وجه أعم باعتبارنا بشراً. هذا التعريف يمتاز بأنه يشمل الثقافة بمعناها الفني، وبالمفهوم الأكثر اتساعاً، وهو المفهوم الأنثروبولوجي فهي أسلوب للحياة، أسلوب مادي، وفكري، وروحي، وبذلك تحفظ الصلة بين الإبداع الفني، وإبداعية الحياة اليومية الجارية. هذا التعريف يأخذ أيضاً في اعتباره تنوع الثقافات، فالإبداعية والتنوع يتلازمان. وأخيراً فإن هذا التعريف يطرح المشكلة الحيوية الخاصة بالفروق الثقافية مع التوتر الدائم بين التجديد والمحافظة. ... وعالمنا في حاجة إلى تنوع وجهات النظر الثقافية التي يعبر عنها بروح من الانفتاح والفضول، لا بروح الحذر والرفض. ومن المهام الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر، في عالم تتضاعف فيه الصلات الثقافية، تشجيع الاعتراف بحقوق الأخرين، ومساعدة أولئك الذين جُحدت حقوقهم، مساعدتهم على الاحتفاظ بهذه الحقوق ودعم هويتهم. هذا هو تحدي التعددية الثقافية"([4]).
والسؤال هنا عن علاقة الخصوصية الثقافية بالتعددية الثقافية؟ هل هما مفهومان مُتناقضان؟ أم أنهما يتكاملان ويتمتعان - من ثم - بحماية دستورية؟
نعتقد أن الخصوصية الثقافية والتعددية الثقافية مفهومان مُتكاملان، وجديران من ثم بالحماية الدستورية؛ فالأول يحفظ على كل جماعة هويتها وذاتيتها المستقلة وأصالتها، والثاني يتيح استيعاب ما بين الجماعات المُختلفة من تنوع ثقافي وعَقَدي وفروقات ذات صلة بالعادات والتقاليد والأعراف؛ فالعضوية بعنصر الشعب في الدولة العصرية لم تعد مقصورة على جماعة بعينها، حتى وإن كانت هذه الجماعة هي المؤسِسَة لعنصر الشعب، أو – كما قلنا – النواة الأولى به، بل تعددت الجماعات داخل الدولة الحديثة، وأضحى نجاح أي دولة مرتبطاً بقدرة هذه الجماعات على التعايش المُشترك والانصهار في بوتقة جَمْعية واحدة، انصهار بالقدر الذي يستلزمه بقاء الدولة مُوحدة، وليس انصهاراً بمعنى التماهي([5]) الذي يزيل ما بين المجموعات البشرية من اختلاف وتَفَرّد.
أيضاً ثمة تساؤل جدير بالبحث عن مفهوم «الهوية الثقافية» Cultural Identity وعلاقته بالخصوصية الثقافية، "فالهوية ليست أمراً ترفيهياً، أو حالة عارضة، بل إنها مُكون رئيس من مكونات الشخصية، إن لم تكن هي المُعبرة أصلاً عن الذات الإنسانية، وبدونها يظل الإنسان يبحث عن وجوده، ساعياً لمعرفة حقيقة نفسه، وتبرز التساؤلات المرتبطة بالهوية من عدة زوايا مثل: كيفية الجمع بين أكثر من هوية؟ وكيفية التغلب على المخاطر التي تواجه الهوية ...؟ وكيفية الفاعلية المجتمعية، والبعد عن العزلة الحضارية والفكرية في المجتمع مع المُحافظة على الخصوصية والتميز الثقافي ...؟ وما سُبل التحصين لحماية الهوية من الذوبان والتحلل؟"([6])
يبدو لدينا أن الهوية الثقافية هي البُعد النفسي للخصوصية الثقافية بالنسبة لأعضاء أي جماعة، فهذه الهوية – التي لا يمكن عزلها عن محيطها – ليست إلا شعوراً داخلياً بالخصوصية والتميز، ولذلك فإن أي اعتداء على الخصوصية الثقافية لأي جماعة، أو أي محاولة لطَمْس هذه الخصوصية أو إذابتها، يستحيل في النهاية عدواناً على الهوية المُشتركة لأفراد هذه الجماعة؛ أي ذاتيتهم وحقهم الطبيعي في ألا تُمحى مظاهر تفرد وأسباب تميز الجماعة التي ينتسبون إليها. ومنع هذا العدوان هو جوهر الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية.
ثانياً: الخصوصية الثقافية وظاهرة العولمة
في أبسط معانيها وأوسعها شهرة تُعَرَّف العولمة على أنها صيرورة العالم قرية صغيرة، وذلك على إثر ثورة المعلومات والتطور التكنولوجي المُتزايد الذي شهده العالم في العقود الأخيرة.
ويتعلق بالحماية الدستورية للخصوصية الثقافية التساؤل عن طبيعة العلاقة بين حماية هذه الخصوصية وما تفرضه ظاهرة العولمة من مُستجدات وتحديات. وللإجابة على هذا التساؤل أهمية خاصة في وضع وتحديد أُطر الرقابة الدستورية فيما يتعلق بحماية الخصوصية الثقافية.
ولإيضاح العلاقة بين الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية وظاهرة العولمة، ينبغي إدراك أن العولمة قد تكون أحد وسائل الهيمنة على الشعوب ثقافياً، وخطورة ذلك تتجسد في أنه بالقدر الذي تتسع فيه دائرة تأثير ظاهرة العولمة ينحسر دور الرقابة الدستورية فيما يتعلق بحماية الخصوصية الثقافية، ولذلك فالاستجابة غير المشروطة لدعاوى العولمة والتفاعل الامتثالي مع مُتطلباتها يحمل معه مخاطر جَمّة؛ إذ قد تستهدف العولمة العبث بالبناء الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع، أو إعادة تشكيل الوعي الجَمْعي وتوجيهه بصرفه عن قيمه العُليا.
وعلى الجانب الأخر، لا ينبغي الإفراط في التوجس من التفاعل الثقافي مع الغير، "إذ ليست الخصوصيات الثقافية بالأمر العارض السطحي الذي يمكن أن يتماهى في ثقافة أو حضارة أخرى بسهولة أو أن يذوب في بوتقة ثقافية أخرى فيفقد ثوابته وأركانه، ومن ثم تضيع ملامحه وتتبدد سماته المميزة. ... وإذا كان الكثيرون ينتابهم قلق من تداعيات التفاعل الواسع والمتعدد الجوانب مع العالم الخارجي في ظل العولمة، فيجب التأكيد على أنه قد أضحى من طبائع ومعالم وثمار المرحلة التاريخية الحالية، وإذا كان هذا الانخراط مع الثقافات المُغايرة يستدعي الحذر، فإنه يجب ألا يتفاقم الخوف من ضياع الخصوصيات الثقافية لنا وبالتالي ضياع الهوية أمام خصوصيات ثقافية أخرى وافدة من العالم الأكثر تقدماً وقوة وثراء، خاصة إذا كنا على يقين بأن خصوصياتنا الثقافية هي أعمق من أن تطمسها التعاملات مع الخارج وأن جذورها عميقة وضاربة في تربة الزمان والمكان، وأن «تعقد التركيبة» التي من مجملها تتكون خصوصياتنا الثقافية يجعل القول بإمكانية ضياع خصوصياتنا الثقافية وهماً وسراباً"([7]).
الخُلاصة إذن أن الالتزام بالحفاظ على الخصوصية الثقافية داخل أي مجتمع سلاح ذو حدين؛ إذ قد يكون – من وجه أول – عاصماً لمنظومة القيم الاجتماعية العُليا داخل الجماعة وحامياً لها من التغولات الفكرية الخارجية، وفي المُقابل – من وجه أخر – قد يستحيل التخندق والانحباس داخل هذه الخصوصية عائقاً يحول بين الجماعة وبين التفاعل الإيجابي مع الأخر والاستفادة منه ونقل المعارف عنه، بما تتضاءل معه في النهاية احتماليات إحراز أي تقدم داخل الجماعة، وهنا يبرز دور الرقابة الدستورية في حماية هذه الخصوصية بضبطها في إطارٍ مُحكمٍ، لا إفراط فيه أو تفريط.
ثالثاً: دائرة الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية
عديدة تلك الأسباب التي يمكن سوقها لحماية الخصوصية الثقافية لجماعة معينة أو لشعب ما. فكما ذكرنا منذ قليل، فحماية هذه الخصوصية بشكل عام هو الذي يحفظ على الجماعة ذاتيتها وتفردها، ويحول دون اعتبار جميع البشر نمطاً واحداً أو نُسخاً مُكررة. إلى جانب أن هذه الحماية تمثل حائط الصَدّ الأول ضد الأفكار الهدَّامة الدخيلة على الجماعة، والتي تهدف إلى النيل من استقرارها الاجتماعي، أو تخريب منظومتها الدينية والأخلاقية، وتدمير ملامح الذوق العام فيها.
وكما ألمحنا منذ قليل، فإن دعوات الحفاظ على الخصوصية الثقافية تتسع لتشمل الحفاظ على هذه الخصوصية سواء بالنسبة للجماعة في صورتها الجزئية البسيطة؛ كالقبيلة أو القرية أو مجموعات الأقليات العنصرية أو الدينية، أو في صورتها الكُلية المُعقدة؛ أي بالنسبة لعنصر الشعب في الدولة المدنية الحديثة.
وفي ضوء الفهم السابق لمفهوم الحفاظ على الخصوصية الثقافية، نعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من أن تتمدد الحماية الدستورية لهذه الخصوصية لتشملها سواء على المستوي الكُلي أو الجزئي. فكما يحمي الدستور عنصر الشعب في الدولة، يُفترض أن يحمي كذلك المُكونات البشرية التي يتألف من جماعها هذا العنصر. بل إننا نعتقد أن حماية الخصوصية الثقافية للمجموعات الفرعية هو الضامن الأكيد لحماية التعددية الثقافية.
وانعكاساً للفهم السابق نجد المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المُجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم".
وبشكل عام نلمس للاهتمام بحماية الخصوصية الثقافية وكذا التعددية الثقافية أثراً كبيراً، سواء على الصعيد الدولي([8])، أو في المجال الدستوري المُقارن، بالذات في السياقات التي تربط بين هذين الاصطلاحين وفكرة التنوع diversity([9])، سيَّمَا التنوع الثقافي cultural diversity الذي يحظى باهتمام واسع على المستوى الدستوري في الكتابات المُقارنة([10]). فالحماية الدستورية للتنوع الثقافي تستوعب بالضرورة حماية الخصوصيات الثقافية بالنسبة لعنصر الشعب في الدولة، وكذا احترام تعددية هذه الخصوصيات الثقافية بالنسبة للمجموعات البشرية المُختلفة (المُتنوعة) داخل الدولة الواحدة.
رابعاً: الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية للسكان الأصليين في الولايات المُتحدة الأمريكية (دراسة حالة)
عادةً لا تثير الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية الكثير من الإشكاليات الدستورية عندما يتعلق الأمر بالنسيج الثقافي لعنصر الشعب في الدولة ككل؛ إذ تتضاءل مخاوف العدوان على هذه الخصوصية على المستوي الجَمْعي، وتتقلص هذه المخاوف في أضيق نطاق إذا اتسم عنصر الشعب في هذه الدولة بالتجانس البشري؛ أي اشتراك غالبية الشعب في لغة واحدة وأصل عرقي أو إثني أو ديني واحد.
ولذلك فإن الصورة الأبرز للحماية الدستورية للخصوصية الثقافية تتجلى بالذات في حماية التفرد الثقافي للمجموعات الفرعية داخل الدول التي يتألف عنصر الشعب فيها من مكونات بشرية ذات خلفيات مُتنوعة، عرقياً أو إثنياً أو دينياً أو غير ذلك من مظاهر التنوع الإنساني؛ كالولايات المُتحدة الأمريكية وجنوب إفريقياً والهند، ومن منطقتنا العربية العراق مثلاً.
وفي الولايات المُتحدة الأمريكية أبرزت المحكمة العُليا الفيدرالية منذ وقت بعيد تفهمها لأهمية حماية الخصوصية الثقافية للمجموعات الفرعية داخل هذا الاتحاد الفيدرالي، فقد جرى قضاؤها مثلاً على الإقرار بدستورية منح السكان الأصليين (الهنود الحمر) مُعاملة خاصة لدى سَنّ التشريعات التي تخص شئون قبائلهم، إدراكاً منها لضرورة الحفاظ على الخصوصية الثقافية لهذه المجموعات، وحتمية التفاعل الإيجابي مع مظاهر هذه الخصوصية([11]).
خامساً: ضابط الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية بالنسبة للمجموعات الفرعية داخل الدولة
"من غير العلمي أو المنطقي أن نعتقد أن الخصوصيات الثقافية لا بد أن تحتوي بالضرورة على مكونات رشيدة أو قيم مثالية وخبرات تفاعلية إيجابية، فكل خصوصية ثقافية تعبر بشكل واضح وأمين عن منظومة الأفكار والقيم والسلوكيات التي تسود في مجتمع ما أو جماعة بشرية بعينها، بكل ما تنطوي عليه تلك المنظومة من سلبيات أو إيجابيات"([12]).
ولما تقدم، فإذا كانت الخصوصية الثقافية للمجموعات البشرية الفرعية داخل الدولة الواحدة جديرة بالحماية الدستورية، إلا أنه ينبغي أن يظل واضحاً أن احترام وتقدير هذه الخصوصية ليس مُطلقاً من كُل قيد؛ إذ تحظى هذه الخصوصية بالحماية الدستورية بالقدر الذي لا تخالف فيه نصوص الدستور، وبالطبع في إطار من النظام العام والآداب داخل الدولة والقوانين المعمول بها فيها([13])؛ إذ لا يتصور أن تكون حماية هذه الخصوصية مَطيّة لمُخالفة القانون ونَقْض ما أبرمه الضمير الجَمْعي للدولة وتم إفراغه في الوثيقة الدستورية؛ فلا يسوغ مثلاً – بذريعة حماية الخصوصية الثقافية – توفير حماية دستورية لنصوص تشريعية تقر العمل بعقوبات جنائية غير تلك التي تنص عليها القوانين العقابية لمُجرد أن هذه العقوبات مُعترف بها قَبَلياً أو قروياً، وبالمثل فلا حماية دستورية لنصوص تشريعية توفر نفاذاً قانونياً لأحكام صدرت عن مُحاكمات عرفية لا تتوافر في تشكيلها أو قواعد تنظيمها الإجرائية والموضوعية أي ضمانات دستورية أو قانونية من تلك التي تنتظم عمل الجهاز القضائي في الدولة([14]).
سادساً: الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية في الواقع الدستوري المصري
لا يعزب عن كل ذي نظرٍ الموجة العاتية الداعية لتدويل بعض الثقافات الغريبة على مجتمعاتنا العربية في الآونة الأخيرة، والتي تشكل عدواناً سافراً على خصوصيتنا الثقافية، هذه الخصوصية التي تجد مُستقرها ومُستودعها في قيمنا الدينية الراسخة ومنظومتنا الأخلاقية الثابتة. والأسوأ من ذلك محاولة فرض هذه الثقافات على مجتمعاتنا، تذرعاً بحتمية التفاعل مع ما ترتب على ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي المُتسارع من أوضاع، وكذا الحاجة للتعاطي الإيجابي مع تحديات العولمة والحوار بين الثقافات.
وقد يسعى البعض إلى فرض هذه الثقافات الدخيلة من خلال مُمارسة نوع من الابتزاز الدستوري، بدعوى أن صَدّ هذه الثقافات وعدم الاعتراف بمُفرداتها ينطوي على مُصادرة غير جائزة دستورياً لحرية الأفراد في اختيار أنماط حياتهم، واعتداء غير دستوري على حقهم في مُمارسة ما تنجذب إليه ميولهم وتوجهاتهم.
إن ما يجب التذكير به دائماً أن لكل مجتمع نسقاً ثقافياً يميزه ومساراً دينياً وأخلاقياً يرتبط وجوده بالحفاظ عليه، وأن الاستتار وراء مبادئ الحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد والاعتراف بتنوع الثقافات – وكلها قيم دستورية لا مجال لإنكارها – لا يمكن أن يُتخذ موطئاً لهدم كيانات الدول وطَمْس هوية المجتمعات؛ فكما أن قبول الأخر فضيلة إنسانية، فإن احترام الخصوصية الثقافية لأي مجتمع ضرورة دستورية. ولذلك فإن مساعي تصدير الثقافات ومحاولات فرضها على من لا ينتحلونها كرهاً عنهم تُشكل انتهاكاً صارخاً للكثير من المبادئ الدستورية المُستقِرة دولياً، واعتداءً غير جائز على سيادة الدول الأخرى، فضلاً عن تجاوزها لكثير من الحقائق الاجتماعية والأنثربولوجية.
وفي واقعنا الدستوري المصري نجد المُشرع الدستوري في دستور 2014 المُعدل قد خصص فصلاً كاملاً (الفصل الثالث) من الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع) كَرَّس فيه لحماية النسيج الثقافي للمجتمع المصري عنونه بـ"المقومات الثقافية"، فنص صراحة في المادة الأولى من هذا الفصل (المادة 47 من الدستور) على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة".
وفي المادة التي تليها (المادة 48 من الدستور) نص على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها".
ونصت المادة التالية (المادة 49 من الدستور) على أن "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استُولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".
وفي المادة الأخيرة من هذا الفصل (المادة 50 من الدستور) نص المُشرع الدستوري على أن "تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر".
ولنا ثلاث ملاحظات على منهج المُشرع الدستوري في فصل المقومات الثقافية المَار بيانه:
- لم يغفل المُشرع وجهي الخصوصية الثقافية على المستويين الكُلي والجزئي؛ فنص في المادة (47) من الدستور على الهوية الثقافية المصرية (أي الهوية الجَمْعية للشعب المصري ككل). وفي المادة (48) من الدستور التي كفلت حق كل مواطن في الثقافة بدون تمييز، تحدث المُشرع عن الاهتمام الخاص بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً (أي الهويات الفرعية للمُجتمعات الداخلية). ويتكامل مع هذه المُلاحظة ما تضمنته المادة الانتقالية رقم (236) من الدستور التي نصت على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ...". فالنص على مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي له دلالة واضحة على اهتمام المشرع الدستوري – ولو بنص انتقالي – بأخذ الخصوصية الثقافية للمجتمعات المحلية في الاعتبار لدى وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة([15]).
- لم يُفَرِّق المُشرع – في فصل المقومات الثقافية المَار بيانه – بين الجانبين المادي والمعنوي للخصوصية الثقافية من زاوية الحماية الدستورية.
- مَدّ المشرع الحماية الدستورية في المادة (50) من الدستور لمكونات التعددية الثقافية في مصر، وهو المعنى سَبَق أن أبرزناه لدى الحديث عن تكاملية الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية مع الحماية الدستورية للتعددية الثقافية.
وقد أولت المحكمة الدستورية العُليا الجانب المادي للخصوصية الثقافية اهتماماً كبيراً في ظل العمل بدستور 2014 المُعدل؛ وذلك بتأييدها – في قضائها في الدعوى رقم 39 لسنة 39 قضائية "دستورية" بجلسة 2 مارس 2019([16]) – دستورية حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًّا، ذلك الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وإدراكاً منها للأهمية البالغة للحماية الدستورية التي أحاط بها المُشرع الخصوصية الثقافية، فقد أجرت المحكمة الدستورية العُليا في قضائها سالف الذكر موازنة توفيقية في غاية الدقة والصعوبة بين قيمتين دستوريتين جديرتين بالاعتبار، أولاهما: الحماية الدستورية للملكية الخاصة التي حرص الدستور في المادتين (33، 35) منه على النص على اعتبارها التزاماً دستورياً على عاتق الدولة، تلك الحماية التي كان يُفترض أن تُطلَق معها أيدي مُلاك العقارات في هدمها أو الإضافة إليها بصرف النظر عن أهميتها التاريخية أو قيمتها المعمارية. وفي مُقابل ذلك، كان أمام المحكمة قيمة دستورية أخرى نصت عليها المادتان (47، 50) من الدستور، تتمثل في ضرورة الحفاظ على التراث المعماري الذي يُشكل الجانب المادي من التراث الحضاري المصري ويعكس الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
وقد أجرت المحكمة الدستورية العُليا الموازنة السابقة بعناية شديدة، فاستهلت التأسيس لقضائها بالتذكير بأن "الدستور – إعلاءً من جهته لدور الملكية الخاصة، وتوكيدًا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي – حرص في المادتين (33، 35) منه على جعل حمايتها وصونها التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، كما كفل حمايتها لكل فرد – وطنيًا كان أم أجنبيًا – ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها."
إلا أن المحكمة أضافت – من وجه أخر – أن "المادة (50) من الدستور قد أكدت على أهمية التراث الحضاري والثقافي المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والإسلامية والقبطية، وكذا الرصيد الثقافي المُعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، باعتبارها جميعًا ثروة قومية وإنسانية، ومن أجل ذلك جعل الحفاظ عليها وصيانتها التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، واعتبر الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبارها أحد روافد الهوية الثقافية والحضارية المصرية، التي ألزم الدستور في المادة (47) منه الدولة بالحفاظ عليها، ومن ثم صار الحفاظ على المباني والمنشآت ذات الطابع الخاص والطراز المعماري المتميز، المُرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًّا، وصيانتها، التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا، وذلك باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الرصيد الثقافي المعماري المعاصر الذي عنته المادة (50) من الدستور، ... ليضحى اضطلاع الملكية الخاصة، التي صانها الدستور بمقتضى نص المادة (35) منه، بدورها في هذا الشأن، داخلًا في إطار أدائها لوظيفتها الاجتماعية في خدمة المجتمع، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فـراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل يمليها خير الفرد والجماعة، الأمر الذي يكون معه النص المحال بتحميله حق الملكية بالنسبة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ببعض القيود التي تمثل انتقاصًا من هذا الحق، بهدف الحفاظ عليها، داخلاً في نطاق سلطة المشرع التقديرية في مجال تنظيم حق الملكية، ووفاءً من الدولة بالتزامها الدستوري المقرر بالمادتين (47، 50) من الدستور".
وإذا كانت المحكمة قد أقرت المُشرع على تقييده لحق الملكية ابتغاء الصالح العام المتمثل في الحفاظ على الرصيد الثقافي المعماري المُعاصر، إلا أنها – إتماماً لتلك الموازنة – لم تترك مُلاك العقارات ذات الطراز المعماري المتميز دون حماية كافية؛ فبعد أن رفضت النعي على دستورية الحظر المَار بيانه، وعلى الرغم من النص على مبدأ تعويض مُلاك تلك العقارات عن حرمانهم من بعض سلطاتهم الفعلية التي يكفلها لهم الحق الدستوري المصون في الملكية الخاصة، إلا أن المحكمة قضت بعدم دستورية سكوت المُشرع عن تضمين النص المُحال (المُقرِر للتعويض) أسس وقواعد وضوابط تقدير التعويض الذي يستحقه هؤلاء، "شاملة معايير تقدير التعويض، وتوقيت تقديره وصرفه لمستحقيه، التي تكفل أن يكون مُعادلاً للقيمة الحقيقية لما تحمله المالك في مُلكه نتيجة القيود التي فرضها المُشرع عليه، وما يضمن أن يقوم التعويض مقام الحق ذاته الذي حُرم منه، ويُعتبر بديلاً عنه".
وإلى جانب النصوص الدستورية المُباشرة على حماية الخصوصية الثقافية المنصوص عليها صراحةً في الفصل الثالث من الباب الثاني من دستور 2014 المُعدل، فإن الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية – سيَّما الجانب المعنوي من هذه الخصوصية – تجد أُسساً إضافية في نصوص دستورية أخرى تضمنتها الوثيقة الدستورية؛ فثالوث اللغة والدين والأخلاق بالذات يشكل أبرز مظاهر الخصوصية الثقافية داخل أي مجتمع، فاللغة: وسيلة التواصل بين أفراد الجماعة، والدين: رباط الجماعة المُقدَّس، والأخلاق: عماد المواطنة الصالحة بها.
وفي ضوء الفهم السابق، فإن حماية الخصوصية الثقافية في التنظيم الدستوري المصري تجد أساساً دستورياً في المادة الثانية من الدستور التي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كذا ما نصت عليه المادة الثالثة من الدستور من أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". فهاتان المادتان كَرَّسَتا للبُعد الديني للخصوصية الثقافية داخل المجتمع المصري، فالإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريعات، وبالنسبة للمسيحيين واليهود فمبادئ شرائعهم هي الحاكمة لشئون أحوالهم الشخصية والدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وهكذا فإن المناعي الدستورية على مُخالفة النصوص التشريعية لمبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة المسيحية أو اليهودية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية أو الدينية أو الروحية بالنسبة للمسيحيين أو اليهود تعد وسيلة ناجعة في الحفاظ على الهوية المصرية من أحد الوجوه.
وبالمثل فقد اعتمد المُشرع الدستوري اللغة العربية كوسيلة للتواصل الرسمي داخل الدولة المصرية في المادة الثانية من الدستور، وهو ما يعكس إدراكاً لا لبس فيه من جانب المُشرع لأهمية الدور الذي تلعبه اللغة في حياة الشعوب - في تسطير تاريخها، ونقل معارفها، وتناقل أخبارها([17]).
غير أن إدراك أهمية الحفاظ على اللغة العربية لم يمنع المُشرع الدستوري في المادة (48) من التشجيع على حركة الترجمة من العربية وإليها، فهذه الترجمة هي التي تعكس التوازن المطلوب بين حماية الخصوصية الثقافية للمجتمع المصري، وبين الانفتاح على الأخر والتواصل معه والانتفاع من معارفه وعلومه، دون أن يترتب على هذا الانفتاح أو ذلك التفاعل إذابة أو طَمْس الهوية اللغوية العربية داخل المجتمع المصري. كما أن النص في المادة (24) من الدستور على أن "اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص" لهو توكيد على هذا الفهم وتكريس للحفاظ على أهم وسائل الترابط الثقافي داخل المجتمع – ألا وهي لغة التواصل داخله.
ولذلك فإن مُباشرة الرقابة الدستورية عملاً بالنص الدستوري على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة المصرية تُعد آلية أخرى للحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع المصري.
وعندما نص المُشرع الدستوري في المادة العاشرة من الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، فإنه يكون قد وَفَّر حماية واسعة النطاق للبنة الأولى داخل المجتمع المصري، وهي الأسرة؛ فالطابع الديني والأخلاقي لمؤسسة الزواج وحماية ذلك الميثاق الغليظ والرباط المُقدس بين «الزوج والزوجة» هو الذي حدا بالمشرع لإفراد هذه العلاقة بنص دستوري خاص؛ حمايةً لبنيان الأسرة داخل المجتمع المصري.
ولا ريب أن الحفاظ على المفهوم الشرعي والأخلاقي للأسرة المصرية لهو أحد أنجع وجوه الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية داخل المجتمع المصري؛ فالربط الذي أجراه المُشرع الدستوري بين الأسرة والدين والأخلاق في المادة العاشرة من الدستور يشكل حائط صَدّ منيع ضد محاولات فرض أية أفكار دخيلة وغريبة على مجتمعنا المصري تتعلق بدعوات الحرية المُطلقة في تكوين الأسرة وتجويز العلاقات المُحرمة دينياً أو الشاذة اجتماعياً([18]).
وعلاوة على ما أنِف بيانه، واستلهاماً من إعلان اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، نَدَّعي أن قائمة طويلة من النصوص الدستورية الأخرى قد يتم توظيفها في اتجاه حماية الخصوصية الثقافية، من ذلك مثلاً ما نصت المادة السادسة من هذا الإعلان من أنه "إلى جانب كفالة التداول الحُرّ للأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ينبغي الحرص على تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها. ذلك أن حرية التعبير، وتعددية وسائل الإعلام، والتعددية اللغوية، والمساواة في فرص الوصول إلى أشكال التعبير الفني والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في صورتها الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع الثقافات في أن تكون حاضرة في وسائل التعبير والنشر، هي كلها ضمانات للتنوع الثقافي."
..................................................
وصفوة القول إذن أن الخصوصية الثقافية للمجتمعات في جانبيها المادي والمعنوي تتمتع بحماية دستورية خاصة، سواء بالنسبة لعنصر الشعب في الدولة أو بالنسبة للمجموعات البشرية الفرعية داخلها؛ وتتعاظم خطورة الدور الذي تلعبه هذه الحماية في شأن الجانب المعنوي من هذه الخصوصية؛ فحماية هذا الجانب هو الذي يحفظ للجماعات والدول نسيجها الاجتماعي، ويؤمن منظومتها الدينية والأخلاقية من التفكك، ويحميها من غزو الأفكار الهَدَّامة ومحاولات احتلالها فكرياً. غير أن هذه الحماية في خصوص المُكونات البشرية الفرعية داخل الدولة ينبغي أن تظل دائماً دائرة في فلك ما هو جائز دستورياً، وبمُراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة، وما تنص عليه قوانينها النافذة فيها.
وقد فطن المُشرع الدستوري المصري لأهمية الحفاظ على الخصوصية الثقافية، فأضفى عليها حماية دستورية فَعَّالة في جانبيها المادي والمعنوي، سواء فيما يتعلق بالهوية المصرية عموماً، أو هوية المُكونات البشرية الفرعية داخل المجتمع المصري، وهي الحماية التي تجد أساسها في بعض النصوص الدستورية المُباشرة، أو عبر العديد من النصوص الأخرى التي تخدم بشكل أو أخر ذات المقصد.
إلا أنه ينبغي أن يظل جلياً أن الحماية الدستورية للخصوصية الثقافية ليست بالمَرَّة دعوة للانعزال أو التشرنق، أو إيقاف مسار الحراكات التقدمية، كما أنها ليست هَوَساً مُفرِطَاً بأفكار الأصالة، أو تكريساً مُغالياً لهيمنة التراث على حساب الحداثة والمُعاصرة، كل ما هنالك أن حماية هذه الخصوصية ليست إلا سعياً وراء الحفاظ على البناء الاجتماعي والمنظومة الأخلاقية للجماعة ضد محاولات التذويب الثقافي وإماهة أوجه تفردها ومظاهر اختلافها. ولا شك أن فَرْز المخاوف المُبالغ فيها من المخاوف المشروعة يدقّ في كثير من الفروض، وهنا يتجلى دور الرقابة الدستورية في تمحيص هذه المخاوف لإيجاد الخط الفاصل بين هذه وتلك.
***
الهوامش
([1]) إبراهيم طلبة حسين – مسألة الهوية لدى الأقليات الإسلامية – بدون تاريخ – صـ553.
([2]) أحمد بن سيف الدين تركستاني – الحوار مع أصحاب الأديان، مشروعيته وشروطه وآدابه – السجل العلمي لمؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) – 2004 – صـ442: 444.
([3]) بشير عبد الفتاح – الخصوصية الثقافية – الموسوعة السياسية للشباب – العدد 20 / يوليو 2007 – صـ7.
([4]) فيديريكو مايور – تحديات التعددية الثقافية – مجلة رسالة اليونيسكو – 1994.
([5]) "التماهي، ويسمى أيضاً التوحد والتعيين، هو أكثر من مجرد التشبه بالأخر أو محاكاته. فهاتان العمليتان تظلان واعيتين، من يتشبه بالغير أو يحاكه يحاول الاقتراب من نمط سلوكه أو مظهره دون أن يفقد إحساسه بالاختلاف عنه، إحساسه بالغيرة. أما التماهي أو التعيين، فهو عملية لا واعية تتم خارج إطار الانتباه والإرادة في معظم الأحيان، وتتلخص بتمثل وجود الأخر حتى يصبح الشخص هو الأخر أو يعيش ذاته كذلك. إنه هو عينه، أو هو هو، ومن هنا يتخذ لنفسه نفس ماهية الشخص الأخر وهويته." مصطفى حجازي – التخلف الاجتماعي – مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور – الطبعة التاسعة (2005) – صـ124.
([6]) إبراهيم طلبة حسين – مرجع سابق – صـ491.
([7]) بشير عبد الفتاح – مرجع سابق – صـ30: 31.
([8]) نصت المادة الثانية من إعلان اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي على أنه "لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعاً يوماً بعد يوم من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في العيش معاً فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التلاحم الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام. وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع الثقافي. وحيث أنها لا يمكن فصلها عن وجود إطار ديمقراطي، فإنها تيسر المبادلات الثقافية وازدهار القدرات الإبداعية التي تغذي الحياة العامة". (اعتمد المؤتمر العام لليونيسكو هذا الإعلان في دورته الحادية والثلاثين – باريس 2 نوفمبر/ تشرين الثاني – 2001). بالمثل تم التأكيد بديباجة اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المُكَرَّسَة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى مُعترف بها على الصعيد العالمي، علاوة على التأكيد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية، وكذا بيان أن الثقافة تتخذ أشكالاً مختلفة عبر الزمان والمكان، وأن هذا التنوع يتجلى في تفرد وتعدد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية، فضلاً عن الإقرار بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي، لا سيما نظم معارف الشعوب الأصلية، وبإسهامها الإيجابي في التنمية المُستدامة، وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة مُلائمة. (اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة هذه الاتفاقية في باريس - 20 أكتوبر/ تشرين الأول – 2005 - وقد وافقت مصر على هذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2007، المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 25 أكتوبر سنة 2007).
([9])
“Diversity is our source of security. It was our source of security when the Constitution was formed, and it will continue to be our source of security today.”
مُشار لهذا الاقتباس في Diversity: The Invention of a Concept 22 (2003) Peter Wood,
([10])
“The management of cultural diversity within the state has become an increasingly prominent issue in recent times both for political actors and for scholars of law, philosophy, sociology and political science. There are certainly many reasons why multiculturalism has been the subject of such attention but of these perhaps the two most important are demographics and political mobilisation. On the one hand cultural diversity is an expanding social phenomenon in an age of migration, asylum, population transfer and the increasing diversification of identity patterns within traditionally homogeneous groups. These evolving demographic patterns have also been accompanied by a growing political assertiveness as cultural minorities, be these territorial sub-state nations, aboriginal groups, or migrant groups, demand in ever more vociferous terms political recognition and the constitutional accommodation of their cultural or societal particularity.”
Stephen Tierney, Cultural Diversity: Normative Theory and Constitutional Practice, in Accommodating Cultural Diversity 1, 1 (Stephen Tierney ed., 2007).
يُراجع أيضاً أحمد فاضل حسين – الحماية الدستورية لحق التنوع الثقافي في العراق – مجلة العلوم القانونية والسياسية – كلية القانون والعلوم السياسية جامعة ديالي – المجلد التاسع – العدد الثاني – 2020.
([11])
“[The] federal regulation of Indian affairs is not based upon impermissible classifications. Rather, such regulation is rooted in the unique status of Indians as ‘a separate people’ with their own political institutions.” United States v. Antelope, 430 U.S. 641, 646 (1977).
“[T]he Federal Government must be, and has been, afforded wide latitude in carrying out its obligations arising from the special relationship it has with the aboriginal peoples, a category that includes the native Hawaiians, whose lands are now a part of the territory of the United States.” Rice v. Cayetano, 528 U.S. 495, 529 (2000).
([12]) بشير عبد الفتاح – مرجع سابق – صـ33.
([13]) تجسيداً لهذا المعنى، نصت المادة الخامسة من إعلان اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي على أن "الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية ومُتلازمة ومتكافلة. ... وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع أعماله ونشرها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته الأصلية. ولكل شخص الحق في تعليم وتدريب جيدين يحترمان هويته الثقافية احتراماً كاملاً. وينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وأن يمارس تقاليده الثقافية الخاصة، في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
([14]) أشارت إحدى القاضيات السابقات بالمحكمة الدستورية العُليا في دولة جنوب إفريقيا لهذا الضابط الدستوري، وربطت كذلك مفهوم الحق في حماية الخصوصية الثقافية بمفهوم التنوع الثقافي:
“It may be argued that individuals and communities have rights to maintain their own cultural uniqueness. This is in accordance with an individual's freedom to organize his or her life in ways that diverge from the national standard. The cultural diversity of South Africans cannot be denied; in fact, it is often celebrated. From the provisions of the new Constitution, it becomes clear that South Africa is now bound to respect the cultural tradition of those of its people who choose to live according to a way of life or culture of their choice, subject, of course, to the standards set in the Constitution. For example, with reference to African custom, one of the many diverse cultural ways of life in South Africa, the courts must now recognise, apply, and develop African customary law, the legal regime associated with African culture. And it seems that the new Constitution seeks to bring to an end the marginal development of African customary law. It also seeks to promote the need to address the application of outdated and distorted African customary law notions and institutions by requiring that they be developed in line with the spirit, purport, and objects of the Bill of Rights and the values of the Constitution.”
Yvonne Mokgoro, The Protection of Cultural Identity in the Constitution and the Creation of National Unity in South Africa: A Contradiction in Terms?, 52 SMU L. Rev. 1549, 1557 (1999).
([15]) يُضاف لذلك موافقة مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 15 في 15 أبريل سنة 1982، والتي تنص في مادتها (27) على أنه "لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما، في الاشتراك مع الأعضاء الأخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم".
([16]) منشور في الجريدة الرسمية – العدد 10 مُكرر (ب) في 11 مارس سنة 2019.
([17]) وذلك لأن "اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم، أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم. فإنما يقيد لغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم. وأما من تلفت دولتهم، وغلب عليهم عدوهم، واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم، فمضمون منهم موت الخواطر. وربما كان ذلك سبباً لذهاب لغتهم، ونسيان أنسابهم وأخبارهم، وبيود علومهم." العَلَّامة ابن حزم الأندلسي – الإحكام في أصول الأحكام – تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر – تقديم: الدكتور إحسان عباس – الجزء الأول – صـ32.
وبالمثل ذهب البعض إلى أنه "من الحقائق العلميّة التي لها أن تتألق الآن في ضوء الشّطرنج الدوليّ الجديد، الحقيقة التي تصف الرابطة المعقّدة القائمة بين اللُّغة والفرد والجماعة. ومدارُها أنّ اللُّغة سابقة للفرد، باقيةٌ بعده، لا تحيا إلا بتداول الأفراد لها، لكنها تموت وتنقرض إذا ما أعرض الأفراد عن تداولها ... ثمّ إنّ اللُّغة هي التي تنتقل بالأفراد من جماعة بشريّة إلى مجموعة ثقافيّة، وهذا على وجه التمحيص يعني أنّ الرابطة اللغويّة أقوى من الرابطة السياسيّة، لأنّ الجماعة البشريّة إذا ترابطت سياسيًّا كوّنت مجموعة وطنيّة، وهذا لا يقتضي بالضرورة أن يكون التجانس الثقافيّ قد قام فعلاً بين أفراد المجموعة بمجرد الانضواء تحت الرابطة السياسيّة الواحدة ... إنّ اللغات البشريّة تتولّد وتحيا وتموت، وقد يبلغ بها الاحتضار مشارف الفناء، فيقيّض التاريخ لها من ينفخ في أنفاسها، فتنبعث انبعاثًا جديدًا، فيشتدّ عودها، وتستقيم هامتها. ولئن كان الأصل في اللغات أن تعيش بفطرتها، وأن تفنى بفعل الزمن فيها، فإنّ التاريخ لقّننا من الدروس ما به نسلّم أيضًا بأنّ اللغات قد تُقتل قتلاً فتُباد، أو تُبعَثُ بعثًا كأنما هو الإحياء بعد الممات". عبد السلام المسدي – الهوية واللغة في الوطن العربي بين أزمة الفكر ومأزق السياسة – فصلية "تبيُّن" للدراسات الفكرية والثقافية – فصلية مُحَكَّمَة يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – العدد 1 – المجلد الأول – صيف 2012 – صـ88.
([18]) لَفَت انتباهنا أن لفظة الأخلاق لم ترد في الوثيقة الدستورية إلا في خمسة مواضع، أولها في ديباجة الدستور، وثانيها عندما ربطها بالأسرة في المادة العاشرة، وثالثها لدى الحديث عن الأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة في المادة (24) من الدستور التي دَعَت الجامعات لتدريس بعض المواد ضمن المقررات الجامعية، ورابعها بالنسبة لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية وذلك في المادة (77) من الدستور التي تعلقت بإنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، وآخرها كان في سياق الحديث عن التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها وذلك في المادة (211) من الدستور. وهكذا فإن المُشرع المصري لم يستخدم لفظة "الأخلاق" بمفهومها الاجتماعي المعروف واسع الدلالة سوى لدى الحديث عن الأسرة كأساس لبناء المجتمع، وإن كان ذلك لا ينفي دخول هذه المفهوم تحت العديد من السياقات ذات الارتباط بمبادئ دستورية أخرى.